كيف نطوّر تدريس الفلسفة في جامعاتنا؟ بحث في إشكالية منطق الحِجاج البلاغي
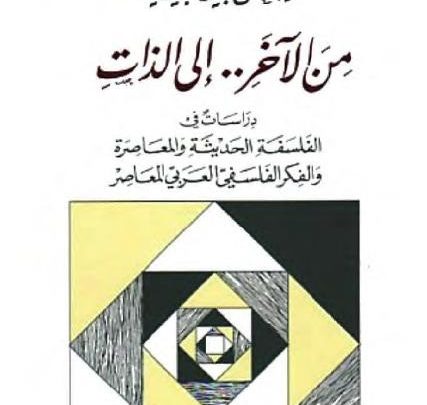
ملخص البحث:-
يهدف بحثنا إلى مناقشة آراء أبرز رواد الفلسفة العراقية تجاه عملية إنتاج الخطاب الفلسفي داخل قاعة الدرس؛ ومناهجه المعتمدة؛ وآليات التواصل بين الأستاذ والطلبة. وبطبيعة الحال، سوف يأخذنا ذلك إلى مراجعة نصوصهم الفلسفية والنظر فيها من وجهة تحليلية حِجاجية نقدية. وبعدها، سوف تحاول تسيلط الضوء على مسألة مهمة للغاية، تتعلق بأن هذه النصوص، وعلى الرغم، من دعواتها المتكررة في مجملها إلى بناء نظرية جديدة في التفلسف الحرّ القائم على اسس التفكير الموضوعي، إلا أنها كانت تفتقر إلى مراجعة للأُطر الابستمولوجية لخطابنا الفلسفي العراقي، والمبنية على نظرية المنطق الصوُّري/أو الشكلاني التي لطالما انشغلت بصياغة القوالب اللغوية والرمزية وصحة بناء اشكالها المنطقية، وأنعزلت عن سؤال السياقات التاريخية والاجتماعية والاخلاقية والسياسية. وهو السبب الرئيسي الذي جعلها نظرية تستند إلى منطق البرهان القسري الألزامي بواجب التسليم والأذعان لصدق المقدمات الأولى دون سؤال أو نقاش أو حوار. وقد استعرضنا لتاريخ الصراع بين بلاغة الفلسفة البرهانية وبين فلسفة الحِجاج النقدية منذ عصور الحضارات اليونانية القديمة، وحتى العصور الحديثة ونشأة نظرية البلاغة الجديدة لمؤسسها الفيلسوف البلجيكي شاييم بيرلمان. وتبيَّن، أنه من المستحيل أن يتولد تفكير حرّ؛ وتفلسف حرّ في ظلّ سيطرة مناهج أقيسة البرهان ومنطقه الرمزي المطلق الحتمي. وفي ضوء ذلك، يجب إعتماد منهج الحِجاج البلاغي وتدريس نظريته في البلاغة الجديدة في أقسام الفلسفة في مختلف جامعات العراق، إذا ما اردنا تحقيق أهداف الجامعة وقسم الفلسفة في «بناء تفلسف حرّ وإشاعة الفكر النقدي وروح الحوار الفكري».
كيف نطوّر تدريس الفلسفة في جامعاتنا؟
بحث في إشكالية منطق الحِجاج البلاغي
اقتبسنا عنوان بحثنا من سؤال الفيلسوف الراحل حسام محيّ الدين الآلوسي الذي طرحه بالقول: كيف نطوِّر تدريس الفلسفة في جامعاتنا؟ في كتابه الفلسفي الموسوم «العقلانية ومستقبلها في العالم العربي» والصادر في عام 2011. وربما، يعد هذا السؤال هو جامع مانع لأحد أكبر الهموم المشتركة بين رواد الفلسفة العراقية على اختلاف تخصصاتهم وانشغالاتهم المعرفية، وأبرزهم أستاذ المنطق وفلسفة العلوم ياسين خليل، وأستاذ الفلسفة الأسلامية مدني صالح، وأستاذ التصوف وعلم الكلام عبد الستار الراوي، وأستاذ الدراسات الأسلامية حسن مجيد العبيدي. وذلك، لأنه سؤال مركزي كان يمثل عند الآلوسي، كما عند بقية الرواد، هو نقطة الانطلاق نحو صياغة نظرية جديدة في التفلسف، بل وفي الخطاب الفلسفي والثقافي برمته، تقع بالضد من جميع «أشكال التسلط والقهر والتعصب والتسليم والطغيان والاستبداد». وهذا، بالطبع، يعود إلى أن شكل العقلانية التي كان يبتغيها الآلوسي: «لم تكن لتعني منظومة مبادئ فلسفية مجردة، ولا إرادة سيطرة على الطبيعة والانسان فحسب، لا سيما بعد أن حوّلت العقل عند المفكر السياسي الديني والأخلاقي والفلسفي إلى نظرة مغايرة لما كان يقال عن الأنسان والدين والدولة في الوطن العربي. ومن هنا فإنها تتطلع إلى نظرة جديدة تقاوم التسلط، ليس بموجب تناغمها وتناسقها مع مبادئ منطقية، وإنما عملاً بمضمون قيمي إنساني يحمي إذا ما تحرر الإنسان الفرد والمجتمع من الاستبداد الذي تحكم فيهما»1.
من هنا، يبدو أن الآلوسي جعل «فعل التفلسف الحرّ» يقع بالضد من «أشكال التسلط والقهر والتعصب والتسليم والطغيان والاستبداد». وهو ما يفسر طبيعة مفهومه للعقلانية الذي بدا واضحاً، وعلى طوال صفحات كتابه، أنه لا يجتمع ابداً مع أدوات القسر والإلزام المقترنة، على الدوام، مع منطق الجزم والقطع والبرهان. وهذا ما جعله يؤكد بالقول:
«نحن نقصد بالعقلانية هنا، وبشكل يزيل كل لبس، فعل التفلسف المعتمد على التفكير الحرّ »2. وهو فعل لا يقوم على القسر والإكراه، وهذا ما يتشارك فيه الأستاذ مدني صالح خلال حديثه عن (قضايا المداخل إلى الدرس الفلسفي)، مؤكداً على ان أستاذ الفلسفة :
«يجب – لا بد من هذا الوجوب – أن يكون معلم الفلسفة ذكياً نابهاً مقتدراً ومتمكناً من الدرس الفلسفي تمكن الناقد المقارن المستخرج المستخلص المستنتج. ويجب أن يكون محباً للطلبة قادراً على التتلمذ عليهم في الحوار الفلسفي وتبادل الأفكار مبتهجاً بتدريبهم يتدربون عليه ويتمرسون في فنون الرفض والمعارضة والقبول وإجادة فن الوقوف ضد القبح… ويجب أن لا يحمل الطلبة على الدرس الفلسفي قسراً بالإكراه»3.
يتضح، من ذلك، أن «فعل التفلسف المعتمد على التفكير الحرّ » عند الآلوسي -كما عند مدني صالح- هو فعل لا يقتصر فقط على التلميذ. فلا يمكن أن يتحقق هذا الفعل ويتم انجازه بمفعول مؤثر في المتكلم/المخاطِب والمتلقي/المخاطَب، دون أن يكون فعلاً تواصلياً متفاعلاً متبادلاً بين التلميذ والأستاذ. وهذا يعني، بالضرورة، أنه كان على الآلوسي -وعلى صالح أيضاً- الأنتقال بمنطقة اشتغالهما إلى الأطر الابستمولوجية المتعلقة بالمناهج والمفاهيم التي تصيغ وتكوّن الاقوال والعبارات الشفاهية والمكتوبة في النصوص الفلسفية المعتمدة في الدرس الفلسفي؛ والمتداولة داخل قاعة الدرس الفلسفي؛ وفي مناهج اقسام الفلسفة على حد سواء. لأنه، وبكل بساطة، يمكننا المحاججة، بالتساؤل ما الجدوى، إذن، من نشدان الآلوسي وصالح تحقيق غاية فعل التفلسف المعتمد على التفكير الحرّ والحوار الفلسفي المتبادل، لو انها كانت موجودة من الأصل ومتحققة على أرض الدرس الفلسفي، ولو كان يتم ممارستها بشكل تلقائي وعفوي في اقسام الفلسفة؟
لكن، لما كانت ممارسات التفكير النقدي التي ينبغي أن تنشأ في رحم الحوار والتفلسف الحرّ ، أي في محاضرات المنطق وفلسفة العلوم، هي واحدة من الممارسات التي لا تستقيم مع بنية المنطق الصوُّري/أو الشكلاني الذي تم اعتماده منهجاً اساسياً في جميع أقسام الفلسفة في جامعات العراق وما يزال حتى يومنا هذا. لانها بنية تقوم على «التسليم والإذعان والخضوع» لصدق المقدمات التام بوصفها حُجَج السلطة غير النافدة الصلاحية بشكل مطلق، مما يجعل نظام الاستدلالات التحليلية المبنية عليها، هي استدلالات قسرية إلزامية، وقد وضعها الفيلسوف أرسطو، بالأصل، لخدمة العلوم الرياضية والهندسية القائمة على الحسابات العددية الكمية الصائبة المطلقة، ولا يمكن ابداً استعمالها في صناعة الآراء وصياغة الآحكام القيمية اللازمة في ادراة شؤون الحياة الانسانية، لانها عندئذ تنبني على الفرض والأكراه حسب فيلسوف البلاغة الجديدة شاييم بيرلمان. وحسبنا وصف الدكتور عبد الستار الراوي لمحاضرة المنطق الصوّري للدكتور ياسين خليل الذي عمل أكثر من ربع قرن استاذاً للمنطق وفلسفة العلوم في قسم الفلسفة-كلية الآداب-جامعة بغداد، لتتضح لنا أبعاد تلك البنية البرهانية المسيطرة على الدرس الفلسفي:
«استغرقت محاضرة الدكتور ياسين خليل في مادة ( المنطق الصوُّري/الشكلاني ) ساعتين بالتمام والكمال، تحدث خلالهما دونما توقف… جاء فيها بالحديث عن المنطق الرمزي أيضاً بالقول أن المنهج الاستنباطي (الاستدلال) ، وميزته القدرة على توليد عدد لا حصر له من الأحكام الجيدة والباهرة من عدد صغير من الأحكام عن طريق تطبيق عدد محدد من القواعد. وقبيل إنقضاء المحاضرة وجه فالح إستيضاحاً إلى د. ياسين خليل: ( .. لا أشك أن بإمكانك يا أستاذنا أن تمنح هذه المادة الجافة بعض ( الطراوة )، التي تجعل منها موضوعاً قابلاً لفهم وتمثل ( رمزيته ) و(إشارته).
– أجاب الأستاذ : (إنا لله وإنا إليه راجعون .. ولا حول ولا قوة إلا بالله )..
واصطفق الباب وراءه ومضى ! »4.
وهنا، علينا أن نتساءل، عن الأسباب التي دعت المختصين في المنطق إلى التأكيد على منطق البرهان واستدلالاته التحليلية القسرية واعتماده منهجاً رسمياً في التدريس، وإلى ان يهملوا، بالمرة، منطق الحِجاج البلاغي، وان يتغافلوا تماماً عن الأشارة من بعيد أو من قريب إلى استدلالاته الجدلية، منذ نشأة قسم الفلسفة الأول في العراق عام 1949 وحتى يومنا هذا؟ من دون شكّ، لم تنفصل هذه الممارسة في التدريس عن الهدف الذي تأسس من اجله قسم الفلسفة على «منهج علمي» سعياً لتحقيق أعلى مراتب «الدقة؛ والثبات، الموضوعية وهي سمات جوهرية تتميز بها اللغة العلمية التي لا تحتمل اللبس والإبهام والغموض السمات الغالبة على لغة الحياة اليومية والآراء الإنسانية المتبدلة». وهذا ما يوجزه لنا نص الدكتور حسن مجيد العبيدي في كتابه الموسوم «من الآخر.. إلى الذات… دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، والفكر الفلسفي العربي المعاصر» والصادر في عام 2008، بالقول:
«من المعلوم أن قسم الفلسفة بجامعة بغداد كان يعدّ القسم الوحيد في كل الجامعات العراقية، ولا يوجد له نظير لغاية عام 1992. فقد تأسس هذا القسم للمرة الأولى عام 1949-1950م، بوصفه جزءا من أقسام كلية الآداب والعلوم آنذاك. وكان الهدف من تأسيسه هو بناء فكر علمي يستوعب التحليل الواعي لطرائق البحث ولصياغة نظرة كونية شاملة، تظهر فيها أوجه مختلفة من مواقف فلاسفة العالم قديماً وحديثاً ومعاصراً. فضلاً عن ان الطالب الجامعي في تفهمه موضوعات الفلسفة وطرائق نقدها ينفتح امامه مجال التفكير والأستنتاج، مما سيقوده إلى تنمية مداركه سواء ما كان يتعلق منها بمشكلاته المعاصرة أم ما يرتبط بشكل او بآخر بالتراث الحضاري للإنسان عموماً.»5.
لكن، ما المانع من تفعيل الاستدلالات الجدلية ومنطق الحِجاج البلاغي، وفي الوقت نفسه، العمل على تحقيق الهدف المراد لقسم الفلسفة في «بناء فكر علمي» والانفتاح على « مجال التفكير الحرّ والأستنتاج»؟ هل كانت«الأقاويل البرهانية هي قوانين الأمور التي تلتئم بها الفلسفة، وكل ما تصير به افعالها أتم وافضل وأكمل»6 حسب تعبير الدكتور ياسين خليل؟ وهل كانت التعددية الأيديولوجية في الجامعة مدعاة للقلق والخوف، وهو ما عبر عنه الدكتور ياسين خليل نفسه، في مقاله المعنون (دور الجامعة في الدول النامية) الصادر في عام 1975، بالقول:
«وفي سبيل فهم أبعاد التجربة العراقية في مضمار الجامعة، لا بد من فهم ما تعانيه الجامعات في الدول النامية من صراع مرير بين التيارات المذهبية والفلسفية والايديولوجية. فالجامعة في معظم الدول النامية تشهد في الوقت الحاضر صراعات ايديولوجية عنيفة، وان طلبة الجامعة منقسمون على انفسهم إلى فئات أو أحزاب، وان اختلاف المواقف من الحياة والمجتمع والانسان والدولة اصبح هو الطابع المميز للحياة الجامعية. وقد زاد من اختلاف المواقف، اعتناق الكثير من الأساتذة والطلبة لفلسفات ايديولوجية متنوعة ومتناقضة في بعض الاحيان، واختلفت الايديولوجيات من حيث القوة والتأثير لاختلاف القوى التي تشهدها وتحميها وتقف من ورائها، فهناك ايديولوجيات دولية واخرى اقليمية واخرى قومية، وان الصراع بينها في إطار الجامعة معناه في الوقت نفسه محاولة هذه الايديولوجيات توليد قناعات لدى الطلبة، فتحرك بذلك سلوكهم وتطبع تصرفاتهم ونظرتهم إلى الحياة. إن العراق وهو جزء من الامة العربية يتعرض من دون شك لتيارات وفلسفات كثيرة وتتعرض الجامعات باعتبارها مراكز للاشعاع الفكري وتربية الاجيال المثقفة لهذه التيارات بشكل عنيف. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو:
هل ينحصر دور الجامعة في تخريج طلبة يحسنون استخدام الآلة والمختبر، أم يتعدى ذلك إلى بناء شخصية المواطن الذي يوجه استخدام الآلة ونتائج المختبر لخير المجتمع والأمة؟»7.
فهل وجد الدكتور ياسين خليل ضالته في «الأقاويل الأرسطية البرهانية» التي توفر وحدة في الشكل والمعنى والدلالة بواسطة صيغها الرمزية المنطقية الكلية الموحدة؟ وهل ثقته بهذه «الأقاويل البرهانية» كبيرة إلى الحد الذي جعله يتصور أن بمقدورها أن تضم أكبر عدد ممكن من مواضع المعرفة والاعتقاد المنتمية لأيديولوجيات محلية واقليمية وتدمجها في ايديولوجيا أحادية كلية؛ لتقضي على أشكال التباين، وتقوم بتحييد الاختلافات وبما يمنع أي تعددية في المعنى أو تفاوت في درجات البداهة والوضوح للأفكار قد يسبب اللبس والغموض المدعاة للشك في مبادئ الأيديولوجيا المسيطرة؟ فهل كانت «الأقاويل البرهانية» عند الدكتور ياسين خليل هي «قوانين الفلسفة الأتم والأفضل والأكمل» التي باستطاعتها أن تمثل مجموعة: «ضوابط عامة وقواعد اساسية لبناء الشخصية القومية المرتبطة بالأرض والأمة، فلا تدع المواطن ريشة في مهب الريح تقذف بها التيارات من كل صوب»8؟
وهل أمكننا أن نبني شخصية متفلسفة مستقلة بواسطة منهج المنطق البرهاني الذي تقوم استدلالاته التحليلية على الحفظ والتلقين والقسر والإلزام؟ الجواب بالنفي بكل تأكيد. والدليل، أننا وإلى اليوم، وبعد مرور ما يزيد عن قرن من الزمان عن سنوات التأسيس لقسم الفلسفة في جامعة بغداد، نطالع عبارات اليأس من حال الفلسفة والنقد الصارخ تجاه العملية التدريسية بصريح العبارة من أهم روادها والمختصون في الدراسات الفلسفية ، وفيها يقول الدكتور حسن مجيد العبيدي:
«أن معظم طلبة الفلسفة في العراق يجدون في هذا القسم ليس ضالتهم، بل اندحارهم. فضلاً عن ذلك، فإن مدرس الفلسفة في الجامعة لا يجيد إلا رصف المذاهب الفلسفية رصفاً تأريخياً لا يحيد عنه، كما يستعرض حياة الفلاسفة ومؤلفاتهم لساعات طويلة، في حين لا يقف امام آرائهم وأفكارهم سوى فترة وجيزة، ولا يقدم أي تحليل أو نقد يشجع الطالب على شحذ ذهنه وإثارة روح النقد لديه، مما نجم عنه أن الطالب اصبح متلقياً سلبياً أكثر مما هو ناقد فعلي لهذه المدارس الفلسفية أو مقارن لها بعضها مع بعض.
ومثلما اشرنا من قبل، فإن واقع الفلسفة في العراق بهذه الكيفية قد انعكس هو الآخر على مستوى الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، إذ هي الأخرى قد سادها طابع التاريخية السردية على النقدية التحليلية المقارنة…إن علة ذلك برأينا تعود إلى طبيعة المناهج الدراسية نفسها، وهي التي اسهمت في هذا التصور في ما بعد لدى طلبة الدراسات العليا عند كتابتهم لرسائلهم وأطاريحهم الجامعية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى حد أن حاملي التخصص فيها اصبحوا هم أيضاً جزراً متناثرة، فالمتخصص في الفلسفة اليونانية لا يحق له أن يدرِّس الفلسفة الأسلامية أو الحديثة أو المعاصرة، أو يكتب فيها ويبحث. فقام معه جيل فلسفي منغلق على تخصصه ولا يقبل بالرؤية المنفتحة على تخصصات أخرى في داخل حقل اختصاصه. كذلك غاب عن هذه المناهج الدراسية صلة الفلسفة بالعلوم الانسانية الاخرى.
في ضوء ذلك كله، يمكن القول ان واقع تدريس الفلسفة وتعليمها في العراق لا ينبئ بمستقبل طيب لها، سواء على الصعيد الجامعي الأكاديمي، ام على الصعد الأخرى اجتماعياً وسياسياً وثقافياً وايديولوجياً»9.
فهل عجزت البنية التحتية الصوُّرية البرهانية، المعتمدة في كتابة وتحرير وتدريس الفلسفة، عن تحقيق «فعل التفلسف المستند على التفكير الحرّ » الخاص بألآلوسي، و«الإنفتاح في مجال التفكير والاستنتاج» الخاص بالعبيدي، لا عند الأستاذ ولا التلميذ ولا الخطاب الفلسفي برمته؟ ولم تتمكن، بالتالي، من صياغة المقدمات المبني عليها قسم الفلسفة في «بناء فكر علمي يستوعب التحليل الواعي لطرائق البحث ولصياغة نظرة كونية شاملة»، مع أنها تعتبر من الناحية الشكلية هي «صيغ منطقية صادقة» وفق المنطق البرهاني، وكان يجب أن نستخلص منها نتائج صادقة بالضرورة تتعلق بـ«الطالب الجامعي من ناحية تفهمه لموضوعات الفلسفة وطرائق نقدها لينفتح امامه مجال التفكير والأستنتاج، مما سيقوده إلى تنمية مداركه سواء ما كان يتعلق منها بمشكلاته المعاصرة أم ما يرتبط بشكل او بآخر بالتراث الحضاري للإنسان عموماً». وهل كانت هذه البنية البرهانية هي القاعدة والدعامة لعقود من انحطاط الخطاب الفلسفي وتدهوره؟ وهذا ما يكشف عنه الدكتور العبيدي بالقول:
«عندما يكون تاريخ الفلسفة فقط هو المهيمن في التدريس على التفلسف، عند ذاك تسود روح التقليد والببغاوية والحفظ، وهي السمة السائدة على هذه المناهج، في غياب روح النقد والتحليل اللذين هما من سمات التفلسف الحقيقي. إن كاتب هذه السطور يعتقد اعتقاداً اقرب إلى اليقين منه إلى الظن بحكم التخصص، وهذا الاعتقاد هو ان الفلسفة في العراق المعاصر سوف تبقى وإلى أمد بعيد محكومة بمنهجية ذات طابع تقريري تاريخي فاقد لأصول التفلسف الحقيقي، لأنها تحولت إلى حرفة للأرتزاق وليست إلى ممارسة حقيقية لفعل التفلسف»10. بعبارة أخرى، إن المقدمات الأولى المستندة عليها عملية إنتاج الخطاب الفلسفي، وإن كانت صادقة في شكل صياغتها البرهاني الرياضي فهي لم تكن تاريخية بالمرة، فكانت وما تزال تعتبر «مداخل خائبة» حسب تعبير مدني صالح، وقد لخصها في ثلاثة مداخل رئيسية:
«اولاً– مدخل الما أدراك: حيث يبدأ الأستاذ درسه بخطته على نحو ما يلي: الفلسفة وما أدراك ما الفلسفة…انها بداية المعرفة، وإنها أم العلوم جميعا، وإنها كانت تضم كل المعارف وكل العلوم….وإلى آخر خطبة «الما أدراك» التي قد تستمر أسبوعاً أو أسبوعين، أو ربما شهراً، بل قد يدور حولها الأستاذ أكثر من ذلك.
ثانياً– مدخل الفيلوصوفيا والماء: حيث يبدأ الأستاذ درسه بأن الفلسفة تعني الفيلوصوفيا وأن «فيلوصوفيا» هي كلمة يونانية تعني باللغة العربية (حب الحكمة)…. هذا وقد تطيب للأستاذ الإقامة في ربوع «الفيلوصوفيا» هذه فيديم الوقوف عندها بالشرح والتفسير والإطالة والتقصير مدة أسابيع لا يدخل معها إلى الدرس شيئاً غير فقرات من خطبة «الما أدراك».
ثالثاً-مدخل التأستذ بالفلسفة بلا تحصيل: حيث هناك اساتذة لا يدري أحد من أين جاؤوا إلى الفلسفة. لكن العارف بأبسط مبادئ الفلسفة لا يخطئ أنهم جاؤوا إليها من التخصص بغيرها على سنة المستشرقين وامتهنوها حرفة للتأستذ مستضعفين حالها بستاناً واطئ الحيطان ضعيف النواطير. ومدخل هؤلاء إلى الدرس الفلسفي محكوم بكل مظاهر وظواهر وطقوس الحديث في موضوع بلا تحصيل. هذا، وقد يركن هؤلاء إلى خطبة «الما أدراك» وإلى شيء من خطبة «الفيلوصوفيا» والماء… إعتذارا عن الهرب من مواجهة المسائل والقضايا الفلسفية بشرح وبتحليل وبإعادة تركيب وباستنتاج وبإلقاء النتيجة في الدرس، من اجل ابتكار حوار فلسفي تربوي اكاديمي رصين في التأسيس الثقافي اللازم ضرورة لكل المحاورين»11.
لاحظوا، أن سيادة «المداخل الخائبة» لا ينفصل عن سيطرة اللغة البرهانية المستندة على الدوام إلى مسلمات قبلية؛ مقدمات صادقة؛ واحكام جاهزة مسبقة. ومن ثمة، فهي تحول دون تحقق «فعل التفلسف المعتمد على التفكير الحرّ »، و«الإنفتاح في مجال التفكير والاستنتاج»، في سبيل «ابتكار حوار فلسفي تربوي اكاديمي رصين في التأسيس الثقافي اللازم ضرورة لكل المحاورين». وهو ما يؤيد فرضية أستاذ المنطق وفلسفة العلوم ياسين خليل التي طرحها في مقاله المعنون (دور الجامعة في الدول النامية) والمنشور في مجلة آفاق عربية في عام 1975: «فإذا اقتصرت الدراسة الجامعية على التلقين النظري، واقتصار المناهج الدراسية على الدروس النظرية البحتة، واقتصر تحصيل الطالب على المراجعة الذهنية والتحضير النظري، اصبحت الدراسة الجامعية غير مجدية، لأن الطالب سوف لن يقدر على تحويل الخبرات النظرية إلى عملية، وتبقى جهوده محصورة في إطار ضيق لا يؤدي إلا القليل في مجال التنمية والتقدم»12.
معنى ذلك، أن «المنظومة المنهجية والمفاهيمية الأرسطية البرهانية» التي استند اليها رواد الفلسفة في طرق تدريسهم للنصوص الفلسفية، تستدعي عملية نقد ومراجعة تستند إلى تقنيات التحليل الحِجاجي. وهذا ما تم التغافل عنه من قبل جميع رواد الفلسفة، ومن قبل جميع المختصين والاساتذة في اقسام الفلسفة العراقية حتى يومنا هذا. وإذا كان فيلسوف البلاغة الجديدة شاييم بيرلمان قد نبه الغرب في خمسينيات القرن الماضي إلى اهمالهم البحث في الاستدلالات الجدلية المتعلقة بالحِجاج لما يزيد عن ثلاثة قرون، «وإلى، أنه، بإستثناء عمل واحد أو آخر في القرن الثامن عشر تم تكريسها للبحث في الطوبولوجيا القانونية، فإن نظرية الحِجاج كانت مهملة بالكامل تقريباً من قبل الفلسفة والمنطق ما بعد الديكارتية. أما في عصور الحضارات الاغريقو-رومانية القديمة، والعصور الوسطى لا سيما في عصر النهضة، فقد تم دراسة المشكلات التي تتصدى لها نظرية الحِجاج، لكن، من قبل مؤلفين كان تعاملهم مع البلاغة والطوبولوجيا، وفحصهم للأدلة الإثباتية الحِجاجية التي اصطلح عليها أرسطو بـ «استدلالات جدلية»، هو من اجل معارضتها مع أدلة المنطق الصُّوري/الشكلاني في الإثبات، أي بما دعاها أرسطو بـ «استدلالات تحليلية» التي تهدف إلى البرهان وليس إلى الحِجاج»13.
فكيف لنا أن نطوّر الدرس الفلسفي في جامعاتنا، ونحن في القرن الحادي والعشرين، ما زلنا لم نعترف بعد بقيمة الاستدلالات الجدلية، وبأهمية منطق الحِجاج البلاغي، ودون أن يتم إقرار تدريس منهج الحِجاج الفلسفي؟ هذا على الرغم من قيام الجامعات العربية بتفعيل منهج الحِجاج الفلسفي وتدريسه في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا منذ عقود من الزمن، دون الحديث عن مراحل التعليم الثانوي الذي تدرس فيه مادة الحِجاج بشكل عام، وقد كانت هذه الجامعات بمختلف تخصصاتها ومختبراتها العلمية ومكتباتها الاكاديمية، هي السباقة في استيعاب واعتماد الترجمة العربية التي قمنا بإنجازها تحت اشراف ومراجعة وتقديم رائد الحِجاج اللغوي البروفيسور المغربي أبو بكر العزاوي، وهي الترجمة الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، والتي ضمت أهم النصوص الحِجاجية الاساسية لمُنظر البلاغة الجديدة الفيلسوف شاييم بيرلمان (1912-1984).
من هنا، فإننا ننبه إلى ان الاستمرار على هذا النهج البرهاني القسري في اقسام الفلسفة عندنا، سيفضي لا محالة إلى اصابة روح التفلسف الحرّ، كما رأى الدكتور حسن مجيد العبيدي:« بالعطل والتبلد وسينظر إلى الفلسفة نظرة تجزيئية مثالية طوباوية غير واقعية، وان الفيلسوف الذي نسميه هكذا لن يقوم من بيننا ليقول لنا قولته ورأيه، لأنه محكوم بغفلة السؤال الفلسفي عبر دراسته الفلسفة جامعياً أكاديمياً، ولخوفه المستمر من إثارة السؤال الفلسفي مع نفسه ومع واقعه ومجتمعه وقيمه وحضارته. وعليه، لا بد أن نجد مناهج دراسية توائم وتلائم بين التفلسف الحقيقي وتاريخ الفلسفة؛ مناهج تثير فينا روح النقد والتحليل والبناء والمشاركة الحضارية الإنسانية والعلمية؛ مناهج تواكب روح التقدم العلمي وثورة المعلومات والتقدم التقني وغير ذلك مما يخدم التفلسف وينمّيه ويخلقه… لا مناهج ما زالت تقرأ أفلاطون وأرسطو وابن رشد وديكارت وراسل بروح العصر الوسيط ومناهجه وايديولوجيته ورؤيته الدينية والسياسية والاقتصادية»14.
– مقدمة في تاريخ أنطولوجيا المنطق البرهاني وفلسفة الحِجاج
تعود بدايات الدرس الفلسفي الحِجاجي إلى الفلاسفة السفسطائيين بروتوغوراس وغورغياس وهيباس، الذين عملوا على تفعيل هذه الممارسة الثقافية التي تشكل مقدمة تمهيدية لكل تاريخ سوسيو-ثقافي/وتعليمي/وسياسي بالضرورة. فمع الخطاب التربوي/الثقافي الجديد للسفسطائيين، جرى تدشين قطيعة ابستمولوجية مع البرادايم البلاغي التعليمي/النخبوي الافلاطوني المسيطر. حيث كانت الحظوة لبلاغة «التعليم العسكرتاري» التي تتأسس على القواعد الأفلاطونية في «ضبط ومراقبة النفس» من اجل تحويل الإنسان إلى كائن عقلاني خاضع وبصورة قسرية إلى معايير وقواعد علم النحو الشكلاني الخاص بالطبقة النخبوية، إضافة إلى شروط الالتزام بطرق التلقين والحفظ بل والنطق أيضا وفق معايير محددة، مع ضرورة التشديد على قاعدة اجتناب إعادة قراءة وتحليل وتأويل ونقد النصوص الفلسفية والأدبية. هذه كانت هي أهم خصائص البلاغة الأفلاطونية التي تنطلق فيها من الاعتقاد الجازم «بأن النصوص صامتة ولا تحتاج للشروحات والتعليقات التي لا تزيد عن كونها ثرثرة ولغو فارغ »15.
من هنا، يمكننا القول أن البلاغة الفلسفية الأفلاطونية المشيدة على مفهوم الحقيقة vérité، لم تكن تضع في عين الاعتبار قيمة للمخاطَب/الجمهور/المتلقي auditoire العادي الذي استحال داخل أسوار منظومتها العقلانية الصارمة مجرد أداة خاضعة لبنية القوانين الأيديولوجية السائدة. وإنما كانت تركز في المقام الأول على الكيفية التي يجري بواسطتها الحفاظ على ثبات المنظومة اللغوية والقيّمية. لذلك استعانت بمنطق الحِجاج البرهاني argumentation démonstrative وبالطريقة التي يمكن أن يتم فيها إجراء عملية إدغام ظواهر الركود والثبات بواسطة آليات القسر المؤسساتي اليومي لغرض إجبار الأفراد ومن ثمة الحشود على تحويل الحقائق المطلقة إلى ممارسات يومية يجددون خلالها عهد الولاء وبطريقة لاشعورية لأحكام شرعيتها وضمان صلاحيتها غير القابلة للنفاد على الإطلاق.
نتيجة لذلك، ساهم أفلاطون بطريقة ما أو بأخرى في تشكيل أشبه بعقدة او بإعاقة لسانية linguistique على المستوى الذهني واللغوي والجسدي. وعمل على إفراغ البلاغة من مقوماتها الحجاجية التأويلية الأساسية التي تؤسس لمبادئ «الحوار والتواصل بين عقول المخاطبين من جانب؛ وبين المؤسسات الاجتماعية والسياسية من جانب آخر»16. وجرى اختزالها في الوقت ذاته إلى مجرد تقنيات بيداغوجية تقليدية وسايكولوجية وأدبية لتشكل فيما بعد الدعامة الأيديولوجية في عملية تثبيت الحقائق النخبوية لأغلبية فئوية محدودة وتهميش المنظومات القيّمية الأخرى والخاصة ببقية الفئات الاجتماعية. لتؤسس بذلك لـ«بلاغة انضباطية» قسرية بامتياز.
لكن، ومع النظام التعليمي/الثقافي السفسطائي –البايديا Paideia– الجديد حصلت ثورة راديكالية واسعة لم تقتصر على التحول الدلالي لمفهوم البايديا ليشير للمرة الأولى لمفاهيم التربية والثقافة17، بل وجرى كذلك تفعيل ابستمولوجيا فلسفة الحِجاج الثقافية والانطلاق إلى رحاب اللغة الطبيعية والعالم اليومي والمخاطَب العادي وسياقاته التاريخية والثقافية. وذلك بالاستناد على منطق الحِجاج البلاغي الذي يقوم أساسا على أدوات الجدل والحوار والنقاش التي تضع وعلى نفس القدر من الأهمية والاعتبار كل من: المتكلم ethos والخطاب logos والمخاطَب/الجمهور /الباثوس pathos المعادل للرأي والأهواء والانفعالات والمشاعر والخيال والتي تشكل في مجملها القدرات الإدراكية والذهنية والعقلية والجسدية للذات والتي تؤثر بالضرورة على عملية تشكيل الأحكام الأخلاقية والقيّمية/المفاهيمية لدى المخاطَب. نتيجة لذلك، كان هناك ثمة تلازم وثيق بين تحول مفهوم البايديا السفسطائي؛ وبين عملية إعادة الاعتبار للمخاطَب/الباثوس وبين امتداد جغرافية الدرس الفلسفي الحِجاجي بفضل السفسطائيين في عموم أرجاء الدولة الديمقراطية اليونانية. والسبب في ذلك إنما يعود لان منطق الحِجاج البلاغي يشتغل على تحليل منطق أحكام القيمة بهدف «العمل على تحليل النسق الهرمي للقيّم الذي يجري فيه نقش وحفر المبادئ العليا والدنيا والمتداخلة ضمن سلسلة من العلاقات التراتبية في العقل الإنساني. فهذه العلاقات تحيل بالضرورة إلى سلسلة لامتناهية من عمليات التمأسس الهرمي التي تتشكل عبر منطق الاعتقادات والقيم والأحكام المسبقة التي أصبحت في مجملها هي مقياس كل شيء في الواقع الإنساني اليومي»18. وبهذه الطريقة اتسعت أبعاد فلسفة الحِجاج السفسطائية النقدية لتشمل نقد المنظومات المنطقية والدلالية واللسانية واللغوية، ولتمتد إلى الأنظمة الفلسفية والسياسية والتشريعية والاجتماعية والقانونية لا سيما وان الدولة اليونانية كانت تمر بتحولات سياسية كبيرة شملت جميع الأصعدة بدء من عملية تشكيل المؤسسات البرلمانية والمحاكم القضائية وحتى أنظمة المؤسسات التربوية والتعليمية.
ولم تتحقق تلك التطورات في السياق الثقافي اليوناني إلا بعدما تحول نظام التعليم نفسه إلى خطاب سوسيو-سياسي يعمل على إعادة الاعتبار إلى كل من: المدرسة/المؤسسة التعليمية بوصفها الوسط الاجتماعي/السياسي بامتياز. حيث يكون فيها الدرس الفلسفي الحِجاجي هو القاعدة الأساسية في بناء فعل تواصلي تداولي pragmatique بين الأستاذ والتلميذ، وذلك بواسطة استعمال تقنيات الخطاب الحِجاجية التأويلية التي تتطلب الأعداد والتهيئة الكاملة لاكتساب الخبرة المفاهيمية والمعرفية الكافية في استعمال تلك التقنيات مثلما كانت لدى المعلم السفسطائي. وذلك ليكون الأستاذ على استعداد للحوار والنقاش والجدل الحِجاجي المنفتح على إمكانيات التحليل اللغوي والفلسفي والاجتماعي والسياسي والتأويل ألتعددي لمختلف الخطابات الثقافية، من اجل أن تتحقق حالة من التطور الدلالي الذي تلحقه بالضرورة عملية تدريجية من التحول الذهني والإدراكي.
–التحول الديمقراطي: من الفلسفة البرهانية إلى خطاب الحِجاج النقدي
لم يكن في الإمكان إعادة اللحمة بين كل من: الفلسفة والحِجاج البلاغي، من اجل بناء فلسفة حِجاج ثقافية/وثقافة فلسفية حِجاجية والتحرر من النزعة المفاهيمية الدوغمائية لأفلاطون دون أن يكون هناك ما يقابلها وبشكل متواز عملية متكاملة تهدف إلى إعادة الاعتبار لموروث الثقافة الشعبية أي لتاريخ الحس المشترك /مجمل القيّم الأخلاقية doxa الذي تتأسس عليه فاعلية تقنيات الحِجاج البلاغي. فمن المعروف انه لطالما جرى إقصاء تاريخ الحس المشترك واستبعاده لصالح التاريخ النخبوي للفلسفة التقليدية/تاريخ فلسفة الحقيقة المطلقة الذي لم يكن له ليرسخ منطق مفاهيمه الثنائي الهرمي ويحوله إلى بنية ذهنية ثابتة وملتصقة إلى حد الامتزاج بالخلايا العصبية، ومتناقلة من جيل إلى آخر، لو لم يكن هناك ما يقابله من تاريخ طويل لعملية نبذ وازدراء لمجمل موروث الحس المشترك وما يتضمن عليه من إمكانيات فردية منفتحة على القدرات الذاتية من الخيال والمشاعر والانفعالات والأهواء. هذه القدرات في مجملها تشكل بالنسبة لفيلسوف الحكمة العدو اللدود للحقيقة. فكيف يمكن له البحث عن الحقيقة والوصول إليها دون أن يتحرر بصورة كاملة وعلى الطريقة الديكارتية من جميع هذه الأسباب المؤدية لإنتاج اللبس والغموض والتي تحول بالتالي دون الوصول إلى الحقيقة؟
من الواضح أن هناك تلازما وثيقا بين إقصاء تاريخ الحس المشترك وبين نفي كل قيمة وقدرة للإنسان العامي/المخاطَب على المساهمة في إنتاج القيّم. فعندما يجري حرمان المخاطَب من حقه في الإدلاء برأيه وطرح السؤال والنقاش بخصوص القضايا الإشكالية التي تلامس أدق تفاصيل حياته وهموم واقعه اليومي. فكيف يمكننا أن نؤسس لفلسفة حِجاج نقدية -ليست على الطريقة الكانطية- ؟ لا سيما وأن حق تحديد وتصنيف أشكال الكلام والتمييز بين ماهو مقبول وماهو ممنوع، هو امتياز للطبقة النخبوية المسيطرة التي تمسك بزمام السلطة وتتحكم بوسائل التواصل لتسمح بما تشاء وتمنع ما تشاء. من اجل أن تتفرد في تحديد وتصنيف طرق وأشكال الإدراك والقول والتواصل بين الأفراد وفق مقاييسها ومعاييرها الخاصة. فهل يمكن لنا أن نندهش بعد ذلك من الولادات المتكررة للأنظمة الشمولية؟
في أعقاب التحول الديمقراطي اليوناني، سعى الخطاب السفسطائي إلى التحرر من انطولوجيا الجوهر الأحادي -التي تشكلت مع جمهورية أفلاطون وعالم المثل والحقائق المطلقة- حيث يتطابق الوجود مع اللوغوس/الخطاب/اللغة/الكلام، ويجري التضييق على ذهن المخاطَب العامي بواسطة قيود علم النحو المعياري وآليات المنطق ألبرهاني الصارم التي لا تسمح للحشود أن يتداولوا سوى الحقائق المطلقة والمفروضة قسريا والذي يشكل بالضرورة عملية تواصلية في الكينونة المتطابقة. لذلك عمل الخطاب السفسطائي «على اقتلاع الكلام من الجذور الراسخة لذلك الوجود المتطابق، ونجح في تحقيق منعرج لساني turn أصبح معه اللوغوس لا يكشف عن الوجود» وإنما يمثل مجمل التقنيات الخطابية التي «هي بالنسبة إلى الروح كالعلاج/الفارماكون بالنسبة للجسد، حيث يمكن لاختلاف بسيط في كمية الجرعة المعطاة أن تكون علاجا للمريض أو أن تكون سما قاتلا له»19. وعندئذ يمكننا الانتقال إلى انطولوجيا الخطاب ألتعددي حيث يمكن للأفراد التواصل داخل منظومات متعددة من الخطابات المختلفة ويحققوا ما يُدعى بـ «تواصل العلاقات الإنسانية».
مع هذا التحول الثقافي الراديكالي، استطعنا الانتقال من تاريخ الفلسفة التقليدي إلى إنتاج الخطاب ألتفلسفي بوصفه واقعة لغوية تتطلب من الأستاذ والتلميذ في الدرس الحِجاجي التفلسفي معالجة النص الفلسفي/والثقافي بمناهج التحليل والنقد والقراءة والتأويل- هنا يتشكل مفهوم المثاقفة الحِجاجية- التي تقوم في مجملها على منطق الحِجاج البلاغي الاقناعي. وهو المنطق الذي يضع في عين الاعتبار المتكلم والخطاب، مع التأكيد على أهمية المخاطَب، ولمجمل الإمكانيات والقدرات المتضمنة في الأهواء والانفعالات والخيال والمشاعر التي تنحدر جميعها عن مفهوم الباثوس. فكما هو معروف أن أفلاطون الذي طبعت فلسفته العقلانية/الميتافيزيقية المتعالية الفكر الغربي برمته، «لم يأتِ على هذا المفهوم إلا عندما كان يريد الإشارة إلى الطبيعة المريضة والمعتلة وآثارها الجانبية على الذات الإنسانية والغير القابلة للعلاج لكونها طبيعة باثولوجية»20. ولم يتوقف تاريخ الإقصاء والاستبعاد إلى هذا الحد، بل امتدّ ليشمل كل ما من شأنه أن يُقلق مضاجع منطق الحِجاج ألبرهاني المستند على القسر والإرغام في التبرير وفرض حقائقه ومبادئه المطلقة، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الالتباس والغموض في المعاني الخالدة. فكان من المنطقي إذن أن يجري الإعلاء من شأن اللغة الرياضية/الصنعية على حساب اللغة الطبيعية التي تخرج على صيغ القوانين الرياضية الاستنباطية، فبلاغة العالم اليومي هي فضاء واسع ورحب ومنفتح على عوالم التقنيات الحِجاجية التأويلية لا سيما الاستعارة التي تخرج على مجمل قوانين منطق الحِجاج ألبرهاني الصارم.
وبالطبع، من اجل التحرر من منطق «البلاغة الانضباطية» الذي يمأسس مجمل القدرات الذهنية والإدراكية واللغوية للفرد وتحولها إلى ماكينات لاجترار النماذج التنميطية السائدة، ينبغي إعادة اللحمة بين ثقافة الحس المشترك والفلسفة والحِجاج البلاغي من اجل التأسيس لفلسفة البلاغة الجديدة التي دشنت لثورة راديكالية اتسعت لتمتد الى مجمل العلوم الاجتماعية والإنسانية واللغوية واللسانية. وهذا بالضبط ما قام به الفيلسوف “بيرلمان” لا سيما وهو قد اتخذ من التقنيات الحجاجية السفسطائية مرتكزا أساسيا في بناء فلسفته في البلاغة الجديدة، مثلما استند عليها من قبله الفيلسوف أرسطو وأسس اغلب كتاباته على الفلسفة السفسطائية كما هو معروف. إلا أن اغلب الدراسات البلاغية واللغوية واللسانية بل والمنطقية أيضا تركز على الدوام وبشكل صريح وواضح للغاية على المنطق الأرسطي دون أن تلتفت وتنبه في الوقت نفسه إلى جينالوجيا المفاهيم والمناهج والتقنيات الحِجاجية السفسطائية التي كانت خير معين لأرسطو في بناء فلسفته خصوصا في نظرياته المتعلقة بالمنطق والبلاغة والحِجاج وفلسفات القيّم والأخلاق والقانون.
ولا نعلم ما هي الظروف التاريخية التي أدت إلى هذا الإقصاء والإهمال والاستبعاد لخطاب الحِجاج البلاغي/الثقافي السفسطائي الذي مارسه الأكاديميون المختصون والباحثون المشتغلون في تلك الحقول؟ ولماذا كان هناك ما يقابله وبشكل متلازم تصعيدا لخطاب الحجاج ألبرهاني/الشمولي الأرسطي؟ ألا تدعو سياقاتنا التاريخية المأزومة إلى مساءلة حالة العداء للخطاب السفسطائي، ذلك العداء الأفلاطوني/الأرسطي الأصل والمرسخ بصورة لاشعورية على المستوى الذهني؟ وتكثيف العمل الأكاديمي في الوقت نفسه حول دراسة الخطاب السفسطائي ونظرياته في فلسفة الحجاج الثقافية والنقدية لغرض تقديم تحليل فلسفي واجتماعي لمختلف النصوص الفلسفية خاصة؛ والثقافية عامة، الكتابية والشفاهية منها دون تمييز؟ ألم يلحق المنطق الحِجاجي ألبرهاني الأرسطي آثارا بالغة الخطورة في ثقافتنا/لغتنا/الذات على جميع المستويات الذهنية والإدراكية والجسدية، ومن ثمة، على بنية العلاقات الاجتماعية وعملية التواصل نفسها التي أصبحت هي أيضا من العمليات التي تخضع لمنطق البلاغة الانضباطية المسيطر؟ ولماذا هناك نوع من التلازم المنطقي ألبرهاني بين المقدمات/المسلمات الأولى المتعلقة بوجود تصاعد ملحوظ في ألازمة القيّمية التي تمأسس مجمل مفاصل الحياة السياسية والتشريعية والقانونية والأخلاقية والاجتماعية والدينية والروحية، وبين النتيجة الصادقة بالضرورة -وغير المجدية على مستوى الواقع الاجتماعي- والتي تؤكد على أهمية الالتزام بالنسق الحِجاجي ألبرهاني الأرسطي؟ هل هناك توافق/واتفاق غير قصدي بين جميع المؤسسات الأكاديمية وبين اغلب المختصون والباحثون بالضرورة، على الحفاظ على الهرم الأرسطي/والأفلاطوني في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إلى اعتماد أدوات بحث منهجية ومفاهيمية جديدة ومغايرة تماما؟
وإذا كان هناك ثمة تماثل كبير بين البنية الشمولية لكل من: الأنظمة الهتلرية والستالينية التي حكمت أوروبا في القرن التاسع عشر وبين الأنظمة الاستبدادية التي تحكم اغلب بلداننا العربية مع الاختلاف الموجود بين السياق العربي والغربي؟ فلماذا انشغلت النخب الأوروبية من فلاسفة ومفكرين ومثقفين ومختصين وباحثين من أمثال الفلاسفة اويغن دوبريل وحنا ارندت وكارل بوبر ورايموند آرون وغيرهم الكثير ممن انهمك في تأسيس ورش عمل مشتركة لغرض نقد وتفكيك منطق الحجاج ألبرهاني الافلاطوني/الأرسطي ألقسري والذي نجم عنه صعود الأنظمة الشمولية إلى سدة الحكم؟ ناهيك عن تأسيس مدرسة بروكسل البلجيكية ومدرسة فرانكفورت بهدف نقد وتفكيك البنية المنطقية واللغوية والبلاغية الانضباطية/الأفلاطونية التي شكلت لمفهوم الهوية الجوهرية الثابتة، والعمل على تفعيل مفهوم التواصل الحِجاجي البلاغي الذي يشكل مقدمة ضرورية في بناء حالة التوافق والتسوية بين الأطراف والفئات الاجتماعية المتنافسة والمتصارعة؟
أليست الصراعات المتكاثرة بين الهويات والاثنيات المختلفة والمتعددة في سياقنا الثقافي العربي تدعونا إلى استلهام روح الفلسفات السوسيولوجية التعددية التي لم تظهر في أوروبا بعد أزمات الحروب المتكررة إلا لغرض التحرر من طغيان الهوية الأحادية على الهويات الأخرى. وهذا ما حصل في بلجيكا حيث كان للطائفة الكاثوليكية التي تشكل الأغلبية السلطة والقوة المتنفذة على الطوائف/الفئات الاجتماعية الأخرى، والتي دعت الفيلسوف البلجيكي دوبريل E. Dupréel (1879-1967) إلى كتابة مؤلفه “التعددية السوسيولوجية” وإصداره بعد يوم واحد فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية 1945؟ ألا يدعونا هذا إلى مساءلة حالة التقاعس الواضحة من المثقفين والأكاديميين التي تمنعهم عن أداء دورهم ألتفلسفي الحِجاجي النقدي؟ في الوقت الذي ينشطون فيه لتصعيد خطاب البلاغة الانضباطية القسرية الذي يعتبر الترسانة الأيديولوجية لكل نظام شمولي حاضر ومقبل وممكن في القوة؟
في الوقت الذي نجد فيه أن الفيلسوف بيرلمان وقف بالضد من منطق الحِجاج ألبرهاني ألقسري الذي كان من البديهي أن يشكل قاعدة علمية أساسية للتبرير لبنية النظام الشمولي الذي يعتبر «شكلاً من أشكال الأحادية الذي يجعل من زعيم الدولة المصدر الوحيد الضامن لشرعية الحقيقة وجميع القيّم، وتتلازم معه بالضرورة شروط قمع الحريات وازدراء تام لحقوق الإنسان، إضافة إلى اضطهاد كل الفئات الاجتماعية التي تسعى نحو تحقيق وجود مستقل عن إرادة الزعيم/الدولة. حيث ينبغي أن تكون جميع الطموحات والتطلعات الإنسانية سواء كانت قومية أم دينية؛ علمية أم فنية واقتصادية أم رياضية في خدمة إرادة الدولة المركزية وما عداها يستحيل أن يكون موضع ترحيب بل ولا يستحق الدعم أو التشجيع. بعبارة أخرى، ستتحول جميعها إلى أدوات خاضعة لمبدأ قيّمي أحادي جوهري يشتغل في خدمة معيار المعايير الأوحد والمطلق في تسيير جميع أمور الدولة الشمولية. ويجري تحديد وتشريع آلية تطبيق وتنفيذ هذا المعيار من قبل النخبة الحاكمة ووكلائها في السلطة الذين يتفرعون منها. من هنا، يمكن القول أن النزعة الأحادية في تشكيل القيّم تمثل المرتكز الأساسي في عملية دعم وتثبيت الترسانة الأيديولوجية للسلطة المركزية في الدولة الشمولية»21.
–البلاغة الجديدة وتقويض طوبولوجيا المعرفة البرهانية
هكذا، سعى خطاب الفلسفة والعلوم الإنسانية إلى التحرر من سيطرة المنطق الافلاطوني المتمركز حول آليات ضبط ومراقبة النفس/والحِجاج ألبرهاني الأرسطي واللغة الشكلانية التي كان لها أثرا كبيرا في إنتاج/وإعادة إنتاج تشكيلات جديدة من النزعة الأحادية المثالية المتجذرة في البنية المنطقية واللغوية واللسانية الغربية والتي جرى استغلالها لصالح تشييد منظومات قيّمية وَلاَّدة لأنظمة الحكم الشمولية/التوتاليتارية. فكانت نشأة خطاب مدرسة بروكسل البلجيكية في نهاية القرن التاسع عشر، رد فعل واضح ضد ذلك الخطاب الأحادي الدوغمائي الصارم، ومحاولة للتحرر من البرادايم الديكارتي المسيطر سيطرة تامة على مفاصل الفكر والعلم والفلسفة والحياة الاجتماعية أيضا، والذي كان تتمة لسلسلة طويلة من مراحل تاريخ العداء للبلاغة والحِجاج والقضايا الجدلية السفسطائية التي وعلى الرغم من أن أرسطو قد جاء على ذكرها في كتابه «الطوبيقا» إلا أن علماء المنطق عمدوا إلى طمسها بطريقة حاولوا فيها تغييب منطق الحِجاج البلاغي السفسطائي، والاستمرار في منطق العداء للحِجاج البلاغي السفسطائي واجتناب فتح باب الجدل والحوار والنقاش من اجل عدم فسح المجال للإنسان العادي للمساهمة في ابتكار القيّم وتعطيل قدراته الإبداعية. وقد نجحوا في تحقيق أكثر مما كان يحلم به أفلاطون نفسه، عندما استطاعوا تحويل الحقائق البديهية/الواضحة في ذاتها والمطلقة إلى قواعد ضمنية ومتداخلة في منظومة الخطاب وتتحكم في الاستعمالات اللغوية اليومية، حتى أصبحت ممارسات لاشعورية يقوم بها الفرد ويؤيدها حين الضرورة تأييدا أعمى دون وعي أو إدراك منه.
من هنا، ركزت مدرسة بروكسل مجهودها العلمي نحو تأسيس ورش عمل مشتركة تعمل على تحليل مختلف الخطابات الثقافية في الحياة الاجتماعية بالاعتماد على المنهج الحِجاجي البلاغي/التداولي. وقد اتضحت ملامح عملها الراديكالي في المقام الأول من خلال تحررها من النزعة الأكاديمية المنغلقة داخل أسوار الاختصاص المحدد، وخروجها إلى فضاء تعددية وتفاعل بين الاختصاصات المعرفية المختلفة. وهذا كان من بين أهم الخصائص المميزة لمدرسة بروكسل، حيث كان جيل المؤسسين الأوائل من المختصين في القانون والفلسفة والسوسيولوجيا والعلوم الإنسانية. وكان من أبرزهم الفيلسوف والعالم السوسيولوجي دوبريل وتلميذه الفيلسوف بيرلمان اللذان يعتبران من المجددين للخطاب السفسطائي ومعهما حصل منعرجا حِجاجياً مهما للغاية. دشنه دوبريل في كتبه التي تعتبر من كلاسيكيات الأدب السفسطائي وفلسفتها (الحكاية السقراطية ومصادر افلاطون) والصادر في عام 1922؛ والثاني (السوفسطائيون) والصادر في عام 1948. واكتمل مع تلميذه شاييم بيرلمان مؤسس نظرية البلاغة الجديدة.
أنطلق الفيلسوف بيرلمان في تشييد فلسفة الحِجاج البلاغي من نقد السفسطائية للمنطق ألبرهاني الرياضي/ونزعة ضبط ومراقبة النفس، وخصوصا النقد الذي وجهه الخطاب السفسطائي لمختلف أشكال الحقائق/النماذج اللغوية المتضمنة عليها مواضع المعرفة والاعتقاد الأرثوذكسية والعادات والتقاليد والعرف أيضا. واتجه في مجمل أبحاثه سواء المفردة أو المشتركة مع زميلته السوسيولوجية لوسي اولبريخت-تيتكا إلى إعادة اللحمة بين الفلسفة والبلاغة وتفعيل منطق الحِجاج البلاغي الاقناعي الذي يستند إلى بلاغة المخاطَب السفسطائية. معلنا في مقدمة كتابهم الشهير والموسوم (رسالة في الحِجاج…البلاغة الجديدة) والذي صدر بطبعته الأولى في عام 1958، أنه مع هذا الكتاب جرى التأسيس لقطيعة مع مفاهيم العقل والحدس والتأمل المنحدر ة جميعها من ديكارت وتعود في أصولها إلى أفلاطون. وقد عمل في اغلب كتاباته على معالجة وتحليل ونقد النصوص الفلسفية بهدف تفكيك «البنية المنطقية التراتبية التصنيفية الأفلاطونية» والذي قام بتشكيلها الفلاسفة بل وتفعيلها أيضا من خلال نظامهم الفلسفي المنطقي وأسلوبياتهم اللغوية ليتحول إلى “عُرف لغوي قبلي” ترسخ في التركيبة الذهنية والإدراكية للذات الإنسانية. وبذلك، تحولت هذه الثنائيات الهرمية الفلسفية إلى معطيات واضحة في ذاتها/بديهيات غير قابلة للنقاش، والى أدوات تسمح بإكساب الخطاب بنية تبدو وكأنها موضوعية دون أن تكون كذلك بالضرورة. لدرجة ما أن «يبدأ فيها الفرد بالكلام، حتى يكون افتراض وجود المعنى حاضر مسبقا وعلى الدوام، فلا يتصور الفرد نفسه قادرا على الكلام دون حضور ذلك الافتراض»22.
نتيجة لذلك، سعى بيرلمان إلى مساءلة وتحليل تلك البنية المنطقية/الفلسفية المسيطرة على إنتاج السياقات الثقافية برمتها. بعبارة أخرى، حاول تفكيك بنية العُرف اللغوي القبلي الذي عمل على عزل الفرد وسجنه بين قضبان “الضرورات المنطقية” من اتساق المفاهيم ووحدة المعنى بمعزل عن الوقائع الحقيقية الحاصلة في سياق الاستعمالات اللغوية اليومية. وذلك يعود في احد أهم أسبابه، إلى أن اللغة الشكلانية هي لغة فقيرة ولا يتوجه خطابها إلى مخاطب مادي ملموس بقدر ما يزعم أنه خطاب إلى الجميع وينطبق على الجميع سواء كان ذلك بحجة المبادئ الديكارتية الواضحة في ذاتها أو أسبقية وجود الحقائق الأفلاطونية المطلقة والتي تؤكد في مجملها أن المعنى المنطقي في اللغة يحمل صدقه في ذاته وصلاحيته التي تقع خارج منطق السؤال أو النقاش.
وفقا للمعطيات السابقة الذكر، كيف يمكن أن نؤسس لمجتمع تاريخي/تعددي يقوم على أساس التوافق بين الفئات الاجتماعية المختلفة وعقد اتفاق تشريعي عام تضمن فيه حقوق الأفراد وعدم قمع الحريات للتحرر وبشكل تام من جمهورية الشموليات الأفلاطونية؟ وكيف يمكننا إعادة الاعتبار إلى المخاطَب/الإنسان العامي في ظل هيمنة الخطابات الشكلانية التي لا تعترف بالآخر ولا تمنح أي أهمية للمتلقي بل ولا تعترف بقدرته الإبداعية على ابتكار القيّم والمساهمة في إنتاجها بوصفه عضوا من أعضاء المجتمع؟ وكيف يمكننا أن نحدث تحولا على مستوى الخطابات الثقافية يقابله وبشكل متواز تحولا واسعا في المنظومة القيّمية يشمل مختلف الممارسات الأخلاقية والاجتماعية ليلحقه تطور دلالي وذهني في الذات الإنسانية. دون أن يعقب ذلك بالضرورة تحليلاً حجاجياً بلاغياً لبنية المنطق الافلاطو-أرسطي ألبرهاني والذي نجم عنه آثارا وخيمة على المستوى الذهني والإدراكي والجسدي؟ بل وكيف يمكن للأنظمة الديمقراطية أن تتأسس على أنقاض منطق الحِجاج ألبرهاني الشمولي الذي يقصي المخاطب ويستعمل أداة القسر بل والعنف في أحيان كثيرة؟ وكيف يمكن الحديث عن وجود مؤسسات تربوية وتعليمية وأكاديمية وتشريعية وقانونية مستقلة في ظل هيمنة منطق ضبط ومراقبة النفس الافلاطوني؟ وكيف يمكن أن نؤسس لدرس حِجاجي يشكل مقدمة لأجيال من الشباب المتفلسف ولانتلجنسيا تحمل مشروعا تنويريا حقيقيا وتشكل رادعا لكل هيمنة نخبوية أيديولوجية مقبلة؟
كل هذه الأسئلة الإشكالية وغيرها، شغلت بيرلمان وجعلته يكرس حياته بأكملها نحو البحث والدراسة والتنقيب في حقل البلاغة والفلسفة. وتدشينه بعد ذلك لفلسفة حِجاجية ثقافية نقدية وضع أسسها ومبادئها في كتابه (رسالة في الحِجاج). مؤكدا على أهمية «نظرية الحِجاج بوصفها خطاب فلسفة البلاغة الجديدة (أو الجدل الجديد) التي تشمل كل حقل من حقول الخطاب الذي يسعى إلى التثبت باليقين العقلاني والمنطقي convaincre أو الإقناع persuader، اياً كان نوع الجمهور/المتلقي الموجه إليه الخطاب، واياً كان محتوى أو موضوع ذلك الخطاب. وكذلك على ضرورة أن تكتمل الدراسة العامة للحِجاج بعلوم مناهج مخصصة لكل شكل من أشكال الجمهور/المتلقي/المخاطَب ولكل فرع من فروع المعرفة. بهذه الطريقة فقط، يمكننا استحداث منطق تشريعي جديد أو منطق فلسفي جديد أيضا، والتي من شأنها أن تؤسس لتطبيقات استثنائية وفريدة من نوعها لنظرية البلاغة الجديدة في كل من: علم القانون والفلسفة»23. وحينما انهمك بيرلمان في التشريع لـ «فلسفة حِجاجية ثقافية نقدية» تقوم على التعددية المنهجية أي تفيد من جميع مناهج العلوم الإنسانية والقانون والفلسفة من اجل تحليل جميع أشكال الخطابات السياسية والإعلامية والقانونية والفلسفية والأدبية أيضا. إنما كان يريد بذلك إعادة الاعتبار وعلى حد سواء للمخاطَب وللثقافة الشعبية التي لطالما جرى ممارسة عملية إقصاء لمجمل ما تنطوي عليه من تواريخ الاعتقادات والرأي العام والعادات والتقاليد الموروثة التي تمثل في مجملها تاريخ الحس المشترك الذي يشكل قدرات الفرد الذهنية والإدراكية والسلوكية ورؤيته للعالم بأكمله. لذلك، ينبغي علينا أن نعترف بضرورة اختبار وفحص الاعتقادات ذات الأصول الفلسفية الراسخة تلك التي تشكل لدينا معها حالة من المألوفية والتآلف إلى الحد الذي أصبحت تقع فيه مجمل تلك الاعتقادات والتصورات خارج منطق المساءلة والفحص والاختبار.
وهذا ما جعل بيرلمان يبدأ من النظام التربوي والتعليمي ويؤكد على ضرورة تفعيل دور البلاغة والحِجاج في المؤسسات التعليمية وتحويلهما إلى ممارسة ثقافية تؤسس لكل تحول قيّمي يشمل جميع الأصعدة في الواقع الاجتماعي. مشيراً في الوقت نفسه إلى انه رغم أهمية دور المختصين في علوم الفلسفة والمنطق واللغة والعلوم الإنسانية أيضا في تلك العملية، غير انه من الملاحظ وجود حالة من العزوف بين أولئك المختصون لا سيما الفلسفة والمنطق عن الاقتراب إلى حقل “البلاغة” والنظر إليها في كثير من الأحيان بعين الازدراء لكونها لا يمكن أن تمثل علما يحمل امتيازا بما يكفي ليجعله مركز اهتمام الفلاسفة وعلماء المنطق فهي مجرد لغو فارغ لا جدوى منه، وحتى طرق تدريس البلاغة التقليدية في مؤسساتنا التعليمية والمعتمدة فيها لعدة قرون، جرى إهمالها إلى الحد الذي لم يبقَ منها غير العنوان الشكلي”للبلاغة” حيث يتم تدريس نصوص علماء البلاغة وكيفية كتابة مقال وصفي عنها.
والغريب في الأمر أن هذا الوصف الذي قدمه بيرلمان لحال تدريس البلاغة في الستينات من القرن الماضي، ما زال ينطبق تماما على مؤسساتنا التعليمية ومناهجها في البلاغة. وهنا، ألا ينبغي علينا أن نتساءل حول ظاهرة ركود فلسفة البلاغة وتعطيل التقنيات الحِجاجية الثقافية إلى وقتنا الحالي؟ ولماذا نجد أن هناك ثمة حالة من الانفصال بين علوم الفلسفة والبلاغة وبقية العلوم الإنسانية وهذا ما يبدو واضحا في إشكالية الدرس الفلسفي عندنا؟ إلى الدرجة التي لا يمكننا أن نعثر وإلى يومنا هذا، على منهج مخصص لتدريس فلسفة البلاغة الجديدة والحِجاج السفسطائي واعتماده مع الدرس المنطقي في أقسام الفلسفة عامة؟
لم يجد بيرلمان سبباً كافياً يمكن له أن يبرر حالة الإهمال والازدراء الذي تتعرض له البلاغة سواء في المؤسسات التربوية والتعليمية أو من قبل المختصين في الفلسفة والعلوم الإنسانية. بل رأى أنها حالة تعبر عن الجهل وعدم الفهم. رغم أن التقليد الكلاسيكي المنحدر عن الفيلسوف أرسطو كان واضحا في تعريف البلاغة بكونها فن التحدث بطريقة اقناعية مستندة على التقنيات الخطابية التي تكشف عن العلاقات الضمنية الموجودة بين القضايا المطروحة للنقاش والتأييد الذي من الممكن أن تثيره أو تضعفه لدى المخاطَب حالما تتغير الطريقة والكيفية التي يعتمدها المتكلم في طرح تلك القضايا. وهذا هو المرتكز الأساسي الذي يعزز من أهمية وضرورة تفعيل المنطق الحِجاجي البلاغي الذي يقوم على مساءلة المألوف اليومي وماهو متوافق عليه من العادات والتقاليد والأحكام الأخلاقية المسبقة أي كل ما يتعلق بثقافة الحس المشترك ونبش ما دُفن فيها من حقائق فلسفية نائمة ومتناثرة هنا وهناك بين طيات الذاكرة الإنسانية، يمكن لأي منها أن تُبعث من جديد في أي عبارة أو قول أو حتى في كلمة جميعها تمثل في آخر المطاف لأحكام قيّمية قبلية. لذلك، يدعونا منطق الحِجاج البلاغي إلى عدم الانغلاق داخل صفحات تاريخ الفلسفة التقليدي/تاريخ البحث عن الحقيقة الأفلاطونية المطلقة. والى عدم الاكتفاء بتكرار تاريخ التيارات الفلسفية ومذاهبها ومدارسها، إضافة إلى التعداد الدوري لأسماء الفلاسفة والمفكرين وتصنيفهم وفق اتجاهات فلسفية بعينها إلى الحد الذي يثير فيه الضجر والملل في كثير من الأحيان.
وإنما ينبغي في المقام الأول العمل على تحويل الدرس الفلسفي التقليدي إلى درس حِجاجي تفلسفي يتأسس على ممارسة تواصلية ثقافية تقوم على تقنيات الجدل والحوار والنقاش الحجاجية الاقناعية المتبادلة الأدوار بين المتكلم والمخاطَب دون أن تكون هناك ثمة تراتبية هرمية من أي نوع كان قد تحول دون تبادل هذا الأدوار بين الأستاذ والتلميذ، فالجميع متساو في حضرة التعلم والمعرفة والنقد والتحليل، وذلك من اجل أن تؤسس لبناء فرد قادر على نقد الخطاب الذي يسمح بالضرورة بتشكيل سلسلة من التمثلات الذهنية والإدراكية الجديدة لدى كل من الأستاذ والتلميذ تلحقها وبصورة متوازية عملية إنتاج مجموعة من الأحكام القيّمية الجديدة التي تؤثر وبشكل مباشر على صيرورة السلوك الفردي. وهذه هي احدّ أهم وظائف الدرس الحِجاجي البلاغي ألتفلسفي الراديكالي والمستندة على الاختبار والبحث الحرّ libre examin. هذا الشكل من أشكال التواصل هو ما نحج في تأسيسه بيرلمان وتفعيله في جامعة بروكسل الحرة، واعتبره احد أهم الأسس الضرورية في بناء مجتمع منظم تنظيما مؤسساتيا بالشكل الذي يتلاءم ومطالب الأفراد والتحولات الحاصلة في الواقع الاجتماعي. حيث يصبح هدف هذه المؤسسات المدنية سواء كانت السياسية منها أو التشريعية أو التعليمية هو التعزيز من ذلك الشكل التواصلي الحِجاجي الاقناعي بين الأفراد والذي يمهد بالضرورة لكل تحول ثقافي يشمل جميع الأصعدة في المجتمع الواحد.
لكن مثل هكذا تحول ثقافي من غير الممكن له التحقق في ظل سيطرة منطق الحِجاج ألبرهاني الصوُّري الشكلاني الأرسطي على الخطاب الفلسفي/والثقافي، لكونه منطق يعمل على تعزيز/وترسيخ بنية البلاغة الانضباطية الأفلاطونية التي لا تعترف بوجود/وقيمة المخاطَب من الأصل. بعبارة أخرى، سوف لن ينظر أستاذ الفلسفة إلى قاعة الدرس بوصفها وسط اجتماعي يلتقي فيه عدد من الطلاب/أي مجموعة من القيّم المشتركة بوصفها بنية من العلاقات المفاهيمية التي تمأسس مجمل السياقات التاريخية والثقافية عامة. وعليه تحتاج من أستاذ الفلسفة إلى تحليل هذه العلاقات ونقد بنيتها المنطقية واللغوية. بل على العكس من ذلك، ستكون الرؤية الأحادية مسيطرة تماما على أستاذ الفلسفة، ولا تفسح له مجالا للنظر إلى ماهو ابعد عن حدود المسلمات القبلية الصادقة وغير النافدة الصلاحية والتي تتأسس عليها جميع الأنظمة الفلسفية الكلية/الشمولية. ومن ثمة، سيكون الدرس الفلسفي تقليدي ومحكوم بآليات المنطق التراتبي الهرمي التي تتحكم أيضا في طريقة انتقاء مناهج فلسفية تقليدية؛ وفي الأسلوب اللغوي المستعمل في طرق تدريس وكتابة ونشر النص الفلسفي أيضا.
والنتيجة الطبيعية لمثل هكذا درس فلسفي تقليدي، بقاء الطالب في حالة من الاستسلام وعدم الفاعلية والاتكال المطلق لمجمل المعلومات التلقينية التي يمليها عليه أستاذ الفلسفة وأهمها أن يسعى الطالب على الدوام إلى التحرر من الخيال والمشاعر والأهواء التي يشوبها اللبس والغموض والالتباس التي تحول بينه وبين الوصول إلى مقام الصفاء والتجريد المطلق الذي يستطيع من خلاله فقط من استيعاب المفهوم الفلسفي المحض. علينا أن لا نستغرب بعد ذلك إذن من عدم وجود حوار فلسفي قائم على منطق الحِجاج البلاغي المنفتح على تعددية القراءات/وتعددية القيّم، ومن اتساع الفجوة بين كل من: أستاذ الفلسفة والمعلومة الفلسفية؛ وبين الأستاذ والطالب والسياق الثقافي العام؛ وبين قاعة الدرس الفلسفي التقليدي والواقع الاجتماعي اليومي. لان أستاذ الفلسفة نفسه تحول إلى مجرد “تمثل” للنظام الاجتماعي وقيّم الأخلاق النخبوي الإيديولوجي المسيطر والمتحكم بجميع مفاصل الحياة الإنسانية. فهو لسان هذا النظام وأذنه التي ترفض الإصغاء والحوار والنقاش في قضايا جرى/ويجري التسليم قبليا بصدقها الأبدي والسعي الحثيث على دفع الطالب/المخاطَب نحو التصديق على شرعية صلاحيتها يوميا عبر مختلف الممارسات الاجتماعية السائدة.
بَيَان من اجل خطاب فلسفي نقدي حرّ:-
اولاً– من اجل تطوير تدريس الفلسفة في جامعاتنا العراقية، يجب إقرار مادة «الحِجاج البلاغي» كمنهج أساسي ضمن مفردات مناهج قسم الفلسفة، واللحاق بركب المؤسسات الأكاديمية الأخرى، ولا نقصد بها الجامعات الغربية، بل الجامعات العربية التي سبقتنا في تدريس الحِجاج الفلسفي منذ فترة طويلة.
ثانياً– ينبغي أن يتم تدريس منطق «الحِجاج البلاغي» منذ المراحل الدراسية الأولى لطلاب البكالوريوس، اضافة الى تدريسها الى طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه). كما هو الحال في الجامعات العربية التي قامت بتعميم هذا المنهج منذ عقود من الزمن. خصوصاً، وأنه لم يعد لظاهرة غياب منهج الحِجاج البلاغي عن مفردات التدريس في أقسام الفلسفة، من حُجَّة تتذرع بعدم وجود كتاب مستقل يمكن الاستناد عليه في تدريس هذا المنهج. وذلك بعد صدور كتابنا (فلسفة الحِجاج البلاغي) الذي اصبح منهجاً معتمداً في معظم الجامعات العربية والمختبرات والفرق العلمية، ودخل في مكتباتها ليكون متاحاً لجميع الطلبة والباحثين والمختصين والأكاديميين في مختلف التخصصات. فمن غير المقبول، بعد الآن، أن يكون العراق هو صاحب الريادة في هذه الترجمة الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وأن يتأخر عن إقرار مادة الحِجاج ومنطقه الاستدلالي صمن مفردات مناهج أقسام الفلسفة في الجامعات العراقية كافة.
ثالثاً– من اجل تحقيق الأهداف المنشودة من رواد الفلسفة العراقية في بناء تفلسف حرّ، يمكن له أن ينشئ جيلاً واعياً منفتحاً على الحوار والنقاش دون خوف او تردد، يجب أن يتم الأعتراف بأهمية وضرورة منطق الحِجاج البلاغي في تطوير الدرس الفلسفي، إذا ما كانت هناك إرادة حقيقية وجادة في رفض العنف وآليات القسر والقهر وجميع أشكال التسلط والقمع والاستبداد. إن معاصرة أقسام الفلسفة لمنهج الدراسات الحِجاجية والبحث في نظرياته الجديدة، هو خطوة أساسية لبناء خطاب فلسفي عملي جديد يتداخل مع عملية تشكيل الرأي العام والتأثير في الجمهور الذي يمكن أن يكون لخطابها عليه مفعولاً مؤثراً وبالطريقة التي تعمل على تكوين وعي فلسفي نقدي يقبل بالتعددية ويرفض الانغلاق، يؤيد حرية تبادل الرأي ويرفض التسليم والخضوع والأذعان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش:-
(1) د. حسام محي الدين الآلوسي: العقلانية ومستقبلها في العالم العربي، دار القدس للنشر والتوزيع-الأردن، ط1، 2011، ص5.
(2) المصدر نفسه، ص295.
(3) مدني صالح: مقالات في الدرس الفلسفي…تعلموا كيف تُقرأ كي تتعلموا كيف تُفهم وكيف تُدرَّس، جمعه وأعده وقدم له د. محمد فاضل عباس، ابن النديم للنشر والتوزيع-الجزائر، دار الروافد الثقافية-ناشرون-لبنان، ط1، 2016، ص25.
(4) د. عبد الستار الراوي: قطر الندى…أيام الفلسفة في الوزيرية (1963-1967)، ط2، 2008، ص45.
(5) د. حسن مجيد العبيدي: من الآخر إلى الذات…دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، والفكر الفلسفي العربي المعاصر، دار الطليعة للطباعة والنشر-بيروت، ط1، 2008، ص ص. 171-172.
(6) د. ياسين خليل: الأعمال الفلسفية الكاملة…المنطق وفلسفة العلوم في التراث العربي الأسلامي-الجزء الأول، إعداد وتقديم د. مشهد العلاف، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، 2014، ص256.
(7) المصدر نفسه، ص ص. 272-273.
(8) المصدر نفسه، ص273.
(9) د. حسن مجيد العبيدي، المصدر السابق ص ص. 174-175.
(10) المصدر نفسه، ص ص. 172-173.
(11) مدني صالح، المصدر السابق، ص ص. 25-26-27.
(12) د. ياسين خليل، المصدر السابق، ص ص. 270-271.
(13) شاييم بيرلمان: فلسفة البلاغة الجديدة، ترجمة: أنوار طاهر، مراجعة وتقديم: د. أبو بكر العزاوي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد-الأردن، ط1، 2020، ص 119.
(14) د. حسن مجيد العبيدي، المصدر السابق، ص 176.
(15) يُنظر: شاييم بيرلمان: فلسفة الحِجاج البلاغي، ترجمة: أنوار طاهر، مراجعة وتقديم: د. أبو بكر العزاوي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد-الأردن، ط1، 2019، ص13.
(16) المصدر نفسه، ص117.
(17) يُنظر: أنوار طاهر، في تأويل بلاغة التعليم…من الكهف الإفلاطوني الى الحِجاج السفسطائي، مجلة علامات المغربية، العدد 46، 2016، ص ص. 135-150.
(18) Michel Meyer : Logique, langage et argumentation, Hachette, Paris, 1982, p. 115.
(19) Barbara Cassin : La Sophistique, un article paru dans Sciences de L’information et de la Communication (sous la direction de Daniel Bougnoux), Larousse, 1993, p. 29.
(20) Barbara Cassin (sous la direction de), Vocabulaire Européen Des Philosophies, éditions du Seuil/ Dictionnaires Le Robert, France, 2004, p. 902.
(21) يُنظر: شاييم بيرلمان: فلسفة الحِجاج البلاغي، ص31.
(22) Gilles Deleuze : Logique Du Sens, Les Éditions De Minuit, Paris, 1969, p. 41.
(23) يُنظر: شاييم بيرلمان: فلسفة الحِجاج البلاغي، ص89.
المصادر العربية:-
-أنوار طاهر، في تأويل بلاغة التعليم…من الكهف الإفلاطوني الى الحِجاج السفسطائي، مجلة علامات المغربية، العدد 46، 2016
-حسام محي الدين الآلوسي: العقلانية ومستقبلها في العالم العربي، دار القدس للنشر والتوزيع-الأردن، ط1، 2011.
-حسن مجيد العبيدي: من الآخر إلى الذات…دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، والفكر الفلسفي العربي المعاصر، دار الطليعة للطباعة والنشر-بيروت، ط1، 2008.
– شاييم بيرلمان: فلسفة البلاغة الجديدة، ترجمة: أنوار طاهر، مراجعة وتقديم: د. أبو بكر العزاوي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد-الأردن، ط1، 2020.
-شاييم بيرلمان: فلسفة الحِجاج البلاغي، ترجمة: أنوار طاهر، مراجعة وتقديم الدكتور أبو بكر العزاوي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد-الأردن، ط1، 2019.
-عبد الستار الراوي: قطر الندى…أيام الفلسفة في الوزيرية (1963-1967)، ط2، 2008.
-مدني صالح: مقالات في الدرس الفلسفي…تعلموا كيف تُقرأ كي تتعلموا كيف تُفهم وكيف تُدرَّس، جمعه وأعده وقدم له د. محمد فاضل عباس، ابن النديم للنشر والتوزيع-الجزائر، دار الروافد الثقافية-ناشرون-لبنان، ط1.
-ياسين خليل: الأعمال الفلسفية الكاملة…المنطق وفلسفة العلوم في التراث العربي الأسلامي-الجزء الأول، إعداد وتقديم د. مشهد العلاف، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، 2014.
المصادر الاجنبية:-
-Barbara Cassin (sous la direction de), Vocabulaire Européen Des Philosophies, éditions du Seuil/ Dictionnaires Le Robert, France, 2004.
-Barbara Cassin : La Sophistique, un article paru dans Sciences de L’information et de la Communication (sous la direction de Daniel Bougnoux), Larousse, 1993.
-Gilles Deleuze : Logique Du Sens, Les Éditions De Minuit, Paris, 1969.
-Michel Meyer : Logique, langage et argumentation, Hachette, Paris, 1982.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمكن تحميل نسخة PDf من الدراسة عبر الضغط هنا




