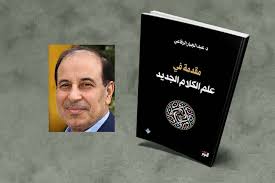الله: السؤال المستحيل وكفاءة الإجابات

الله: السؤال المستحيل وكفاءة الإجابات[1]
الوحدانية الإلهية فكرة مركزية في الإسلام، هي أم العقائد كما كان يكرر الأصوليون، وهي الفكرة التي شكلت طابعا ثورياً في ثقافات المنطقة التي بزغ الإسلام وسطها. لم تكن فكرة وحدانية الله غريبة عن تلك الثقافات ولا حتى عن عرب ماقبل الإسلام، ولكن الفهم الخاص الذي جاء به القرآن للوحدانية هو مامثل ذلك الطابع الثوري لها. من جهة هي وحدانية مطلقة لا تقبل التشبيه بأي وحدة نعرفها نحن البشر، ولكنها في الوقت نفسه وحدة تتصل اتصالا مباشراً مع العالم الطبيعي والإنساني، حيث لا وسائط من أي نوع، لا أوثان أو نجوم أو كواكب أو أشخاص أو مؤسسات دينية، وحدة خالصة على تماس مباشر مع كل كثرة الأشياء وتعدد أحداث العالم وتناقضاته.
عندما يقرر القرآن هذه الوحدانية يفتح في الوقت نفسه باب الأسئلة على مصراعيه، كيف عسانا نفهم هذه المسألة الصعبة؟ 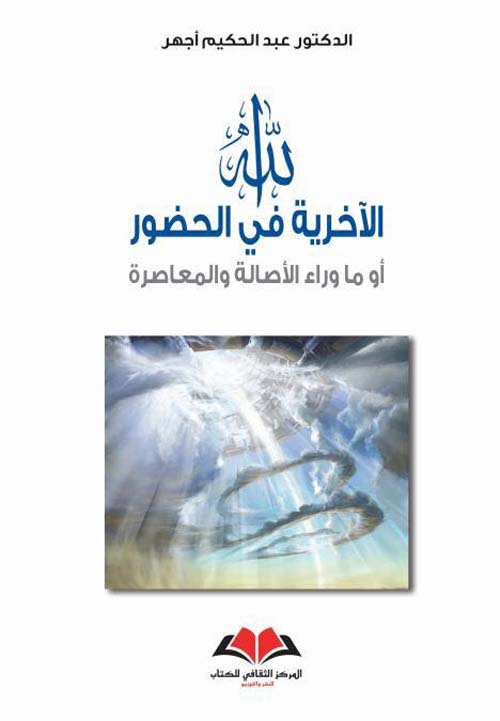 كيف نفهم هذه الوحدانية؟ هنا يستيقظ العقل والشعور على سؤال صعب أقرب إلى المستحيل، فالأمر هنا لايتعلق فقط بالجانب الكوني وعلاقة الوحدة بتعدد الموجودات، بل بأفعالنا نحن وكيفية نسبتها إلى الله أيضاً، إذ من غير الممكن فهم الوحدانية الإلهية إذا استبعدنا من هذا المفهوم كل التمثيلات والمقاربات البشرية، فوحدة الله ليست مجرد الإقرار أن لا إله غيره، بل أيضاً في أن الوحدانية الإلهية الحقيقية ليس لها أجزاء، وأنها ليست مجموعاً لكل، وأن لا شيء بها يشبهنا، وأنها ليست كلياً عقلياً، ولا تنطبق عليها المفاهيم الذهنية، وأن اللغة غالباً ما تتعثر في قول مايمكن أن يجعل من هذه الوحدانية أمراً قابلاً للإدراك. وحدانية من هذا النوع تخرج عن كل التعينات التي اعتاد ذهننا أن يقوم بها، فالحدود العقلية والمفاهيم واللغة لاتستطيع الإمساك بها، ذلك أن من طبيعة عقلنا أن يفهم الواحد كمجموع أجزاء مندرجة فيه، فالوحدة لا تُفهم دون أجزائها، وحتى المفاهيم العقلية المجردة لا معنى لها دون المفردات الواقعية التي تندرج فيها، أما الوحدة الخالصة فهي شيء يقع خارج مواضعاتنا الذهنية. الوحدة بهذا المعنى كانت موضوعاً نظرياً مركزياً للتفكير وليس فقط قضية إيمانية.
كيف نفهم هذه الوحدانية؟ هنا يستيقظ العقل والشعور على سؤال صعب أقرب إلى المستحيل، فالأمر هنا لايتعلق فقط بالجانب الكوني وعلاقة الوحدة بتعدد الموجودات، بل بأفعالنا نحن وكيفية نسبتها إلى الله أيضاً، إذ من غير الممكن فهم الوحدانية الإلهية إذا استبعدنا من هذا المفهوم كل التمثيلات والمقاربات البشرية، فوحدة الله ليست مجرد الإقرار أن لا إله غيره، بل أيضاً في أن الوحدانية الإلهية الحقيقية ليس لها أجزاء، وأنها ليست مجموعاً لكل، وأن لا شيء بها يشبهنا، وأنها ليست كلياً عقلياً، ولا تنطبق عليها المفاهيم الذهنية، وأن اللغة غالباً ما تتعثر في قول مايمكن أن يجعل من هذه الوحدانية أمراً قابلاً للإدراك. وحدانية من هذا النوع تخرج عن كل التعينات التي اعتاد ذهننا أن يقوم بها، فالحدود العقلية والمفاهيم واللغة لاتستطيع الإمساك بها، ذلك أن من طبيعة عقلنا أن يفهم الواحد كمجموع أجزاء مندرجة فيه، فالوحدة لا تُفهم دون أجزائها، وحتى المفاهيم العقلية المجردة لا معنى لها دون المفردات الواقعية التي تندرج فيها، أما الوحدة الخالصة فهي شيء يقع خارج مواضعاتنا الذهنية. الوحدة بهذا المعنى كانت موضوعاً نظرياً مركزياً للتفكير وليس فقط قضية إيمانية.
تمسك الإسلام بقوة بفكرة الارتباط المباشر بين الله والعالم الطبيعي والإنساني، وكان على الفكر النظري أن يبحث في تلك الروابط المباشرة وينفتح بالتالي على سؤال اتصال الوحدانية اللامتعنية بالعالم. كان القرآن قد قرر وجهين متلازمين لتلك الوحدانية، التنزيه التام من جهة والتشبيه التام من جهة ثانية، في الأولى يحتفظ الله بتعاليه عن الإدراك السهل، وفي الثانية ينشىء الروابط الممكنة مع أحداث العالم الفيزيائية والإنسانية. الفكرتان وردتا في القرآن بالتشديد نفسه، الله منزه عن أية مشابهة مع غيره، وفي الوقت نفسه الله يتصل بالعالم بطرق عديدة، وأكثر مايُعبّر عن ارتباط الله بالعالم هو الصفات التشبيهية (الخبرية) التي جعلت الله مشابهاً للإنسان، كالقول إن الله يضحك ويغضب ويستوي وينزل وله يد ويتحدث مع الملائكة والأنبياء …، هذه الأوصاف لا تجعل الله على صلة بالعالم فقط بل على قرب شديد منه.
هاتان الفكرتان: أولاً، التنزيه الإلهي غير القابل للإدراك والتعيين اللغوي، وثانياً، الله الذي يشابه العالم إلى حد وصفه بأوصاف إنسانية، صارتا معاً مندرجتين تحت مسمى واحد هو الله. وهاتان الفكرتان هما ماعُرفتا بالتنزيه والتشبيه، وصارت وحدة الله تعني وحدة التعين واللاتعين، وحدة التجريد الخالص وقابلية الوصف معاً. هذه الوحدة ليست وحدة شيئين، بل هي وحدة الله بوصفه منزهاً ومشبهاً في الوقت عينه.
كان جهد مفكري الإسلام يتحرك في المنطقة الوسطى بين المفهومين، فالتنزيه الخالص أمر أساسي، ولكن الاقتصار في فهم الله على التنزيه فقط يجعل الله مُعطلاً وبعيداً عن العالم ومقطوع الصلة به، وفي المقابل فإن التوقف عند الصفات التشبيهية والاقتصار عليها يخفف من تنزيه الله ويجعله أقرب لمماثلة موجودات العالم، الأمر الذي يُفقد الله آخريته المطلقة. كان معظم المسلمين على وعي بهذه المسألة، وكانوا يمارسون نقداً مريراً على من يقتصر في فهمه لله على التنزيه فقط أو على التشبيه فقط. كانت حساسية المسلمين اتجاه هذا السؤال وإدراكهم ضرورة الجمع بين وجهي وحدة الله تجعل بعضهم يلقي هذه التهمة، تهمة التعطيل أو التشبيه على البعض الآخر.
لو نظرنا إلى هذا التاريخ وقرأنا النص التراثي بعمق وبمرجعية همومه وانشغالاته لوجدنا أن هذا النص كان يتصدى لواحدة من المشكلات النظرية الكبرى في تاريخ الثقافة الإنسانية. ذلك أن فكرتي التنزيه والتشبيه أخذتا مع الوقت صياغات نظرية تمثل أسئلة فلسفية من نوع خاص.
السؤال إذن هو، كيف يمكن لله الذي لايوصف بصفات الأشياء أن يؤسس منطقة محايثة مع العالم، كيف يمكن لله أن يكون آخراً مطلقاً، اختلافاً تاماً عن كل شيء، من جهة، وفي الوقت نفسه أن يكون على صلة مفهومة بالعالم مُصاغة بطريقة متسقة ومنطقية؟
يمكن الاعتقاد أن هذا السؤال الذي أثاره الإسلام، يقف وراء ولادة النص النظري بأشكاله المتعددة، وهو السؤال الذي شكّل حالة القلق التي لم تنته بعد والتي لن تنتهي، والتي جعلت من النص نصاً، ومن الكتابة ضرورة. هو الذي جعل أحدهم يجلس ليكتب، وجعل من أحد آخر ينتقد هذا المكتوب ليقدم اقتراحه المُعدّل أو البديل.
لو ذهبنا خطوة أخرى للأمام لصار باستطاعتنا أن نتساءل، لماذا هناك نص كلامي ونص صوفي ونص فلسفي؟ لماذا تعددت أصناف النصوص والسؤال واحد؟ هذا التعدد يفسره السؤال الآخر الذي يقول، لماذا نفترض أن الله يتصل بالعالم أو ينشىء 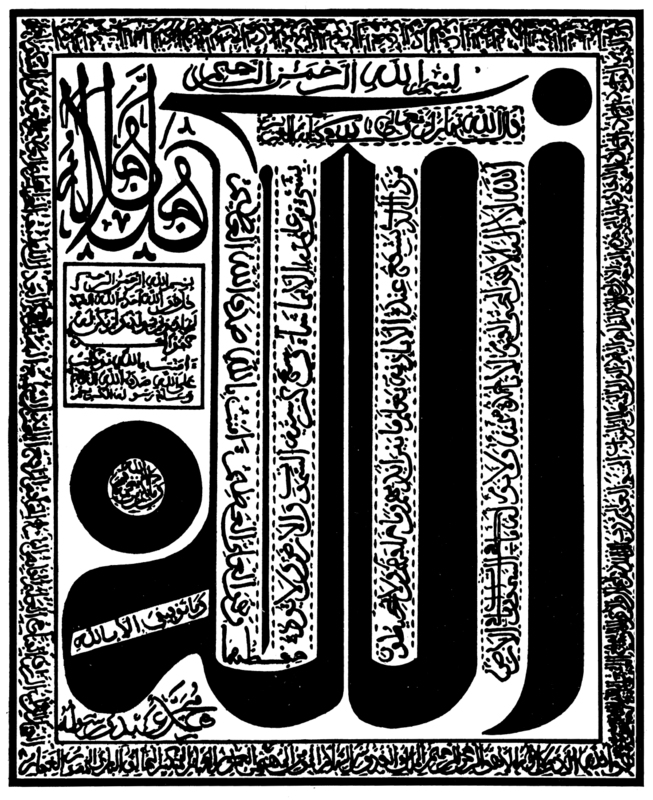 منطقة محايثة معه على هذا الشكل دون ذاك، خصوصاً أن من طبيعة التنزيه إمكانيته على الاتصال بالعالم بأشكال عديدة؟ لماذا يجب أن نفترض أن الله يحضر في العالم بفاعليته وقوته، ولانفترض أنه يحضر بذاته، أو يحضر بوجوده أو ماهيته ……؟ وعندما يختار أحدهم فرضية محددة لحضور الله في العالم كتلك التي تركز على صفات الله أو أسمائه كالقدرة والإرادة والعلم، أو تلك التي تركز على حضور الله بذاته أو بوجوده، فإن خطابه سيحدد شكل الإجابة التي سيذهب لها. ولكن الأمر لن يتوقف هنا، ذلك أن سؤالاً آخر يبرز، وهو سؤال متعلق بكيفية هذا الحضور، هل نفهم هذا الحضور على أساس الضرورة المنطقية بين الفاعلية الإلهية وبين المفعولات، أم على أساس أن الحضور الفاعل لله هو نوع من علاقة خارجية بين طرفين لا يتبادلان التأثير ولاتربطهما علاقة ضرورية، أم أن طرفا هذه العلاقة متداخلين مع بعضهما لدرجة يكون فيها أحدهما هو الآخر؟
منطقة محايثة معه على هذا الشكل دون ذاك، خصوصاً أن من طبيعة التنزيه إمكانيته على الاتصال بالعالم بأشكال عديدة؟ لماذا يجب أن نفترض أن الله يحضر في العالم بفاعليته وقوته، ولانفترض أنه يحضر بذاته، أو يحضر بوجوده أو ماهيته ……؟ وعندما يختار أحدهم فرضية محددة لحضور الله في العالم كتلك التي تركز على صفات الله أو أسمائه كالقدرة والإرادة والعلم، أو تلك التي تركز على حضور الله بذاته أو بوجوده، فإن خطابه سيحدد شكل الإجابة التي سيذهب لها. ولكن الأمر لن يتوقف هنا، ذلك أن سؤالاً آخر يبرز، وهو سؤال متعلق بكيفية هذا الحضور، هل نفهم هذا الحضور على أساس الضرورة المنطقية بين الفاعلية الإلهية وبين المفعولات، أم على أساس أن الحضور الفاعل لله هو نوع من علاقة خارجية بين طرفين لا يتبادلان التأثير ولاتربطهما علاقة ضرورية، أم أن طرفا هذه العلاقة متداخلين مع بعضهما لدرجة يكون فيها أحدهما هو الآخر؟
إذا افترضنا مثلاً أن حضور الله في العالم يجب أن يكون بواسطة قوة الله، أي صفتي (القدرة والإرادة)، فهل نفهم هذه القوة على أنها تتحكم في العالم وهي بعيدة عنه، أم نفترض أن القوة الإلهية تتوزع في الأشياء لتصبح قوى العالم هي ذاتها قوة الله، موجودة في أحداث جزئية لاحصر لها، وعندها يصبح كل حدث في الكون هو ترجمة للقوة الإلهية ذاتها؟
هذه كلها صياغات متعددة للسؤال الإسلامي الوجودي. الفلاسفة أو هؤلاء المتأثرون بالتراث اليوناني لم يعتقدوا أن حضور الله في العالم يمكن أن يكون عن طريق فاعليته (علم الكلام) أو ذاته (التصوف)، فهذا النوع من الاستحضار[2] أمر خاطئ بالنسبة لهم، لأنه يفترض تخارج الله عن ذاته أثناء اتصاله بالعالم، في الوقت الذي يجب أن يكون الله دائماً هوية مطابقة لذاتها مطلقاً.
إذن طريقة استحضار الله الذهني إلى منطقة الاتصال مع العالم هي التي جعلت النصوص تتنوع، وهو الأمر الذي سنناقشه على مراحل، وسيهتم هذا الكتاب بمناقشة خطاب القوة الذي ذهب إلى أن صلة الله بالعالم تقوم على مبدأ الفاعلية المتمثلة بصفتي القدرة والإرادة، اللتين تحددان شكل العالم ومصيره. أما خطاب الذات،[3] وخطاب الوسائط[4] فسيكون لهما مناقشة أخرى في مكان آخر.
في المراحل النظرية المتقدمة أخذت ثنائية التنزيه والتشبيه، تسميات كثيرة، فهي مثلاً تعادل عند كثيرين ثنائية الذات والصفات، إذ هناك من جهة، الذات الإلهية البعيدة عن كل تعين، آخرية مطلقة، تقع وراء كل الثنائيات والصياغات النظرية للعالم، ومن جهة أخرى هناك الصفات الإلهية التي يناط بها الاتصال بالعالم، اتصال القدرة والإرادة والعلم بالمقدورات و المرادات والمعلومات، الله في هذا الجانب المتعلق بالصفات يصبح آخرية متعينة، حيث الصفات تتصل بالعالم، وتحدد سلوك الأشياء وتصمم بنيتها، وتجعل العالم قابلاً للتفسير.
الآخرية المتعينة كانت الهم الأكبر والسؤال الأكثر وطأة بالنسبة لمفكري الإسلام، إذ كيف نحدد طريقة حضور صفات الله في العالم وكيف نجعل من هذا الحضور مُصاغاً بطريقة نظرية منسجمة ومتسقة منطقياً؟ فنحن مثلاً إذا افترضنا أن حضور لله يكون بواسطة فاعليته المتمثلة بالإرادة والقدرة، يصبح السؤال محفوفاً بمشاكل كثيرة؟ من هذه المشاكل مثلاً، كيف تتصل قدرة الله وإرادته وعلمه بالعالم، كيف نفسر العلاقة بين أزلية هذه الصفات وحدوث كل شيء آخر؟ هل كانت معلومات الله موجودة أزلاً مع العلم الإلهي قبل الخلق، هل كانت هذه الصفات فارغة من محتوياتها في الأزل، هل كان العلم الإلهي دون مضمون، أم أن العلم الإلهي كان دائماً موجوداً مع معلوماته؟ إذا قلنا بوجود المعلومات منذ الأزل مع العلم، فإن هذا يعني أن المعلومات أزلية أيضاً، فزيد الذي سيولد في يوم كذا، ويفعل بالتفصيل كذا، ويخرج من بيته في لحظة كذا، ويموت في يوم كذا، تجعل من زيد أزلياً كشيء معلوم، الأمر الذي لم يقبله كثير من المسلمين الذين يتمسكون بأزلية الله وصفاته فقط، وهذا مادفع البعض للقول إن أفضل تقرير لأزلية الله هو القول إن الصفات الإلهية حدثت في الزمان مع مضامينها. آخرون صمتوا عن الأمر وذهبوا إلى تقرير أزلية العلم والمعلومات لكن دون تقديم أي تفسير محدد.
هذه الأسئلة كانت تثير الرعدة والشجاعة في الوقت نفسه، كانت من الأسئلة التي حيرّت وقسمت المسلمين بالمعنى الإيجابي للانقسام، سيذهب البعض إلى القول إن علم الله محدث، ليس أزلياً، من أجل أن يتجنب وجود المعلومات وجوداً أزلياً، وسيذهب الكثير من المعتزلة بإنشاء فرضية “شيئية المعدوم”، التي تنص على أن معلومات الله أزلية ولكنها معدومة، وذلك من أجل إنقاذ أزلية العلم الإلهي، وإنقاذ اسم الله كعالم أزلاً.
يمثل الله نوعان من الآخرية في خطاب القوة المسمى غالباً بعلم الكلام، آخرية مطلقة تقع خارج كل التسميات والثنائيات النظرية، وآخرية متعنية تمثلها الصفات الإلهية. الآخرية المتعينة أخذت تسميات كثيرة، وكانت كل تسمية تعتقد أنها تحافظ على التنزيه الإلهي وتعطيه الاسم المناسب لبناء العالم، الأمر الذي جعل الأبنية النظرية تقوم على الثنائيات المتقابلة.
دافع كثيرون من المعتزلة عن تسميات محددة لله تناسب طريقة تفكيرهم في حضور الله في العالم، أبو علي الجبائي (ت. 303 هـ/ 915 م) مثلاً، دافع عن تسمية الله بالقديم (الأزلي) واعتقد هو وأتباعه أن هذا الاسم هو الأنسب لموقع الله المقابل لعالم كل شيء فيه مُحدث، فاسم “القديم” يعطي الله خصوصيته التي لايمكن لموجودات العالم الأخرى امتلاكها بوصفها مؤقتة في الزمان. أخذ الأشاعرة بهذا الاسم، ولكنهم وسعّوا من خصوصية الله ولم يقتصروا على اسم “القديم”، فأعطوه أسماء أخرى خاصة به، وهي كلها تسميات تقف قبالة العالم المتعدد والمُحدث في الزمان.
تحمس الغزالي (ت. 505 هـ/ 1111 م)، خلاف الجيل الأول من مدرسته، لتسمية الله بـ “واجب الوجود” مستعيراً تسمية الفارابي (ت. 339 هـ/ 950 م)، لأن العالم كله “ممكن” الوجود يستمد وجوده من الله بينما الله هو الوحيد الذي وجوده مطابق لذاته، لايحصل عليه من سبب غير ذاته. أما ابن تيمية (ت. 728 هـ/ 1328 م) فكان يفضل تحديد خصوصية الله على أنها مجموع الكمالات، لأن كل شيء في العالم ناقص ونسبي، والله على طرف مقابل تماماً.[5]
هذه التسميات هي التعينات التي تصل الله بالعالم وتنشأ بواسطتها منطقة المحايثة بين الطرفين، ولكن التنزيه يبقى آخراً مطلقاً وراء كل هذه التسميات، هذا التنزيه أخذ غالباً اسم “الذات” عند الغزالي وعند كثير من المسلمين، أو “الماهية أو المائية” عند ضرار بن عمر (ت. بين 190 و 200 هجري)، أو اللاشيء عند جهم بن صفوان (ت. 128 هـ/ 745 م)، أي الذي لا تنطبق عليه تسمية (شيء)…..
الفكر الإسلامي في نصوصه العربية الثلاثة، خطاب القوة وخطاب الذات وخطاب الوسائط، كان مشغولاً في صياغة منطقة محايثة بين الله والعالم وفي محاولة استيعاب تنزيه الله، الأمر الذي أنتج هذا العدد الكبير من الأفكار والنظريات التي لايمكن فهمها خارج هذا السؤال، والتي لا يصلح فيها دائماً تطبيق مناهج معاصرة عليها تريد تفسيرها بمنطق آخر غير ذلك الذي نشأت بسببه وانشغلت به.
الفكر الإسلامي كان تاريخياً بطبيعته، لأن إجاباته كانت تتقدم دائماً نحو صياغات أكثر اتساقاً حتى لو اتصف هذا التقدم بالبطء في مراحل كثيرة، ولكن الأمر الأكيد أن الإجابات الأولى تختلف عن الإجابات المتأخرة، لأن الإجابات المتأخرة كانت قد استثمرت النقاشات والتناقضات والصياغات التحكمية التي جاءت مبكراً وحاولت ترتيب صياغة تخفف من الانقطاعات داخل هذه الصياغات ومن منطقها التحكمي. العالم يجب فهمه في التراث على أنه ذلك المكان الذي تلتقي فيه التجربة العينية التي يعيشها البشر في العالم مع وجه من وجوه الله.
في هذا التصنيف الذي نقترحه والقائم على شكل حضور الله في العالم وشكل منطقة المحايثة التي تم تشييدها، ستتغير خطوط التصنيف القديمة، إذ لم يعد هناك علم كلام وتصوف وفلسفة بالمعنى التقليدي، إنما صار هناك خطاب قوة، وخطاب ذات وخطاب وسائط، بوصفها الخطابات الأوسع انتشاراً والتي استحضر كل منها الله بطريقة مختلفة عن الآخر. بهذه التوزيع الجديد القائم على طريقة حضور الله يصبح مثلاً الكندي (ت. 256 هـ/ 871 م) وأبو البركات البغدادي (ت. على الأرجح 560 هـ/ 1164 م) من المنتمين إلى خطاب القوة لأن فكرهم ارتكز على فاعلية الله في العالم، رغم تصنيفهم التقليدي كفلاسفة، كما سيصبح بعض المتصوفة منتمين لخطاب الوسائط لأنهم سيأخذون بفكرة الفصل بين الله والعالم وافتراض وسائط بين الاثنين.
وهذا الأمر يجعل فكرة المحددات النهائية لخطاب ما، فكرة غير دقيقة، لأن المنتمين إلى خطاب ما كانوا ينفتحون على خطابات أخرى، ويتعرفوا على مواطن الضعف في خطاباتهم ويندفعون نحو تعديل صياغات “مدارسهم”، وهذا مايمثل الحقيقة التاريخية للفكر الإسلامي بوصفه فكراً متحركاً باتجاه صياغات معدلة قد تجعلها أقل عرضة للنقد من السابق.
ربما يفسر لنا هذا الأمر لماذا كان الغزالي وفخر الدين الرازي بالكاد أشعريين، ومن النظّام ومعمر وضرار بالكاد معتزلة، ومن الكندي والبغدادي بالكاد فلاسفة بالمعنى الأرسطي. لقد وقف أبو الحسن الأشعري (ت. 324 هـ/ 937 م) الذي أسس واحدة من أكبر المدارس في الإسلام على تخوم مدارس وآراء متعددة، كالمعتزلة والكلابية والحنبلية، كما وقف الكثير من تلامذته على تخوم المعتزلة والفلسفة، مثل الجويني والغزالي والرازي. ووقف أبو هاشم الجبائي المعتزلي على تخوم مدرسته وعلى تخوم الصفاتيين كالكلابية والأشاعرة والماتريدية. ووقف الكندي وأبو البركات البغدادي بين الفلسفة وعلم الكلام، ووقف ابن تيمية على تقاطع عدة تيارات، من كلام وتصوف وفلسفة، ووقف الكثير من المتصوفة على خطوط التماس نفسها بين علم الكلام والفلسفة والتصوف. كل ذلك يجعل فكرة المدرسة التقليدية تحتاج إلى مراجعة. كانت الخطابات التي تعتمد منطقة محددة للمحايثة بين الله والعالم تتطور تاريخياً من أجل تحقيق اتساق أكبر في قولها، وأكثر قدرة على تنظيم مبدأ المحايثة الذي تعتقد به، ولكنها تكتشف فيما بعد أن الأمر مازال بعيداً عن التحقق، وأن جهداً فكرياً إضافياً صار مطلوباً لتحسين القول في الخطاب، وهكذا.
من أكبر المدارس في الإسلام على تخوم مدارس وآراء متعددة، كالمعتزلة والكلابية والحنبلية، كما وقف الكثير من تلامذته على تخوم المعتزلة والفلسفة، مثل الجويني والغزالي والرازي. ووقف أبو هاشم الجبائي المعتزلي على تخوم مدرسته وعلى تخوم الصفاتيين كالكلابية والأشاعرة والماتريدية. ووقف الكندي وأبو البركات البغدادي بين الفلسفة وعلم الكلام، ووقف ابن تيمية على تقاطع عدة تيارات، من كلام وتصوف وفلسفة، ووقف الكثير من المتصوفة على خطوط التماس نفسها بين علم الكلام والفلسفة والتصوف. كل ذلك يجعل فكرة المدرسة التقليدية تحتاج إلى مراجعة. كانت الخطابات التي تعتمد منطقة محددة للمحايثة بين الله والعالم تتطور تاريخياً من أجل تحقيق اتساق أكبر في قولها، وأكثر قدرة على تنظيم مبدأ المحايثة الذي تعتقد به، ولكنها تكتشف فيما بعد أن الأمر مازال بعيداً عن التحقق، وأن جهداً فكرياً إضافياً صار مطلوباً لتحسين القول في الخطاب، وهكذا.
الفكر الإسلامي تاريخي، لأن السؤال المطلوب البحث فيه سؤال لا يكف عن إثارة القلق وعن المطالبة بالتفكير الدائم للإجابة عنه. وهذا مايجعلنا نصل إلى نتيجة مهمة، وهي أن النزعة الإحيائية التي يمارسها الفكر العربي والإسلامي الحديث يجب مراجعتها والتشكيك بجدواها، لأنه من غير الممكن لنا أن نتوقف عند صيغة معينة أو مفكر معين ونطالب به كممثل عن التراث يضمن لنا الدخول في العصر، لن يكون ذلك ممكناً بعد أن نضع يدنا على السؤال الإسلامي الذي يحرك كل الصيغ وكل المنخرطين في البحث عن إجابات له. فطبيعة هذا السؤال تقتضي عدم التمسك بأية صيغة نظرية قد قيلت، كي لانجعل من هذه الصيغة وثناً فكرياً يريد احتكار تمثيل الله بشكل يُقصي بقية أشكال القول ويمنع من ولادة قول آخر. الاعتقاد أن صيغة ذلك المفكر أو تلك المدرسة مازالت صالحة اليوم هو ابتعاد تام عن الله بوصفه سؤالاً، بوصفه آخراً، يسلب بآخريته واختلافه كل تعيين له وللعالم، هو القبول بنسيان تنزيهه، هذا التنزيه الذي يقتضي منا بالضرورة التفكير فيه دائماً بوصفه ذلك الأفق الذي لايمكن استنفاذه.
إن ماقيل في الماضي هو دروس في التاريخ الثقافي تساعدنا على التدريب العقلي في كيفية البحث في سؤال صعب، فكل مفكر من التراث هو لحظة في هذا التاريخ دفع فكرة المحايثة التي اعتقد بها نحو صياغة أفضل.
التنزيه الإلهي مُفارِق مطلقاً ولايقبل التعيين، وهو يتيح للفكر أن ينفتح على المستحيل الذي لا نفتأ نحاول الاقتراب منه وبلوغ شيء منه، وهذا التنزيه لاينفك عن إثارة الفكر دون توقف من أجل إعادة بناء العالم مرات لاحصر لها. التنزيه هو حالة سلب لكل تعيين، لكل تسمية ولكل صياغة لغوية للعالم، هو الاختلاف الذي لايمكن إدماجه داخل العالم ولايمكن إلغاء آخريته، والذي لا يقبل تعييناً واحداً ولا استحضاراً واحداً، لكنه يبقى قابلاً لكل استحضار ولكل تعيين دون أن يكون أياً منها. ذلك أن أية صياغة قولية عن العالم هي صياغة مؤقتة، تطمح إلى ترتيب نسق ما، سرعان مايتم الاكتشاف أن آخرية الله تنبثق داخل النص وتفتحه على التغيير.
إن فهماً مُنصفاً للنص التراثي يجب أن يعتمد على مرجعية السؤال الذي جعل هذا النص ممكناً، ولن يكون من العدل أبداً مقاربة هذا النص بأحكام منهجية مسبقة ترغمه على قول مالم يكن ينوي قوله أبداً. كما أن فهم النص التراثي على أساس أسئلته يجعل من الإبداع الفكري اليوم أمراً ممكناً، ويجعل من الممكن تجاوز التقليد الفكري الذي مازلنا نعيش عليه منذ وقت مبكر. بناء العالم على أساس الآخرية المطلقة والآخرية المتعينة لله، على أساس التنزيه ومنطقة المحايثة، بوصفهما الامتداد الطبيعي والمنطقي لوجهي وحدة الله، التنزيه والتشبيه، أمر يجعل من الممكن استئناف التفكير اليوم على الخطوط الفلسفية ذاتها التي اشتغل عليها المسلمون منذ الحسن البصري وجهم بن صفوان وحتى ابن عربي وابن تيمية.
لا يمكن اليوم إحياء صيغة محددة من التراث، فكل مفكريه ومدارسه هم دروس على غاية من الأهمية في فن وطريقة الإجابة عن السؤال الوجودي الإسلامي، وفي الوقت نفسه لايجب استبعاد أو إقصاء أحد ولا التخلي عنه لأن الجميع هم تعبيرات حقيقية عن محاولة الإجابة. التراث هو ماضي، ولكن أكثر مايجب الانتباه له من هذا الماضي شيئين، أولاً، السؤال عن منطقة المحايثة بين الله المنزه والعالم، وثانياً، الطريقة التي كان يُجاب بها عن هذا السؤال والتقاليد الفلسفية التي أسسها المسلمون. كانت كل إجابة تلبي مطلباً مهماً في التاريخ يبقى طالما أنها إجابة تستجيب بكفاءة لواقع معين. الإجابات التراثية توقظنا على السؤال الوجودي ولكن لايجب النظر إليها على أنها إجابات ناجزة ومكتملة بل إنها على طريق الإنجاز، وهذا يسمح لنا التخلص من كل الوثنيات الفكرية التي تسمرت عند مذهب معين ومدرسة معينة، ونسيت أن الله اللامتعين لايمكن سجنه ولا تأطيره في تسمية ولا في موقع نظري نهائي. كل الصيغ والنظريات هي فرصة لممارسة التجربة في إنشاء منطقة محايثة جديدة للعالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] من مقدمة كتاب، الله: الآخرية في الحضور، الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافي للكتاب، 2018.
[2] الاستحضار يعني دائماً كيفية فهم العقل الإنساني لحضور الله في العالم، هو استحضار نظري وعقلي لله المنزه.
[3] صدر عن المركز الثقافي للكتاب عام 2019 الجزء الذي يناقش خطاب الذات بعنوان: الحقيقة وسلطة الاختلاف، بعد صدور كتاب، الله: الآخرية.
[4] المقصود بخطاب الوسائط الفلسفة اليونانية بصيغتها الاسكندرانية التي وصلت للمسلمين مع حركة الترجمة، وسيصدر قريبا كتاب يناقش طبيعة هذا الخطاب.
[5] التشكلات المبكرة للفكر الإسلامي، 2005.