الاغترابُ الميتافيزيقي
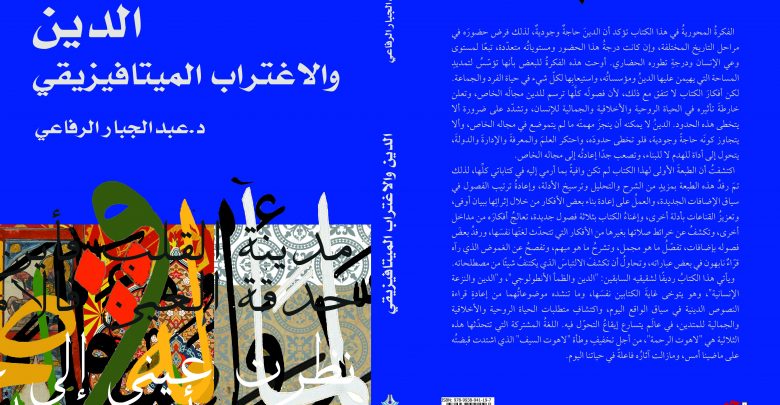
تفرضُ رؤيةُ الكائنِ البشري للعالَم الذي يعيش فيه كيفيةَ صلته بالعالَم، ويتشكّل نمطُ وجودِهِ في ضوئها، وتمثّلُ هذه الرؤيةُ إطارًا مرجعيًا موجّهًا لتفكيرِهِ ومواقفِهِ وسلوكِهِ في الحياة.
لقد صنع علمُ الكلام رؤيةَ معظم المسلمين للعالَم، بعد أنْ تسيّدت الرؤيةُ التوحيديةُ للمتكلمين مبكرًا الحياةَ الدينيةَ في عالم الإسلام، واستولت بالتدريج على شعورِ المسلم ولا شعورِه، وصاغت أشكالَ علاقته بذاته والآخر، وتشكّلَ في سياقها منطقُ التفكير الديني في الإسلام، وظهرت بصمتُها في تدوينِ علومِ الدين ومعارفِهِ المختلفة. وانتهت إلى ضربٍ من الاغترابِ الوجودي للمتديّن عن عالَمِهِ الذي يعيشُ فيه.
في لاهوتِ المتكلّمين يغتربُ الإنسانُ وجوديًا عن الله، لأن ذلك اللاهوتَ يبرعُ في نحتِ صورةٍ لله تحاكي علاقةَ السيد بالعبد المكرّسةَ في مجتمعات الأمس. الله في هذا اللاهوت تسلطي كما الملوك المستبدّين، نمطُ علاقته بالإنسان كأنها علاقةُ مالكٍ برقيقه، فهو يمتلك الناسَ كما يمتلك الأسيادُ الرقيقَ، ويمتلك أقدارَهم، ويمتلك التصرّفَ بكلّ شيء في حياتهم. وقد وُلدت عقيدةُ الجبر في أفق هذه الرؤية مبكرًا، وأصبحت منبعًا لشرعنة الأشكال المتنوّعة للاستبداد في تاريخ الإسلام. وحاولَ بعضُ الفقهاء تبريرَ استبدادِ الحاكم في أدبيات الأحكامِ السلطانية، وتفويضِه بحقِّ الاستحواذِ على السلطةِ واحتكارِها، وبحقِّ ممارسةِ كلّ ما من شأنه تدبيرُ الشأن العام وبسطُ الأمن ما دام عادلًا. ولا أدري كيف يمكن أنْ يجتمعَ الضدان (الاستبداد/العدالة) في أفعالِ وأوامر شخصٍ واحد، على نحوٍ يكون عادلًا في استبدادِهِ، ومستبدًا في عدالتِهِ. وهو ما تفنَّن بعضُ المتكلّمين في تسويغِه عندما نحتوا صورةً لله تحاكي شخصيةَ المستبدّ الظالم في أوامرِهِ، لكنَّه العادلُ مع خلقِهِ في تلك الأوامر.
إن الصورةَ التي صاغها المتكلّمون لله في كتاباتهم لا يتجلّى فيها شيءٌ من رحمته، بل تظهر قاسيةً شديدةً، إذ عمل المتكلمُ على رسم صورةِ الخالق بوصفه مُعاقِبًا لخلقه عقابًا مريرًا، ومعذِّبًا لهم عذابًا مريعًا، ومتسلِّطًا عليهم، يراقب كلَّ زلّةٍ أو خروجٍ عمَّا فرضته تلك الصورةُ من أوامر ونواهٍ تتّسع لكلّ صغيرة وكبيرة في حياتهم. وتغلّبت صورةُ الإله المرعبِ وتغلغلت في آثار المتكلمين، حتى طمستْ ما يشي بمحبةِ اللهِ لخلقِه، ورحمتِه، وعفوِهِ وتوبتِهِ ومغفرتِهِ لهم. من هنا نشأ جدلٌ واسعٌ بين المتكلّمين حولَ مصير فاعل الكبيرةِ، حتى قال بعضُهم بخلوده في النارِ.
ولم تشأ تلك الصورةُ قبولَ التنوّع والاختلاف الطبيعي بين البشر، ولم تقبل صورةُ الله التي نحتوها إلّا النموذجَ الواحدَ الذي صاغه علمُ الكلام، وهو نموذج يجب أنْ يتماثلَ فيه كلُّ الناس الذين يعيشون في الأرض أمس واليوم وغدًا.
وكان من نتائج تسيّد صورة الله هذه، بناءُ علاقة عدائية بين الله والإنسان، لأن رسمَ صورة مخيفة لله تقود الإنسانَ للنفور منه، الإنسانُ بطبيعته ينفر من كلّ ما هو مخيف، ولا ينجذب إلّا لما كان محبوبًا جميلًا.
قادتْ تلك الصورةُ المكفهرّةُ الإنسانَ للهروب من الله بسبب ما أثارته من قلق، وذعر، وكآبة، وربما اشمئزاز. فإنه لا يمكن أن يحبَّ الإنسانُ عدوَّه، أو يظلّ محايدًا حياله، بل عادةً ما يلجأ لمقاومته، فإنْ لم يستطع يلجأ للاحتماء، بالاختباءِ والغيابِ عنه تمامًا. وعندما يحتجب الإنسانُ عن الله يحتجب اللهُ عنه.
عندئذٍ ينتهي الحالُ بالإنسان للسقوطِ في الاغترابِ الوجودي أو «الاغتراب الميتافيزيقي»، الذي هو ضربٌ من الاغتراب يختلف عن اغتراب الوعي والاغتراب الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والسياسي. إنه ضياعُ كينونة الكائن البشري وتشرّدُها عن أصلها الوجودي.
يفتقرُ الإنسانُ في وجوده المتناهي المحدود إلى اتصالٍ بوجودٍ غنيّ لا نهائيّ لا محدود، وعندما لا يتحقّق له مثلُ هذا الاتصال الوجودي يسقطُ في الاغترابِ الميتافيزيقي. والاغترابُ الميتافيزيقي يعني أن وجودَ الذات البشرية وكمالَها لا يتحقّقان ما دامتْ مغتربةً في منفى عن أصلها الذي هو الوجود الإلهي.
الاغترابُ الميتافيزيقي ضربٌ من الاغتراب لا يرادف تفسيرَ جورج ويلهم فردريك هيغل (1770 – 1831) الذي يرى أن الاغترابَ ينشأ من وعي الإنسان بالهوة الشاسعة بين وجوده والحقيقة النهائية «الروح المطلقة» أو العالم المثالي. فالإنسانُ يكون مغتربًا عندما لا يجد ذاتَه في العالم المثالي.
ولا يرادف الاغترابُ الميتافيزيقي تفسيرَ لودفيغ فويرباخ (1804 – 1872) الذي يرى أن خيالَ الإنسان هو من اخترع فكرةَ الإله وأسقط عليها كلَّ كمالاته، فأصبح الإنسان مُستلَبًا، عندما صيّر الإلهَ كلَّ شيء في حين سلب من ذاته كلَّ شيء.
ولا يرادف الاغترابُ الميتافيزيقي تفسيرَ كارل ماركس (1818 – 1883) الذي جعل سببَ الاغتراب استغلالَ الرأسمالي للعامل، واستلابَ قيمة عمله، الذي يفضي إلى: اغترابِ العامل عن ناتج عمله، واغترابِه عن عملية الإنتاج، ومن ثم اغترابِه عن وجوده النوعي ككائن بشري، واغترابِ العمال بعضِهم عن بعضِهم الآخر.
كما لا يرادف الاغترابُ الميتافيزيقي تفسيرَ سيغموند فرويد (1856 – 1939)، الذي رأى أن الاغترابَ ناتجٌ عن وجودِ الحضارة واستلابِها لغرائز الإنسان، اثر ما يحدث من تعارض بين متطلّبات بناء الحضارة وما تفرضه الدوافعُ الغريزية للإنسان من متطلّبات مضادّة.
وأعني بـ «الاغتراب الميتافيزيقي» أن الإنسان هو الكائنُ الوحيد في هذا العالم الذي لا يكتفي بوجود ذاته، فيشعر على الدوام بافتقاره إلى ما يثري وجودَه، لذلك لا يكفّ عن الاتصال بمنبع لا محدود للوجود، يتكرّس به وجودُه الشخصي، ويظلّ يعمل كلّ حياته على توسعة وجودِه وإغنائه، من خلال السعي للعثور على ذلك المنبع اللامحدود للوجود، فإنْ عجز عن الاتصال بالمطلق عاش حالةَ ضياعٍ واغترابٍ وجودي.
ولما كان كلُّ شخص يحتاجُ لما يتخطّى وجودَ ذاته المحدود، فإنْ لم يصل إلى المطلق يحاول أن يعوّض حاجتَه بما يعتقد به من مطلق، بقطع النظر عن نوع ما يعتقد به، سواء أكان أيديولوجيًّا، أو ميثولوجيًّا، أو فكرةً، أو أمةً، أو إثنيةً، أو بطلًا، أو وطنًا، أو ملحمةً، أو سرديةً، أو غيرها، وكلها تنتمي إلى المتخيَّل الذي تنسجه كلُّ جماعة لنفسها، ويتحقّق فيه شكلٌ من أشكال حضورِها، وحضورِ كلِّ فرد ينتمي إليها، وشعورِه بالاتصال بمطلق. لكنه عندما يستفيق متأخرًا يجد ذاتَه مقذوفةً في متاهات، وكأنه يهرول وراء سراب، لأن كلَّ ذلك لا يشعره بأن وجودَه الفردي يتكرّس بمزيد من الوجود. بمعنى أن لدى كلِّ فرد حاجةً إضافيةً في ذاته للوجود عابرةً لوجوده الشخصي الضيّق، وهذا الوجودُ لا يفيضه سوى الاتصال الحيوي بالمطلق.إذ يتّسع وجودُ الكائن البشري بمدى قدرته على تحقيق ضربٍ من الاتصال بهذا الوجود اللامحدود.
وجودُنا الفقيرُ يبحثُ عن وجودٍ يتسعُ له ويتحررُ به من كلِّ حدود وقيود الوجود. الزمانُ والمكانُ واللغةُ قيودٌ وحدودٌ تُفقِر الوجود، وتغرقه في اللا معنى أحيانًا، لذلك يبحث الإنسان عن لغة بديلة للغته تستوعب ما يتوالد في متخيله وأحلامه وأوهامه وقلقه وآلامه، فينتقل للرمز الذي يتسعُ لما لا تتسعُ له أيةُ لغةٍ.الرمزُ يتكفل بتزويد الإنسان بمعانٍ تضيقُ بها اللغةُ، الرمزُ لغةُ الأديانِ والفنون، لذلك كانت الأديانُ والفنونُ من أثرى منابع المعنى في حياة البشر.
كلُّ وجودٍ يقترنُ بزمانٍ ومكانٍ ولغةٍ فقيرٌ، لأن الزمانَ والمكانَ واللغةَ قيودٌ تقيّدُ الوجودَ وحدودٌ تحده، وكلُّ قيدٍ وحدٍ نهايةٌ، والنهايةُ افتقارٌ، وكلُّ افتقارٍ ضربٌ من الظلامِ. لذلك لا يمتلكُ الوجودُ المحدودُ كينونتَه إلا عندما يتحررُ من حدودِ الزمانِ والمكانِ واللغةِ. الزمانُ الذي هو غطاءٌ من الظلامِ يحتجبُ به الوجودُ، فيغترب عن ذاته. الصلةُ الوجوديةُ بالوجود المطلق، وهو الله، هي ما يحرّرُ الوجودَ المحدود من اغترابه، أي من فقرهِ الناتج عن قيوده وحدوده، التي عندما يتخلصُ منها يمتلكُ كينونتَه، فيكتمل وجودُه، وتُمحى غربته عن ذاته. لا يمتلكُ الوجودُ المحدود ذاتَه إلا بصلته الوجودية بالوجود المطلق. وهذه الصلة لم أجدها في مدونة علم الكلام الإسلامي، الذي أنتجَ غربةَ المسلم عن ذاته وعالَمه.
هذا المعنى هو الذي أفهمه من آية النور: “اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ”[1]. “وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا”[2]. هذا النور هو الوجود المطلق الذي يخرج به الوجود المحدود من فقره وظلمته، أي من اغترابه.
إن القرآنَ كتابٌ ميتافيزيقي بامتياز، وكلُّ ما جاء فيه ينشدُ بناءَ صلةٍ وجودية بالله، وتكريس الحياة الروحية والأخلاقية،نلحظ أن حضورَ الله يتفوّق كثيرًا على كلِّ حضورٍ في هذا الكتاب، وهذا الحضورُ لله لا نراه بهذه الكثافة في أيّ كتابٍ مقدّسٍ آخر غيرِ القرآن. فقد ورد ذكرُ اسمِ “الله” 1567 مرةً في آياته، ولو أضفنا لذلك عددَ أسماءِ الله وصفاتِه المتنوّعةِ في القرآن لتجاوز هذا العددَ بكثير، فمثلًا تكرّر ذكرُ كلمة “رب” فقط 124 مرة.
الدينُ هو ما يخلّص الإنسانَ من الاغتراب الميتافيزيقي من خلال الاتصال الوجودي بالمطلق، الذي هو الله في الأديان الإبراهيمية، والإله أو الروح الكلّي في أديان أخرى. والمطلقُ يمثّل أغزرَ منبع يستقي منه الكائنُ البشري مزيدًا من الوجود، وهذا الوجودُ هو الذي يحدّد كيفيةَ حضور الذات البشرية في العالَم، لأن الكائنَ البشري يتحقّقُ فيه بمرتبة أكمل من الوجود.
الاغترابُ الميتافيزيقي حالةٌ أنطولوجية، تُستلَب فيها كينونةُ الكائنِ البشري، ولا يتخلّص منها الإنسان إلّا ببناءِ صلةٍ ديناميكيةٍ يقظةٍ بالمطلق، تتحقّق فيها أُلفةُ الإنسان مع الوجود، بعد أنْ تحدث عمليةُ توطينٍ له، بنحو يتحوّل الوجودُ فيه إلى مَسكَنٍ يقيم فيه. وحيث يسكن الإنسانُ الوجودَ يجدُ ذاتَه، وعندما يجدُ ذاتَه يشعر بالأمان في المأوى الذي يأوي إليه. ويتبدَّل نمطُ علاقته بإلهِهِ، فيتحوّل من عداءٍ إلى حبٍ، بل قد يتسامى الحبُّ إلى مرتبةٍ يكون فيها الحبيبُ هو الأنا.
وعلى الرغم من الآثار الموجعة لاغتراب الوعي والاغتراب الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والسياسي، لكن الخلاصَ من أنواع الاغترابِ هذه لا يعني الخلاصَ من الاغتراب الميتافيزيقي، لأن الاغترابَ الميتافيزيقي اغترابٌ لكينونة الكائن البشري عن وجودها، وهذه الحالةُ من الاغتراب تنتج القلقَ الوجودي، إذ بعد أن تنقطعَ صلتُه الوجودية بإلهِهِ، يفتقدُ ذاتَه، وعندما يفتقد الإنسانُ ذاتَه يمسي عرضةً لكلِّ أشكال التبعثر والتشظّي، وربما يتردّى في حالةٍ من الغثيان الذي يعبثُ بروحِهِ ويمزّقُ سلامَه وسكينتَه الجوانية.
ونشأ اغترابُ الإنسان الوجودي عن إسقاط المتكلّمين لصورة الإنسان على الله. فقد تورّط المتكلّمون بقياس الغائب على الشاهد في دراسة توحيدِ الله وصفاتِه وأفعالهِ، وكان نموذجُهم المحسوس علاقةَ السيد بالعبد، فصاغوا في إطارها نمطَ علاقةِ الله بالإنسان. ووُلدت الرؤيةُ التوحيدية الكلامية في أفق هذا الفهم، وكُتبت المدونةُ الفقهية في سياق هذه الرؤية، وتبعًا لذلك أنتجت فقهًا يشرعن بعضَ أشكال العنف. بل تغلغلت رؤيةُ المتكلّمين في معارف الدين المختلفة، وظهر أثرُها في كثير مما أستلهمه المسلمون من النصوص الدينية.
الرؤيةُ التوحيديةُ للتصوّف الفلسفي عالجت الاغترابَ عن الله ببناء صلة وجودية بين الله والإنسان، إذ يسافرُ الإنسانُ في ضوء هذه الرؤية إلى الله حتى يصلَ إليه، ويحضر في حضرته، كذلك يقترب اللهُ من الإنسان، حتى يصيرَ الإنسان مرآةَ الله وأظهرَ تجلياته، كما يشرح ذلك مفهومُ الإنسان الكامل، وأسفارُ الإنسان في عوالم الأسماء والصفات الإلهية، وكيف يصعد الإنسانُ سُلّمَ تلك العوالم، ويتسامى ليتصل وجوديًا بالحق. في إطارِ هذه الرؤية تتلاشى المسافاتُ بين الإنسان ومقامِ الربوبية، ويتخلّص الإنسانُ من اغترابه الوجودي عن الله، ويكفّ الدينُ عن أن يكونَ منبعًا للعنف.
ويمكن العثورُ على بعض الجذور العميقة للعنف في الاغتراب الميتافيزيقي، فقد كشفت الدراساتُ الأنثروبولوجية عن اقترانِ العنف بالمقدّس[3]. وتشير التوراة والقرآن إلى أن أولَ عملية عنف دموي في الحياة البشرية قتل فيها أحدُ أبناء آدم أخاه كانت بسبب نزاع على قربان إلهي.
عندما نتحدّث عن التصوّفِ الفلسفي، وكيفيةِ رسمه لوحةً ميتافيزيقية مختلفة تمامًا عن لوحة المتكلمين، لوحة يتصل فيها الإنسانُ بالله، فيتحرّر من اغترابه الوجودي، وتبعًا لذلك يتحرّر المتدينُ من أحد بواعث الحاجة للعنف، فإن البحثَ يتناول الموضوعَ من زاوية تنشد الكشفَ عن أثر هذا النوع من الاغتراب، بوصفه يسهم في تشكيل البنيةِ العميقةِ لظهور العنف. ولسنا هنا بصدد الحديث عن الأسباب الأنثروبولوجية والاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية المختلفة للعنف، والتي لا يمكن استبعادُها ونفي الأثر المباشر والكبير لها في ظهور الأنواع المتنوّعة للعنف، وتطوّر أساليب ممارسته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[3] راجع كتاب: رينيه جيرار. العنف والمُقدَّس. ترجمة: سميرة ريشا. بيروت: المنظمة العربية للترجمة.




