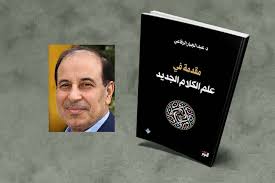انتهت دعواي في الجزء الأول من هذا المقال إلى السؤال: “هل زادت وغلبت تسمية القهر اليوم رضاً كما زادت وتوغلت أنواع جديدة من القهر في حياة الناس؟” بكلمات أخرى: هل حياة الناس اليوم أقل قابلية للرضا ذي المعنى—رضا الشخص عن نتائج فعل قام به هو نفسه (وإن أمكنه الشك في صحته لاحقاً) ولم يدفعه إليه عقل جمعي وقانون جمعي وإعلام جمعي وتعليم جمعي؟
ثمن المواطنة
هل زادت وغلبت تسمية القهر اليوم رضاً كما زادت وتوغلت أنواع جديدة من القهر في حياة الناس؟ لعلنا نتفق مبدئياً أن الانحسار فيما يمكن أن نسميه الرضا الشخصي (الذي يمكن نسبته إلى إرادة فرد بعينه) ونمو ما يمكن تسميته “الرضا الجمعي” شىء مناسب جداً لزمن نرى فيها حكم الجماعة حاسماً لا لمسائل السياسة والقانون فقط بل للمعارف نفسها (لكنني سأدع هذه الأخيرة —ادعاء بناء المعارف على حكم الجماعة لا الخاصة ذوي التدريب الملائم للمعارف محل البحث— لمقال آخر). في كاليفورنيا أكثر من 20 مليون شخص يقدر قانوناً على التصويت (من أصل 39 مليون يسكنون الولاية منهم الأطفال والمجرمون والمحجور عليهم). أغلبية من يمكنهم التصويت (أكثر من 10 ملايين) لم تصوت لاختيار رئيس من الأصل أو صوتت لمرشح كانت فرصه ضعيفة ممن لا يعرفه أحد خارج الولايات المتحدة وصوّت لهلري كلنتن 5 ملايين ونصف وللرئيس الحالي 3 ملايين ونصف. الأغلبية مع ذلك رضيت بانتخاب مَنْ لم يصوتوا له رغم عدم زيادة من رضوا بـ”ترمب” رئيساً في كاليفورنيا عن سُبع الناخبين. وفي انتخابات الرئاسة يخضع سكان كاليفورنيا لاختيار سكان مشجن ووسكنسن وبنسلفينيا وغيرها من والولايات لأن سكان كل هذه الولايات يشارك في الاختيار. وإذا نظرت إلى المسافة بين من اختاروا حاكم الولاية (كاليفورنيا) ومن أمكنهم التصويت فسكتوا أو صوتوا ضد الفائز وجدت هذه المسافة أكبر ففي انتخابات حاكم الولاية لم يصوت أكثر من خمسة ملايين صوّت منهم أقل من ثلاثة ملايين لـ”جافن نوسم” الذي نصب حاكما في يناير 2019. الرضا في الديمقراطية جمعي لا شخصي وهو لذلك أنقص من الرضا القديم (الناقص بدوره وإن كان أكمل وأخص بصاحبه من رضا أيامنا).
نعم فوق الشركات المتوغلة في ميدان الإجبار الذي يستحيل رضاً بقدرة قادر الدولة التي هي —فيما يبدو— قادرة على قهر الفرد حتى يعلن الرضا بلسانه وهو في قلبه ساخط. وإذا كان الرضا بيني وبين شركة اتصالات يمكن من حيث المبدأ تصفيتها بالقانون (ما لم يقرر أهل الشأن أنها “أكبر من أن تزول”) أو منعها من الحركة التجارية الحرة داخل بلد بعينه منقوصاً فكيف بالرضا المفترض بيني وبين دولة ذات جيش وجهاز شرطي وأجهزة إدارية وأجهزة تنصت؟ لابد أن هذا الرضا أضعف في المعنى وأقل جديةً. هذه نقطة أسرف الباحثون في استغلالها ليدعوا أن الدولة الحديثة قضت تماماً على كل الثقافات السابقة عليها كما قيدت الخيارات الشخصية الفردية لكن لها وجاهة لا نتردد فيها رغم الاختلاف في التفاصيل.
فإذا سألت نفسك ما أصل الرضا والتسليم بحكم الدولة قبل الخضوع لنتائج الانتخابات وغرائبها وجدت نفسك أمام التجنس سواء بجنسية دولة نشأ المرء فيها بين أمه وأبيه أو هاجر إليها. وعقد الجنسية نوع من العقود يفترض بناؤه أيضا على الرضا.
فهل رضا المواطن بمواطنته والتزامه الأخلاقي تجاه بلده كذبة اتفق الجميع على عدم البحث فيها (إذ كلنا هذا الرجل الكاذب)؟ دعنا نسأل سؤالاً أسهل: هل يرى الواحد منا نفسه ملتزماً أخلاقياً تجاه بلده أم ملزماً قانوناً (مجبراً لا بطلاً)؟. وهل تختلف الاجابة إن كان الواحد منا مثلاً ليبرالياً مؤمناً بأن الليبرالية مرادفة للخير أو “إيرانياً” مؤمناً بأن ثورة بلاده أقامت البلد الشيعي الذي يلزم الشيعة في العالم كله ديناً وخلقاً بدعمه؟ يشكك الأستاذ جون سِمُنْز[i] بقوة في إمكان طرح دعوى التزام الليبرالي أخلاقياً تجاه دولة حديثة من النوع الليبرالي الذي يفترض الليبراليون أنها أحسن ما هو متاح من الناحية الالتزام بالعدالة (لأن الليبرالية تحقق للرجال والنساء واللوطيين والزنوج والأقليات المسلمة في الولايات المتحدة مثلاً جميعا احتراماً وعدالةً لا تحققها النظم المبنية على الدين ولا النظم المحافظة التي تقع في التمييز العنصري مثلا). يقول سمنز إن تاريخ هذه الليبراليات وحاضرها يعوق هذه الدعوى. فالتاريخ حبس جماعات من الناس داخل هذه البلاد وأجبرها على الوقوع في ظلم سكان بلاد أخرى وهذان الأمران أهم من التطور الذي أصاب نظم وقوانين هذه البلاد فجعلها مثلاً تضع رجلا أسود على رأس جهازها التنفيذي. لم يرض الشعب الأمريكي ولا يمكنه أن يرضى بعواقب عقد الجنسية الذي التزم به سواء بأن وُلِد فيها ولم يتركها أو هاجر اليها واختار التجنس بجنسيتها إلا أن نفهم الرضا بمعناه الجديد (رضا السكوت لغياب البدائل—الرضا الجمعي السلبي). وكلام سمنز وسؤاله أكثر نضجاً بمراحل من مباحثات دارسي السياسة من أمثال هنتنجتن الذي شُغل وشغل معه الناس بقضية نمو السكان “اللاتينو” واحتمال أن يلعبوا دوراً سلبياً في إضعاف المبادىء الأنجلوبروتستانتية التي بنيت عليها الولايات المتحدة ثقافةً واقتصاداً. وكان يلزمه تكملةً لبحثه أن يشرح كيفية صناعة البشر الملائمين للولايات المتحدة حتى تستمر في جلب السكان والحفاظ على هويتها في نفس الوقت. (وهذه مُزحة لعل معناها لم يخْفَ على القارىء.)
وعندي أن الأستاذ سمنز يبقى مصيباً وإن استبدلنا بـهذا “الليبراليِ” المسلمَ الذي يعتقد نظرياً لزوم “ولائه” لبلد يحكمها مسلمون. ويعلم من يعلم شيئاً عن الفقه الإسلامي الحديث أن الفتاوى قد كثرت في قرن الإسلام الرابع عشر (القرن العشرين المسيحي) تحرم التجنس بجنسيات الدول الأوروبية وهذا على أساس أن المسلم الذي نشأ بين مسلمين رضي رضاً حقيقياً عن بقائه في مجتمعه الذي تغير فلم يعد يشبه المجتمع الذي وصفه المفتون ليقارنوا بينه وبين المجتمع الأوروبي الذي يريدون تحريم التجنس بجنسيته. هم يفترضون أن المسلم وقتها أمامه خياران: الرضا بالإسلام فيلزمه عندهم البقاء تحت حكم من يعتبر نفسه حاكماً مسلماً أو القبول بصفة “المرتد” عن الدين. صحيح أن أقدم هذه الفتاوى كان قد صدر في وقت كان معنى تجنس التونسي أو الجزائري بالجنسية الفرنسية أنه ربما يحارب أهلَه لحساب جيش فرنسا لكن استمرار هذه الفتاوى من مشائخ بلاد قامت على التحالف مع دول أوروبا وأمريكا الشمالية أخلاها تماماً من كل معنى وتبرير. فلا فرق بين ليبرالي ومسلم في التزامه الاخلاقي (أو عدمه) تجاه دولة تتبع فلسفيا المبادئ التى يلزم نفسه بها في حياته. (أي أن أي واحد منهما لا يلزمه أخلاقياً البقاء في بلده والدفاع عنها مثلاً إذا أصابها شر الحرب الداخلية أو العدوان من الخارج لأن البلاد تساس بنفس الطريقة مهما اختلف لون حكامها ودينهم وعرقهم.)
كم فرقاً ترى بين عقد المواطنة الذي هو بينك وبين بلدك وبين عقدك مع شركة التليفون؟
رضينا سواء أبينا أم رضينا
الرضا هذه الأيام —الرضا الجمعي السكوتي السلبي— هو رضا الضرورة الذي ينبني على ضعف الخيارات وهو أيضاً رضا الوقت الذي ضعفت فيه ثقة المرء بنفسه، فالواحد اليوم قل أن يسأل نفسه عن رأيه ثم يتكلم بل يتأمل حال من حوله قبل أن يقرر هل يسكت أم يتكلم ثم بأي شيء يتكلم. قد يكون أساس هذا الرضا دائماً حسبة اقتصادية نخجل من التصريح بها. ونحن مع ذلك نُعجب سراً بشجاعة الممثل الفرنسي جيرار دوباردو الذي لم يتورع عن خلع جنسيته الفرنسية واعتناق البلجيكية ليوفر في ضرائبه السنوية. (كيف لا يكون جيرار دوباردو فرنسياً وكانت نسبته إلى فرنسا عند أبناء جيلي كنسبة برج ايفيل لفرنسا سواء بسواء؟) نحن —وهذا ليس جديداً— نحسب المصالح والمفاسد ثم نرى رأينا. ولو قدرنا على خلع أوطاننا من غير ثمن لفعلناها. والقليل منا يقدر. ومن يقدر مرةً فلن يقدر مرةً أخرى.
وليس الرضا (الذي هو سكون النفس واطمئنانها) أساساً مطلوباً لمشروعية القوانين الحاكمة للحياة المدنية والقانونية والسياسية. هل تراك تظن أن سكان الولايات المتحدة رضوا بهذا المعنى مثلاً بحكم محكمتهم العليا سنة 2015 الذي جعل نكاح الرجل للرجل حقا دستوريا مكفولا منذ سنة 1868 (بالتعديل الدستوري الرابع عشر) وان لم يُعمل به قبل سنة 2000 الا في أماكن قليلة في هذه الولايات المتحدة المتفرقة؟ تقول الإحصاءات إن أكثر الشباب رضوا وتوقف الشيوخ. لكن الواقع أن الجميع —عملياً— راضٍ عن القوانين رضا البكر التي إذنها صماتها.
أعلم أن قد صاحب صعودَ ما يسمى اليمين القومي مع نجاح الرئيس الأمريكي الحالي (السمسار سابقاً) كما صاحب انتخابَ جورج بُش في الماضي هياجُ مشاعر مضطربة لدى عدد من الأمريكيين تجاه التغير السكاني والثقافي الذي أصاب “بلادهم” بنزوح أفارقة وآسيويين لا يشاركونهم في العادات والأخلاق.
وأنا لم أسأل عن رأي الناس في نفسهم إلا عرضاً، وإنما بحثت عن أصل واقعي قانوني سياسي (قبل الثقافي النفسي) لاعتبار بلدٍ من البلاد بلداً من هذا النوع أو ذاك وهو —في دعواي— الرضا الجمعي السلبي (الذي سعيتُ إلى إزاحة التراب عنه في هذا المقال). وأنت رأيت أنني أنظر إلى المسألة من غير تحيز للنظرة القانونية الدولية الحديثة التي تفترض التزام الناس بنظام عالمي أو دولي قانوني من نوع معين لأن كل الفروض الواثقة بهذه المبادىء —فيما يبدو لي— لم تعد مقنعة لمعظم الناس وإن ترددوا في التعبير عن شكهم وضعف ثقتهم في هذه المبادىء التي كانت (منذ نصف قرن مثلاً) تبدو مسلمة كمسلمات الرياضيات.
فلنتوقف هنا لنسأل مرةً أخرى أخيرة: هل رضي أوروبيو أمريكا الشمالية حقاً بعولمة قارتهم عرقياً؟ والجواب: نعم رضوا ربما كما رضيت المرأة الإنجليزية طويلاً بفقه بلاكستون ورضيت أنا وأنت وكل من يعيش تحت حكم القانون الذي يعيد تعريف النكاح والبيع والعقود كلها اليوم بهذه التعريفات وإن سخرنا منها وهاجمناها في السر والعلن. رضينا سواء أبينا أم رضينا. نعم رضي أوروبيو أمريكا الشمالية كما يرضون في عادتهم في الرضا سواء أبوا (في الواقع) أم رضوا.
لتحميل المقالة والاطلاع عليها كاملة، انقر هنا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[i] John Simmons, Boundaries of Authority (Oxford: Oxford University Press, 2016).