
قراءة نقدية لكتاب
الحريات العامة في الدّولة الإسلاميّة لراشد الغنوشي
أعتمد في الإحالة إلى هذا الكتاب الطبعة الأولى له من طرف مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1993.
أوّلا- التقديم المادي والمنهجي الشكلي والأسلوبي للكتاب:
أُعِدّ الكتاب في الأصل للحصول على درجة الدكتورا من كلية الشريعة وأصول الدين بتونس، لكن الحملة الأمنية التي شنّها النظام على الإسلاميين أواسط الثمانينات قضت على هذه الغاية. فقد أعدّ الغنوشي الجزء الأوفر منه فترة سجنه بين سنتي 1981 و1984، واستأنف العمل عليه في صائفة 1986 لما اضطر للاختفاء عن أعين السلطة بعد هدنة قصيرة معها. ولذلك استحالت مناقشة هذه الأطروحة.
الكتاب من القطع الكبير (حوالي 24x 16) وبه 382 صفحة.
وهو يتضمن:
- تمهيدا به خطة البحث وطرح الإشكالية: حقيقة المشكل السياسي.
- قسما أوّل: حقوق الإنسان وحرياته في الإسلام.
- قسما ثان: الحقوق والحريات السياسية.
- قسما ثالثا: ضمانات عدم الجور أو الحريات العامة في النظام الإسلامي
مما يعني أن القسمين الأول والثاني إن هما إلا إطارا نظريا للبحث، ذلك أن معنى عنوان القسم الثالث يتطابق مع عنوان الكتاب ككل، ولكنه لم يحظ إلا بثلث حجم الكتاب، حيث إنه يبدأ من الصفحة 217 وينتهي في الصفحة 317.
باقي صفحات الكتاب خصّصت لتلخيص الأقسام الثلاثة واستخلاص نتائجها (إلى ص. 364)، ثم تأتي الملاحق والمراجع وفهرس الأعلام والمصطلحات مندمجة.
أسلوب كتابة البحث
راوح الباحث بين ثلاثة أساليب في الكتابة:
- الأسلوب العلمي ويظهر ذلك في التوثيق الدقيق للشواهد والإحالات، وفي التقسيم المنهجي للكتاب وفي التعريفات والتحاليل المفهومية التي يقدمها، وأخيرا في طريقة عرضه لأراء علماء التراث ومناقشتها وترجيح بعضها على بعض ترجيحا معلّلا، كم فعل مثلا مع قضية الردّة.
- الأسلوب السّجالي: ويبرز عموما في سياقين. سياق عرض النظريات الليبيرالية والماركسية ومناقشتها. وسياق نقد النظام السياسي القائم ونقد أسسه الدستورية. ففي هذين السياقين كثيرا ما تعترضنا عبارات الاستهزاء والشتيمة من قبيل أن “النقد الماركسي للنظام الليبيرالي جوهره هدم ونفاق” (ص. 33) وأن “ديباجات الدساتير الغربية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وهم وخداع”(ص. 34). وفي الطبعة الثالثة للكتاب يصف الغنوشي كاتبي دستور 1956 التونسي بأن “الجم الغفير منهم من ذوي الوعي الضحل ومن المنافقين”، وذلك تعليقا على صياغة الفصل الأول منه: “تونس دولة ذات سيادة، العربية لغتها والإسلام دينها…”. وقد وصف الغنوشي صياغته بكونها “مائعة ومطاطة” (ص. 126). وهو عين الفصل الذي شاركت النهضة في تثبيته في دستور 27 جانفي 2014 ولم تجد عنه بديلا في سياق تحقيق إجماع وطني حوله. أما في طبعة مركز دراسات الوحدة العربية، فقد تهذّب نقد الغنوشي لكاتبي هذا الفصل، حيث لم يصفهم بالنفاق وإنما فقط بقلة الوعي، وهذا تم على الأرجح بتدخل من رئيس المركز وخبراءه محافظة منهم على الحد الأدنى من السمت الأكاديمي للعمل.
- الأسلوب التقريظي: وهو مبثوث في مواضع كثيرة من الكتاب وخاصة في الفصل الرابع منه الخاص بالمبادئ الأساسية للحكم الإسلامي، وخصوصا لدى التعرض لبعض التجارب التاريخية السياسية في الحضارة الإسلامية.
ثانيا- الإطار النظري الضمني لكتاب الحريات العامة في الإسلام (وقضية الخلافة)
يؤصّل المؤلّف بحثه في ما يسميه النظام السياسي الإسلامي، ولكنه لا يحدّد هذا النظام الذي ذكره، بما يفترض وجود هذا النظام واشتهاره بين الباحثين والناشطين السياسيين، بينما لا شيء من ذلك متحقق فعلا وعلى نحو واضح وقاطع. يقول الغنوشي: “إن البحث في االحريات العامة جزء لا يتجزّأ من البحث في النّظام السياسي الإسلامي، وهو بحث يفترض التسليم سلفا بشمول نظام الإسلام لحياة الإنسان فردا وجماعة…وهذه المسألة ننطلق منها كمسلمة” (ص. 24).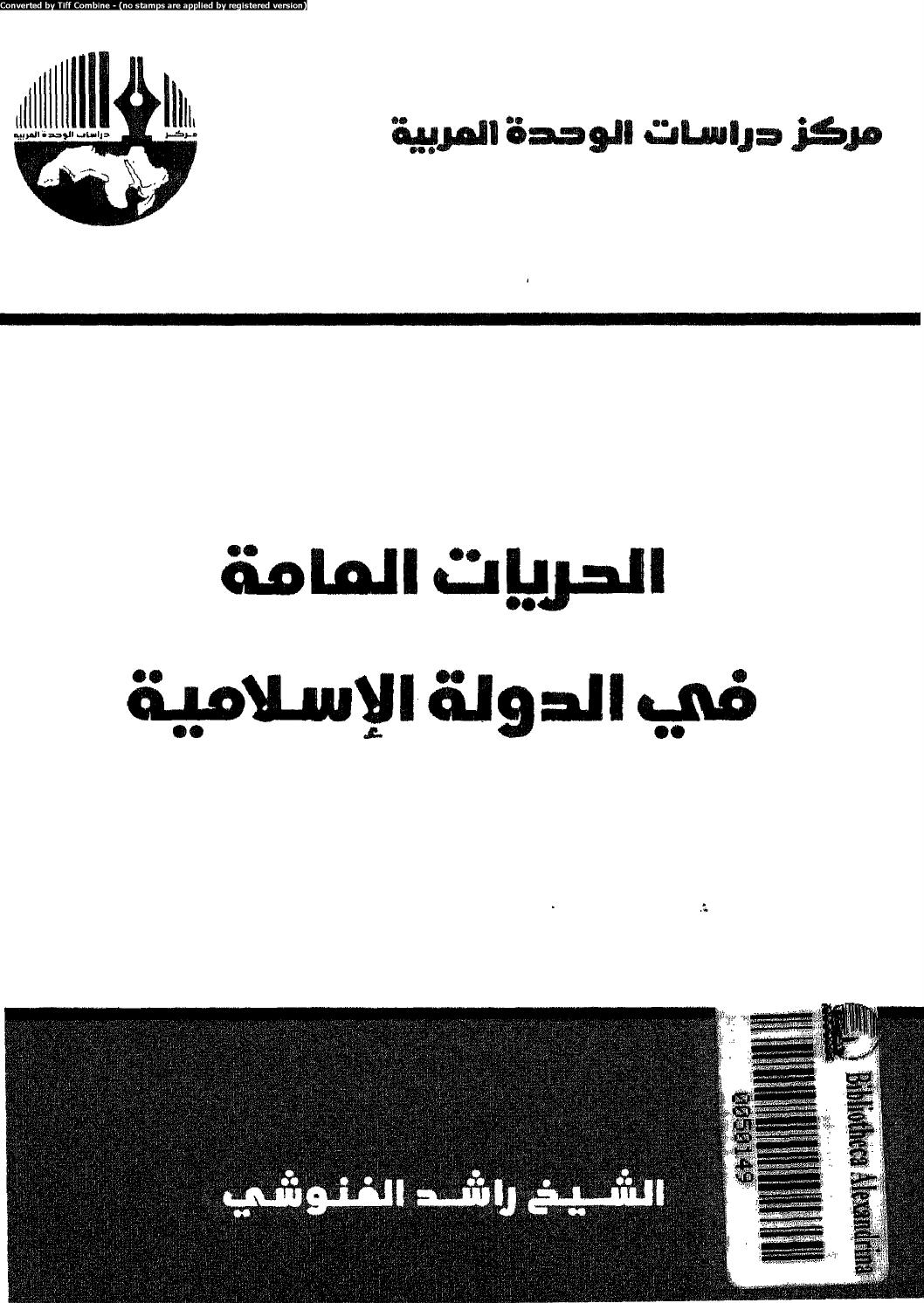
فما هو هذا النظام السياسي الإسلامي؟ هل هو نظام الخلافة مثلا؟ نعم إنه نظام الخلافة. وعنه يقول الغنوشي بعد 128 صفحة من كلامه في المنهج والإطار النظري للبحث، محيلا إلى الشهيد عبد القادر عودة:
“تعتبر الخلافة فريضة من فروض الكفايات كالجهاد والقضاء، فإذا قام بها من هو أهل لها سقطت الفريضة عن الكافة، وإن لم يقم بها احد أثم كافة المسلمين حتى يقوم بأمر الخلافة من هو أهل لها” (ص. 152).
ويعرّف الخلافة كالآتي:
“الخلافة حسب علماء الشريعة عقد يتمّ عن اختيار وقبول بين الأمة والخليفة تترتب عنه التزامات وحقوق تفرض على الخليفة السير في حكمه وسياسته على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله وإقامة العدل”(ص. 165-166).
والخلافة نموذج للحكم يغذي بصفة مثالية المخيال السياسي للإسلاميين بمن فيهم إسلاميو تونس.
يقول السيّد الجبالي لما كان رئيسا للحكومة إبان فترة الترويكا أمام حشد من أنصار الحركة الإسلامية: “يا إخواني أنتم الآن أمام لحظة تاريخية، أمام لحظة ربّانية في دورة حضارية جديدة إن شاء الله في الخلافة الراشدة السادسة إن شاء الله، مسؤولية كبيرة أمامنا والشعب قدّم لنا ثقته ليس لنحكم ولكن أعطانا ثقته لنخدمه، وإياكم وعقلية الحاكم، أنتم تحمون هذا الشعب إن شاء الله”[2].
فأين ستقوم هذه الخلافة؟ وهَبْ انها قامت في أفغانستان أو في السودان أو في العراق، فهل علينا في تونس ان نخرج من البرلمان ونحلّ الاحزاب ونخرج على الدولة الوطنية ونحرق جواو السفر ونمزّق بطاقة التعريف الوطنية ونعلن الولاء لخليفة المسلمين الأفغاني أو السوداني أو البغدادي؟
وهذا الخليفة هل يتم انتخابه من جملة عدة مترشحين يقومون بحملة انتخابية للظفر بمنصب الخلافة؟ وهل أن الذي يظفر بها يمكث فيها مدى الحياة حتى يهرم ويموت أو يموت في حادث من الحوادث؟
وما معنى يحكم “على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله”؟ هل بطرح حزب التحرير؟ أم بطرح الوهابية؟ أم بطرح القاعدة في بلاد المغرب؟ أم بطرح جبهة النصرة؟ أم بطرح حزب النور المصري؟ أم بطرح الدواعش؟ وكيف سيجمع الأمة من حوله؟ بالدعوة ومعادة كل الدول الإسلامية وقادتها حتى يدخلوا في طاعته؟ أم يشن عليهم حروبا و”فتوحات” جديدة؟ أم كيف؟
أما ما يعتبره الغنوشي الإطار الأعم الذي يشمل ما سماه “النظام السياسي في الإسلام، فهو مفهوم شمولية الإسلام بالمعنى الذي وجده عند سيد قطب، ولكنه لم يحلله، لأنه اعتبره مسلّمة. ومع ذلك فقد اقتبس منه مفهوم الحاكمية لله. حيث يقول: “إن حاكمية الله سبحانه وسيادته في حياة الإنسان قد نطق بها الوحي كتابا وسنة (السنة التشريعية) فمنه استمدت الشريعة…فشريعة الله حاكمة على ما سواها”(ص. 104). كما استمد منه ومن الفكر الإخواني ككل فكرة أو شعار أن “الإسلام دين ودولة” (ص. 25).
يقول سيد قطب في كتاب خصائص التصور الإسلامي ومقوماته[3]: “كذلك يعتقد المسلم أن لا حاكم إلا الله، وأن لا مشرّع إلا الله…” (ص. 197). فماذا نفعل الآن بالبرلمان وكل القوانين التي شرّعها؟ أين الدور الاستخلافي للبشر المتشبعين بقيم الوحي وأخلاق النبوّة في طور ما بعد ختم النبوة، والتي يمكن الوصول إليها أيضا من طريق العقل الراشد الباني للقيم الكونية؟ وإن أكبر ميزة للأخلاق القرآنية كونها أخلاق مبنية على أساس موضوعي كوني وهو الفطرة التي يشترك فيها كل البشر، وهو ما شرحه بكل وضوح مؤلف كتاب أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، الشيخ الطاهر ابن عاشور.
هذا ويربط سيد قطب ربطا وثيقا بين مفهوم التوحيد ومفهوم الحاكمية (ص. 200). وقد اعتمد الغنوشي هذا المنهج أيضا بطريقة مضطربة. فهو ينطلق من التوحيد مثلا لتسويغ الحرية التي هي للإنسان من جهة منح الله الخالق إياها له، ناقدا في الآن نفسه الطرح الفلسفي الغربي بخصوص الحرية بما هي حق طبيعي للإنسان المواطن، مستبطنا مفهوم الحاكمية لله. ولكن الاضطراب يظهر لاحقا لدى اعترافه بحق المواطنة لغير المسلم بما في هذا الحق من مزايا ديمقراطية مثل الحرية وغيرها، دون تأصيل ذلك في زوج “التوحيد/ الحاكمية”، وهو ما سنشرحه لاحقا. وكما سنرى لاحقا أيضا يعود هذا الاضطراب إلى أمرين:
- النزعة الحركية البراغماتية في مناخات تفكير ونشاط إخوانية، رغم طموح الكتاب إلى بلوغ درجة البحث العلمي من مستوى الدكتورا.
- كثرة المتدخلين في “إثراء” الكتاب ومراجعته وإعداده، وهو ما سنوضحه في إبانه.
ثالثا- مفهوم الحرية وصلته بالمواطنة وبالديمقراطية: هل توجد هذه الصلة في كتاب الغنوشي أم لا؟
يقول الغنوشي نافيا أن يكون أساس بناء الديمقراطية والمواطنة هو البحث الفلسفي في مفهوم الحرية: “ليس المجال هنا بحثا فلسفيا حول مفهوم الحرية” (ص. 31). ولكنه حصر وجوه البحث الفلسفي فيها في البحث عن ماهيتها والبرهنة على وجودها. وهو ما نفى إمكانيته.
صحيح أنه استحال على العقل الفلسفي إثبات حرية الإنسان (كانط وسبينوزا مثلا) ولذلك جعل كانط من الحرية إحدى مصادرات العقل العملي الأخلاقي الثلاثة (الله، الحرية، خلود النفس). ومع ذلك فإن سبينوزا يعرّف الإنسان الحر كالآتي: “الإنسان الحر هو الذي يهتدي بالعقل وحده” (من برهان القضية 68 من الجزء الرابع). أي أن الإنسان كلما تحرّر من الأهواء والانفعالات وسلطة الغرائز المنفلتة ومفاعيل اللاوعي كلما كان حرا. “الإنسان الحر هو الذي يهتدي بالعقل وحده”: في هذه الجملة القصيرة والمكثفة نعثر على مقوّمي الحداثة اللذين ذكرهما آلان توران في كتابه “نقد الحداثة”: الفرد (الإنسان) والعقلانية أي السلوك وفق حكم العقل. الإنسان الحر إذن هو إنسان الحداثة وما قبلها كان الإنسان مكبلا بالموروث وبالأوهام وبالظنون وبالوعي الحسي المباشر وبشتى العوائق المعرفية. الإنسان في الدولة يصبح هو المواطن والحرية تصبح هي الديمقراطية. وليس هذا ما يقول به الأستاذ راشد الغنوشي ولا تلامذته أمثال محسن ميلي وغيرهم الذين اقتبس عنهم بعض الأفكار.
فهو أولا يسخر من تصور الإنسان في النظام السياسي الغربي مواطنا (ص. 31)[4] وهو يعتبر ثانيا أن مفهوم الحرية لا ينبع في التصور الإسلامي من طبيعة الإنسان التي “تنبثق عنها بذاتها حقوق طبيعية- كما ادعى الفكر الغربي [حسب قوله]” (ص. 37). يريد من هذا كله أن يذهب بنا إلى تأسيس مفهوم الحرية مفهوما كلاميا بالعودة إلى قضية التوحيد وتذكيرنا بأن الإنسان هو مخلوق لله ميزه بصفات العقل والإرادة والحرية والمسؤولية…الخ. وهذا لعمري نقد غريب لنظرية الحق الطبيعي. فلكأن الحق الطبيعي الذي يضمن حرية الإنسان في وظيفته المواطنية ليس هبة إلهية له. أي إقامة تنافس وتعارض مصطنع بين الإرادة الإلهية وحرية الإرادة الإنسانية. فنحن مثلا عندما نبني علوم الطبيعة والعلوم الطبية وندرس تكوين جسد الإنسان أو جهازه النفسي، ونضع قواعد لسلامته البدنية والنفسية ونبني علوم التربية لنضمن سلامة تفكيره ورفعة ذوقه ورقة إحساسه، انطلاقا مما نعلم عن تكوين الشخصية المتوازنة، هل ترانا عندئذ بصدد نفي خلق الله للإنسان وتمتيعه بالسمع والبصر والفؤاد وبالحياة ذاتها؟ ! واضح هنا أن مؤلف الحريات العامة منشغل ببناء نسق إيديولوجي لما يراه نظرية الإسلام في الحكم وليس بالمساهمة في بناء إنسانيات استخلافية. نعم لقد تكلّم الغنوشي عن استخلاف الإنسان في الأرض، ولكن أليس الإنسان ووعيه والأرض التي نشأ منها وعليها معطيات أولية طبيعية. أن نعتقد أن الله هو خالق الطبيعة ككل والطبيعة الإنسانية المتضمنة لصفات العقل الحرية والإرادة، فهذا أمر يخصنا بصفتنا مؤمنين. ولكن كيف نبني نظرية في الحكم تجمعنا مع كل مواطنينا باختلاف عقائدهم وقناعاتهم ومللهم ونحلهم؟ نظرية مدنية؟ أليس على قاعدة المشترك الذي يجمعنا، بما أننا نبتغي بناء مشتركٍ (الدولة) يجمعنا على أساسه أيضا؟ فما هو هذا المشترك الذي يجمع المسلم والمسيحي واليهودي والليبيرالي والماركسي وغيرهم؟ أليست هي المواطنة؟ وأليس المواطن هو إنسان له حقوق طبيعية نعتقد نحن المؤمنون أنها هبة الله له، ويعتقد غيرنا عن حق أنها من صميم تكوينه وشوقه الطبيعي، الذي نسميه نحن بلغة القرآن فطرة؟.
فعندما يقول الأصولي الشيخ الطاهر ابن عاشور “إن الشارع متشوف للحرية”، أليس ذلك في تطابق تام مع فطرة الإنسان، أي تكوينه الطبيعي المتشوف والمتشوق للحرية؟ ! الحرية التي نلمسها بكل يسر في التكوين الطبيعي حتى لكائنات أقل تعقيدا حيويا من تركيبة الإنسان العاقل ذي التكوين العصبي الذي يفتح على إمكانيات لا حصر لها من حرية الاختيار، أعني بها العصافير التي تُفتح لها أبواب الأقفاص التي سُجنت فيها. فإنها وإن تردّدت في البداية في الانطلاق الحر إلى الجوّ، بحكم الإشراط الحصري، فإنها تنتهي أخيرا إلى تقرير مصيرها الجديد المطابق لفطرتها أي لتكوينها االطبيعي، الذي نسميه بلغة القانون في حق الإنسان، الحق الطبيعي. ثمّ من منا ينسى صرخة الحقّ الطبيعي التي أطلقها عمر بن الخطاب: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟!”. ألا يعلم عمر أن الناس هم من خلق االله؟ ولا ننس أن هذه الجملة الخالدة قد قالها عمر رضي الله عنه في حق غلامي قبطي، أي ليس مسلما، ولكنه مواطن بالدولة الإسلامية في ولاية مصر، لمّا تظلّم لديه مع أبيه من ظلم وضرب ابن عمرو بن العاص له. عمرو بن العاص الذي كان والي مصر في ذلك الحين. وذلك لما تسابقا على الخيل وسبقه الغلام االقبطي. هذه الجملة نفسها هي التي نطق بها تقريريا خطيب الثورة الفرنسية “لافاييه”، لدى قراءته البيان الأول للثورة، حيث قال: “يولد الرجل حرا ولا يجوز استعباده”. حينها رفع لافييه رأسه وقال: “أيها الملك العربى العظيم عمر بن الخطاب، أنت الذى حققت العدالة كما هي”.
الحلقة المفقودة هنا في الفكر الحركي السياسي الإسلامي هي حلقة فلسفية وهي حلقة التحييث l’immanence، أي مغادرة منطق علم الكلام القديم الذي لم يعد قادرا على حل مشكلات المواطنة والعيش المشترك (لا على قاعدة أهل الذمّة، بل على قاعدة المواطنة) وبناء فلسفة استخلافية محايثة. الاستخلاف لا يخصّ المسلمين فقط بل يخصّ النوع الإنساني كافة، والتحييث يعني تطبيق منهج أفقي، خلافا لمنهج علم الكلام العمودي، الذي يورث تصورا تراتبيا عسفيا لنظام العلاقات الاجتماعية والسياسية، وتنزيل المتعالي ضمن الشرط الإنساني والطبيعي. دائرة الأخوّة في الوطن، لن تلغي الدائرة الأوسع أو الأضيق، في الدين. ولكن لكل منهما قانونه الأخلاقي والروحي الخاص. الروح في الوطن هي الوطنية والمواطنية، وهي تجمعنا بكل شركائنا في الوطن مهما كانت دياناتهم وعقائدهم وأحزابهم واتجاهاتهم. أما الروح الدينية فهي روح إيمانية، وهي إضافة هامة للروح الوطنية والمواطنية، ولا تعارض ولا صراع بينهما.
أضيف إلى ما سبق نقطة منهجية ذات علاقة بمسألة الحرية كما طرحها الغنوشي في هذا الكتاب، وهي إحالته في هذا السياق إلى عدد من المفكرين الإسلاميين هم الشيخ الطاهر ابن عاشور، والشيخ علالة الفاسي، والمفكر السوداني حسن الترابي، والفيلسوف محمد إقبال والمفكر مالك بن نبي، والأستاذ محمد فتحي عثمان. بينما لا تنتمي الأطروحات الفكرية لكل هؤلاء إلى مدرسة فكرية واحدة ولا إلى براديغم فكري تجديدي واحد. فشتان مثلا بين فلسفة محمد إقبال التجديدية الأصيلة والعميقة واجتهادات الزعيم الإخواني حسن الترابي أو مفكر النهضة الإسلامية الجزائري مالك بن نبي أو مفكر اليسار الإسلامي فتحي عثمان. فإقبال مثلا قد نحت مفهوما يساعد على تدشين قطيعة ابستمولوجية مع منهج النقل والأثر ومع التبعية للنص، وهو مفهوم ختم النبوة. بما هو تمش معرفي يرفع الوصاية عن عقل الإنسان. لماذا ختمت النبوة؟ لأنه انفتحت أمام الإنسان إمكانية الاعتماد على نفسه: “إن النبوة لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها”. النبوة كالأبوة. المراحل الثلاث: الطفولة العقلية والمراهقة العقلية: (مرحلة النبوة) ثم أخيرا النضج العقلي (ختم النبوة)الذي بفضله يمكننا أن نبني ما نشاء من المفاهيم النظرية والعملية بما في ذلك السياسية منها بكل حرية ومسؤولية عقلية وأخلاقية، مثل مفهوم الديمقراطية.
وهذا الخلط بين عدّة مرجعيات لا تنتمي ضرورة إلى نفس المدرسة الفكرية هو نَفَسٌ اتّسم به هذا الكتاب بما جعله يتّصف بنوع من التجميعية التوفيقية التلفيقية. ولعلّ أحد أسبابه عائد، فضلا عن الروح الحركية السياسية الإيديولوجية والبراغماتية التي بقيت حاضرة في البحث على حساب اتساقه النظري ومتانته الابستمولوجية، إلى تعدّد المتدخلين في مراجعته تعددا كبيرا. فالباحثون الآخرون الذي شاركوا بطريقة أو بأخرى في صياغة عدد من أفكار هذا الكتاب ومضامينه، بمناسبة مراجعاتهم له، هم على الأقل سبعة أشخاص[5]:
د. البشير النافع – د. محمود أبو السعود- أحمد المناعي- محمد النوري- لطفي زيتون- سلوى المهيري- المختار البدري، فضلا عن تقويمات خبراء مركز الوحدة العربية ونصح وتوجيه د. محمد سليم العوّا. وهذا أمر مفهوم من جهة، وغير مفيد من جهة أخرى. فهو مفهوم بحكم الظروف الأمنية والحركية التي حفت بإنتاج هذا العمل وانشغال الشيخ راشد الغنوشي في مرحلة ما بعد السجن بإدارة شؤون الحركة الإسلامية. ولكنه غير مفيد من جهة الخلط وضعف التماسك المنهجي والغموض المفهومي والنظري الذي يتسبب فيه.
رابعا- قضية الشورى والديمقراطية
يفرّق الأستاذ راشد الغنوشي بين جانبين في التعامل مع المنجز الحضاري الغربي الحديث: جانب الوسائل والإجراءات والتقنيات وجانب المبادئ والقيم الأفكار. نأخذ الأولى أي التقنيات والإجراءات عن الغرب ولا نأخذ منه المبادئ والقيم والأفكار. وهو ما أقرّه عليه مقدّم الطبعة الأولى الدكتور محمد سليم العوا. وهو بهذا يستعيد نفس الموقف الذي اتّخذه روّاد النهضة العربية من الحضارة الأوروبية أمثال الطهطاوي في رحلته الباريسية التي دوّنها في كتابه “تخليص الإبريز في تلخيص باريز”. فهو يقول إنه علينا الأخذ بالعلوم الحِكمية من أوروبا أي التقنيات والإجراءات الإدارية، مثلما فعل ذلك لاحقا الجنرال حسين في المدرسة الحربية برقادة في الجانب التقني العسكري أو خير الدين التونسي في الجانب الإداري، أو مثلما فعل محمد علي باشا في مصر، ولكن لا يجوز أخذ القيم عن الغرب، فلنا قيمنا التي تغنينا عما سواها. وفي الحقيقة هذا المنهج كان قد كُرّس أيضا سابقا من المسلمين الذين أخذوا عن الرومان بعض تنظيماتهم الإدارية ومؤسساتهم وأخذوا من الصينيين والهنود والفرس بعض تقنياتهم، ولكنهم تمسّكوا في ما عدا ذلك بعلم الكلام بكل فرقه الداخلية. وفي الحقيقة ليس هذا بالضبط منهج التعارف القرآني: شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لننظر اليوم مثلا في البلدان الاسكندنافية حيث مستوى الفساد صفر.
يقول الغنوشي: “وسنرى كيف يمكن للإسلام أن يستوعب النظام الدّيمقراطي الغربي، فيحفظ للمسلمين والبشرية إيجابيته في ما قدّمه للفكر السياسي من إضافة حقيقية تتمثل في تحويل مبدأ الشورى الذي جاء به الإسلام، أي اشتراك الأمة في الحكم وانبثاقه عن إرادتها وقوامتها على حكامها وتحويله من مواعظ ومبادئ عامة إلى جهاز للحكم، مثلما فعل العقل الغربي مع تراثنا في الهندسة والجبر، إذ حولهما إلى تقنية منظورة، وذلك بعد من أبعاد الثورة العلمية والعبقرية الغربية: القدرة على تحويل الأفكار والقيم إلى آلات، فهل نرفض هذه التقنيات الصناعية والسياسية [لاحظ انزياح الغنوشي بالمعنى، وتسريبه لصفة “السياسية” وسحبها على التقنية] لمجرّد أنها صنعت في الغرب؟ أم نقول هذه بضاعتنا ردّت إلينا؟” (ص. 87-88)؟
ما غاب عن الأستاذ راشد الغنوشي والدكتور سليم العوا أن تلك التقنيات والإجراءات (حينما يعتبر أن الديمقراطية والعلمانية من قبيل التقنيات أو التكنولوجيا السياسية) لم تكن وليدة العقل التقني وحده، بل وليدة العقل الكوني والعقل العملي الأخلاقي المؤسس على مسلمة الحرية وأنها وليدة فلسفة في الإنسان وموقعه في الوجود وقدرته على الفعل في العالم والتاريخ. وليست تحويلا تقنيا لمبدإ الشورى الإسلامي في ورشات ومختبرات ومخابر الفكر الفلسفي السياسي الغربي حيث اشتغل فلاسفة الأنوار والعقد الاجتماعي: سبينوزا وهوبز وروسو ومونتسكيو وفولتير. وهذا في الحقيقة رأي غريب أي القول بأن الغرب قد انطلق من الإسلام ليبني الديمقراطية الحديثة. أي كالقول بأنها بضاعتنا ردت إلينا. ولكنها خرجت منا مادة خام ورجعت إلينا مصنعة، كالفسفاط أو غيرها من المواد الأولية التي نصدرها للغرب ثم نشتريها منه بأثمان مرتفعة بعد أن يعالجها في مختبراته ومصانعه. بل لعل العكس هو الصحيح، وهو أننا نستلم فكرا سياسيا وثمراتٍ لهذا الفكر فنُقحمه في منظومتنا الثقافية ونعيد إخراجه على أنه بضاعتنا ردت إلينا وعلى أنه موجود لدينا في نصوصنا وتراثنا. وهذا منهج غريب عن مبادئ حقوق التّأليف الحضاري وعن منهج التعارف القرآني. بقي أن نقد جانب من القيم الغربية الحديثة أمر مشروع تماما وهو لا يبرّر الزهد في ما هو كوني وعقلاني وسليم في تلك القيم.
المشكل ليس في الحداثة بل في استجلاب صيغة جاهزة للحداثة، والحداثة حداثات. علينا أن نبني حداثتنا بالاعتماد على ممكنا الفكري الحضاري الذاتي وعلى المشترك الكوني الإنساني. علينا أن نبني حداثتنا الأصيلة بتحييث المتعالي على مسطّح ختم النبوّة الذي يعني رفع الوصاية عن عقل الإنسان، هذا العقل الذي هبة الله وهديته للبشر، كما الوحي رسالته ورحمته النازلة عليهم. وعندها يمكن للإنسان المتحرر بختم النبوة والمكتسب لاستقلاليته بفضل وعيه بالآثار المعرفية المترتبة عليها، أن يبني الديمقراطية بأي طريقة شاء وحتى أن يتجاوزها بإبداع نظم سياسية أكثر تطورا (المرور مثلا من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية والمحلية، وعدم الاكتفاء بها شكلا سياسيا للتداول على السلطة أو المشاركة فيها، بل شحنها كذلك بمضامين اجتماعية…الخ.).
خاتمة
هذه قراءة غير مستوفاة بالضرورة لكتاب “الحريات العامة في الدولة الإسلامية”، وهو رغم هناته المنهجية والمعرفية التي لا تؤهله، في نظرنا، ليكون بحثا علميا بالمعنى الأكاديمي الدقيق للكلمة، إلا أنه يمكن اعتباره كتابا ثقافيا طريفا ومفيدا لا يخلو من اجتهادات محمودة مثل قوله بجواز تقليد الولايات العامة للمرأة كالإمارة والقضاء، ومثل رفضه لاستئثار رئيس الدولة الإسلامية بالحكم كله لنفسه في تماه كامل مع الدولة كما تقول بذلك بعض الأحزاب الإسلامية السلفية، ومثل تأكيده على الطابع المدني لولاية الحاكم أمر المسلمين وكافة المواطنين في الدولة، ومثل موقفه من الردّة وتمييزه بين المرتدّ المنقلب على الدولة والمرتدّ الذي اكتفى باختيار حر جديد لعقيدته، وعديد المسائل التفصيلية الأخرى المتوافقة مع روح النظام السياسي الديمقراطي الحديث.
يمكن القول إجمالا أن هذا الكتاب قد كتب في مواجهة ضاغطتين:
- ضاغطة الفكر الحركي السياسي الإخواني بكل شحنته التراثية السلفية، مع فتحات ونفحات تجديدية.
- ضاغطة الفكر السياسي الليبيرالي كما تقبل به الدول الغربية، وكما يتبناه في الظاهر النظام الحاكم السابق ذي التعددية الشكلية. أي هو عبارة عن مطلب تأشيرة للعبور إلى فضاء المشاركة السياسية العلنية والقانونية وإلى الحكم، ولكن هذا المطلب لم تستجب له إلا الثورة، ثم سُحبت التأشيرة جزئيا في اعتصام الرحيل، فأُخرج الإسلاميون من الحكومة، ثم جُدّد المطلب للشعب مع الانتخابات الموالية وقُبل..وما زال إلى الآن من يرفض مشاركة الإسلاميين في الحكم حتى وإن رضوا بكامل قواعد اللعبة الديمقرطية..وهذه قصة أخرى…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جريدة “المغرب” 14 نوفمبر 2011.
[2] سيد قطب، خصائص االتصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق، القاهرة، 1988.
[3] يتدارك هذا الامر في نهايات الكتاب في عنصر “المواطنة عامة وخاصة”. حيث يقول: “للإنسان في الدّولة الإسلامية أيا كان مذهبه وجنسيته، حقوق ثابتة في العيش الكريم[…] ولكنه يملك حق الاختيار في أن يؤمن بأهداف الدولة والأسس االتي قامت عليها ويمثل الإسلام عمودها الفقري، أو أن يرفض ذلك. فإن آمن بها وكان مسلما فليس له ما يميزه عن إخوانه المسلمين غير مؤهلاته، وإن اختار االرفض فهو مجبر من أجل اكتساب حقوق المواطنة أن يوالي الدولة وأن يعترف بشرعيتها فلا يتهدد نظامها العام..” (ص. 290).
[4] يذكرهم الغنوشي في معرض شكره لهم على الإسهام في إعداد هذا الكتاب، سواء “بالنصح أو التقويم” أو “إثراء بعض أجزائه” أو “مراجعته” أو”ببذل الجهد المعتبر” أو”إخراجه” (ص. 22).




