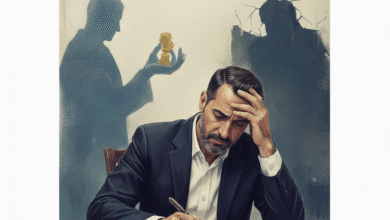تعديلات مدونة الأسرة وسؤال المآلات
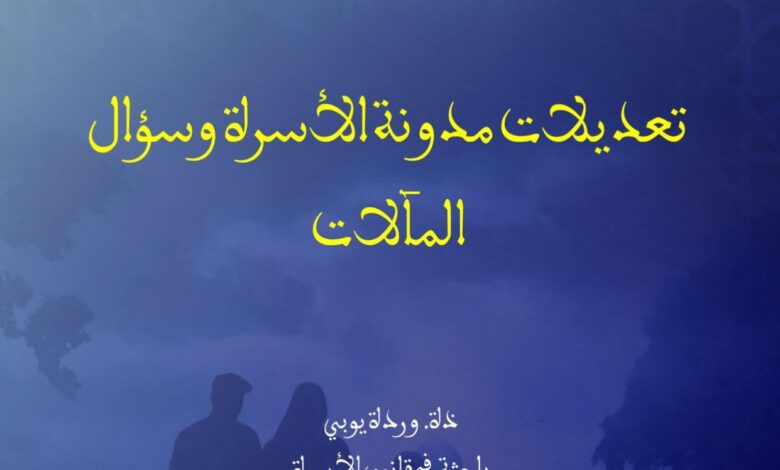
أثار الإعلان عن مقترح التعديلات المزمع تضمينها مدونة الأسرة ردود فعل متضاربة في المجتمع المغربي بين مؤيد ومعارض، بين من يراها إنصافا للمرأة وبين من يراها إنسافا للرجل، وبين من يراها تصب في مصلحة تيار حداثي على حساب آخر إسلامي، وبين من يراها رضوخا لإملاءات المواثيق الدولية وبين من يراها خضوعا للمتغيرات المجتمعية، فاستفزت بذلك إشكالات متعددة لدى المهتمين والباحثين وأثارت النقاش الكبير وأسالت وستسيل المداد الوفير.
لمقاربة موضوع مقترح التعديلات بناء على الإشكالات التي أثارتها أرى أن يقارب من زاويتين اثنتين، أولهما زاوية سؤال المستند الشرعي لمقترح التعديلات ذلك أن مدونة الأسرة تعتبر قانونا يتميز بخصوصية مصدريته المبنية أساسا على أحكام الشريعة الإسلامية، ثم من زاوية سؤال المآلات بالحديث عن آثار هذه المقترحات على مآل الأسرة المغربية.
- سؤال المستند الشرعي للتعديلات المقترحة:
كانت أولى ردود الفعل لدى مختلف الشرائح المجتمعية متصلة بسؤال شرعية المقترحات وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، الشيء الذي أصبح لزاما معه البحث في أصل المستند الشرعي للمقترحات المعلن عنها وتجليته. وبالرجوع لأحكام الفقه الإسلامي نجد أن موضوعات التعديلات المقترحة التي أثارت الجدل هي إما مسائل متوافقة أساسا مع أحكام الشريعة الإسلامية كإدراج الشرط في عقد الزواج ما لم يخالف مقاصد العقد والقواعد الآمرة، وإما مسائل خلافية لفقهاء الشريعة الإسلامية المتقدمين كما المتأخرين لهم فيها أقوال، فإن لم يكن القول المعتمد في المقترحات مستمدا من المذهب المالكي كان من غيره من المذاهب، وهذا هو الحال في مسألة عدم سقوط حضانة الأم المطلقة بالزواج، وكذا مسألة وجوب النفقة بمجرد العقد. وإما مسائل قياسية إن صح التعبير كمسألة إيقاف بيت الزوجية من التركة للزوج الباقي حيا قياسا على إيقاف الحجرات لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاتهن. أو خلافية إن كان القول المعتمد فيها ذاك الذي قيل به بناء على الحديث النبوي الذي أخرجه أبو داوود في صحيحه عن زينبَ أنَّها كانت تَفْلي رأسَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وعندَهُ امرأةُ عثمانَ بنِ عفَّانَ ونساءٌ منَ المُهاجراتِ وَهنَّ يشتَكينَ منازلَهنَّ أنَّها تضيقُ عليْهنَّ ويخرُجنَ منْها فأمرَ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وسلم أن تورَّثَ دورَ المُهاجرينَ النِّساءَ فماتَ عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ فوُرِّثتْهُ امرأتُهُ دارًا بالمدينةِ. وكذلك حال مسألة تثمين العمل المنزلي باعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام رابطة الزوجية قياسا على العرف السوسي “تمزالت” المعروف بالكد والسعاية والمعمول به فقها سواء كان هذا القياس صحيحا أو فاسدا أو شاذا فليس هذا مقام بيان القول فيه.
أما الجدل الذي أثير في عدم الالتزام بالمذهب المالكي في مضامين التعديلات المقترحة، فمردود عليه إذ أن عدم الالتزام بالمذهب المالكي قد اعتمد عليه سلفا في مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957، وكذلك كان الحال في مدونة الأسرة لسنة 2004 سواء بالنقل من المذهب الحنفي أو المذهب الظاهري. ثم إن التقيد بمذهب فقهي معين لم يوجبه الله ولا رسوله، إذ أن ولاء المسلم يكون للنصوص القرآنية والسنة النبوية، كما أن الحق غير محصور في مذهب واحد، وأن أئمة المذاهب لم يدعوا الناس إلى اتباعهم واعتبارهم أئمة، وإنما كانت مذاهبهم اجتهادات، والاختلاف بينها إنما هو اختلاف في الفروع التي أوسع الشارع للناس فيها الاختلاف ما كان اختلافا محكوما ومؤطرا بأصول الشريعة الإسلامية وقد اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والأئمة الكبار وما ضرهم ذلك شيئا، هذا ما دام الأمر متعلقا بخاصة الناس وهم أهل العلم المكلفين بالتشريع فلا يسري على عامتهم إذ يتعين عليهم الالتزام بمذهب معين، عزائم ورخصا إلا دفعا لمشقة وبشروط حددها العلماء.
وأما القول في عدم حاجة المجتمع للاجتهاد في الأحكام الفقهية، بحجة أن الفقهاء المتقدمين قد اجتهدوا وألفوا وأقروا الأحكام وأن لا حظ للمجتمع فيها سوى النقل فهو رد، إذ الحاجة للاجتهاد مستمرة ومتجددة بتجدد الوقائع والنوازل، فلا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان كما تنص القاعدة الفقهية، كما أجمع العلماء على أن أقوال الفقهاء هي للانتفاع لا التقديس وأن كلا يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام كما أخبر الإمام مالك. بل إن الفقهاء المتقدمين لطالما أكدوا أن الاجتهاد في كل عصر فرض وأن النوازل وإن كانت نفسها في وقائعها اختلف في قضائها باختلاف زمنها فتلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، ما اقترن الاجتهاد بضوابطه، وأركانه، ومقاصده، ورجاله.
أما النظر في التعديلات المقترحة باعتبارها خضوعا صارخا لإملاءات القانون الدولي من خلال السعي لملاءمة قانون الأسرة دونما اعتبار لما سبقت مناقشته أعلاه، فهو وإن كان فيه بعض الصحة من جانب مسايرة المنتظم الدولي والمتغيرات المجتمعية الأممية والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، إلا أنه يبقى مرتبطا بالمقتضى الدستوري الذي حرص المغرب على الالتزام به والذي ينص على جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية. وهنا والحال ما ذكر، ينبغي التنويه إلى أن مقتضيات الاتفاقيات الدولية ومن خلالها مطالبات التيار الحداثي للجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والتي بت فيها المجلس العلمي الأعلى تضمنت تعديلات تمس النصوص الدينية القطعية الدلالة والثبوت كالمساواة في نظام الإرث والتوارث بين المسلم وغير المسلم، والمساواة في الحقوق المتعلقة بالزواج، وزواج المسلمة بغير المسلم، بالإضافة لمسائل أخرى كإثبات النسب للأطفال الناتجين عن علاقات خارج إطار الزواج، وسقف المطالب يزداد علوا إذا تجاوزنا القانون الأسري وصولا للقانون الجنائي والمطالبات بعدم تجريم العلاقات خارج إطار الزواج واستحداث جريمة ما أطلق عليه الاغتصاب الزوجي. لذا فإن مخرجات المجلس العلمي الأعلى بالنظر لهذه المقتضيات الأخيرة تستحق التنويه مبدئيا.
من خلال ما سبق، يظهر أن مخرجات مقترح التعديلات ابتداء لا تشكل تناقضا مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تخالف نصوصها القطعية ولا أصولها، بل وقد تبدو ظاهريا مكتسبات للمرأة المغربية باعتبار فرضية أنها الطرف الضعيف في العلاقة الزوجية، وبالنظر للإشكالات التي تعاني منها والتي يجليها عدد المنازعات المتعلقة بالأسرة في ردهات المحاكم. غير أن مدونة الأسرة وكما هو معلوم ليست مدونة للمرأة وإنما مدونة للأسرة كلها زوجا وزوجة وأبناء، وإذا كانت التعديلات تبدو أنها تنصف المرأة في الحال فإنها تنسف الأسرة، التي هي عماد المجتمع في المآل، وهنا يتوجب النظر في مدى صوابية مقترح التعديلات ومدى توافقها حقا مع مقاصد الشريعة الإسلامية، إذ التوافق مع الشريعة الإسلامية يستلزم التوافق مع مقاصدها، ذلك أن الأمور بمقاصدها، وإذا كان يتوجب للضرر الواقع على المرأة أن يزال، فإنه يزال لا باعتبار الحال فقط وإنما باعتبار الحال والمآل.
- سؤال مآلات مقترح التعديلات على الأسرة المغربية:
إذا كان المجتمع يحتاج للاجتهاد في الأحكام الفقهية مسايرة للمتغيرات المجتمعية وللوقائع والنوازل المتجددة، فإن هذا الاجتهاد يجب أن يتم وفق ضوابط محددة، محققا شروطا معينة، بحيث يتغيى المقصد العام من التشريع الإسلامي والذي يدور حول جلب المصالح ودرء المفاسد للفرد والمجتمع على حد سواء، ومؤطرا بمجموعة من القواعد الفقهية التي تحفظ المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية في الحال والمآل، وكل اجتهاد لا يراعي هذه القواعد فلا يعد اجتهادا حقيقة وإنما تكريسا لواقع كائن ومسايرة له، وهو ما أطلق عليه الدكتور طه عبد الرحمن الإمعة القانونية ذلك أن المطلوب من القانون هو أن يسبق تشريعه الأحداث ويضع القواعد لما يستقبل منها وفق قيم أخلاقية محددة، مقوما للمسالك وموجها للمطالب، لا أن يكتفي بتكريس الوقائع ويقف عند حد الاستجابة للمطالب، وتقرير الواقع وليس تصحيحه. وبالنظر لمضامين مقترح التعديلات التي أعلن عنها وإن سلمنا ابتداء باستنادها لمستند شرعي وبأنها تحقق مصالح لأحد أفراد الأسرة في الحال، فإنها بالنظر للمآل الذي ستؤول إليه الأسرة المغربية نجد أنها ستجلب مفاسد جمة للمرأة والرجل والأسرة خاصة وللمجتمع المغربي عامة، وهذا ما لا يقبله كل من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد.
فبقليل من النظرالحصيف يمكن التنبؤ بالمآلات التي ستؤول إليها الأسرة والمجتمع، إذ التركيز على منظومة الحقوق المادية داخل الأسرة يحول العلاقات داخلها من التراحم إلى التعاقد، وتحويل الأسرة من مؤسسة اجتماعية تربوية قيمية إلى مؤسسة مقاولاتية تنبني على الربح بدل الفضل، وهو ما سينشئ جيلا متشبعا بنزعة المادية والفردانية وكل قيم التيار الرأسمالي ومفرغا من القيم التكافلية والتراحمية التي يتميز بها المجتمع المغربي. كما أن العمل على إكساب الزوجة مجموعة من الحقوق على حساب الزوج يشكل إضرارا بهذا الأخير في حقوقه المادية والمعنوية ويؤدي إلى العزوف عن الزواج في وقت يعاني فيه المجتمع سلفا من انخفاض نسبة الزواج وارتفاع مهول في نسب الطلاق، وانخفاض في نسبة الخصوبة حسب النتائج المعلن عنها للإحصاء الأخير، ما سيؤدي ليس فقط لشيخوخة المجتمع وإنما لانهياره. هذا فضلا عن تأجيج وتعزيز العلاقة الصراعية بين الرجل والمرأة وما لذلك من آثار وخيمة على المجتمع.
إن الإشكالات التي تعاني منها الأسرة المغربية في جميع أطرافها زوجا وزوجة وأبناء لا يمكن إنكارها وغض الطرف عنها، والقانون المؤطر للعلاقات داخلها والمتمثل في مدونة الأسرة يحتاج فعلا تعديلات تسد ثغراته وتتجاوز عثرات تنزيله وتساير تجدد الوقائع والنوازل التي تفرزها العلاقات المؤطرة به، فيحتاج بذلك اجتهادات فقهية تصحيحية مقاصدية يصلح بها حال الأسرة ومآلها، لا اجتهادات تكريسية للواقع معززة ومبررة له.
كما أن القاعدة القانونية وإن كانت وسيلة لتنظيم العلاقات بين الأفراد، فهي غير كافية لإصلاح حال الأسرة، ومبتغي الإصلاح لن يعدم الوسيلة لإدراك هذه الغاية التي تتطلب مقاربة شمولية متعددة الأبعاد فتشمل البعد الفقهي القانوني والاجتماعي والتربوي والاقتصادي، والاقتصار على بعد وحيد لن يفرز إلا منظومة حلول ناقصة لا تزيد الإشكالات إلا تعقيدا. لذا فإن تظافر جهود مجموعة من الفاعلين كالعلماء والفقهاء والأكاديميين والمتخصصين والباحثين ورجال القانون والقضاء يعد السبيل لدراسة الإشكالات الأسرية وسن القواعد القانونية المحكمة لحلها وتجاوزها.