علم كلام جديد أو علم كلام معاصر
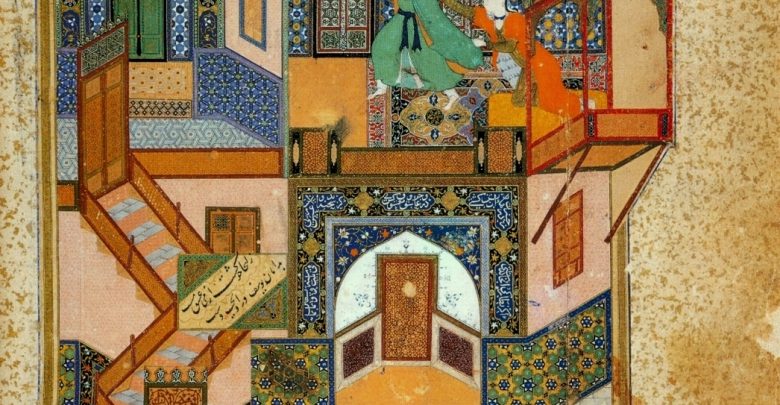
التسميات ليست محايدة
كلُّ تسميةٍ تفرضُ سلطتَها، التسمياتُ ليست محايدةً، تسميةُ “علم الكلام المعاصر” تحاول تحوير موضوع علم “علم الكلام الجديد”، وتشدّد على توجيه غاياته بعيدًا عن غاياته التي ينشدها، وتحاول سكبه في قوالب علم الكلام القديم، واستدعاء مناهجه وموضوعاته ومسائله وطرائق التفكير فيه ولغته ومصطلحاته القديمة ورؤيته الكلاسيكية للعالَم.
يحرص باحثون أشدّ التصاقًا بالتراث وتشبثًا بكلِّ ما فيه، وحرصًا على استئنافه كما هو، على استعمالِ مصطلح “علم الكلام المعاصر”، وغيرِ ذلك من تسمياتٍ تستبدل كلمةَ “الجديد” بما يوازيها في محاولةٍ منهم للخلاص من الحمولةِ الدلالية لمصطلح “علم الكلام الجديد”، وما تشي به من قطيعةٍ مع معظم كلاسيكيات علمِ الكلام القديم، ودعوةٍ لإعادةِ بناءٍ شاملة لعلم الكلام، تتخطى المنطقَ الأرسطي لتنتقل للمنطق والفلسفة الحديثَين، والتحرّرِ من سطوةِ الطبيعياتِ القديمة، والرؤيةِ القديمة للعالَم، بتوظيفِ مكاسب العلومِ والدراساتِ الإنسانية والرؤيةِ الجديدة للعالم، وتبعًا لذلك يتحوّل منهجُ علمِ الكلام وبنيتُه، وتتبدّل كثيرٌ من مسائله، بل يحدث تحوّلٌ في طبيعة وظيفته، فبدلًا من انشغالِه في الدفاع عن العقائد، تصبح وظيفتَه الجديدةُ شرحُ وبيانُ وتحليلُ المعتقدات، والكشفُ عن بواعث الحاجة للدين، ومختلف الآثار العملية لتمثلاته وتحولاته في حياة الفرد والجماعة، تبعًا لأنماطِ الثقافةِ وطبيعةِ العمران والاجتماعِ البشري.
وبتعبير آخر تنتقل مهمةُ علم الكلام من كونها أيديولوجية دفاعية، تنطلق من مسلّمات ثابتة، لا غرضَ لها سوى التدليلِ على المعتقدات، ونقضِ حجج الخصوم، إلى مهمةٍ معرفية لا تنشغل بنقض حجج الخصوم، بل يتمحور غرضُها حول تعريفِ المعتقدات وتوصيفِها وتحليلِها، بالاعتماد على الفلسفة والعلوم والمعارف الجديدة، والتعرّف على منابعِ إلهامِ المعتقدات، ومجالاتِ اشتغالها، وأشكالِ فعلها في سلوك الفرد والجماعة.
في ضوءِ ذلك يتضح أننا أمامَ عِلمين: “علم الكلام القديم”، و”علم الكلام الجديد”، وليس عِلمًا واحدًا، فعلى الرغم من اشتراكهما بالاسم، لكن توصيفَ “الجديد” يجعله مفارقًا للقديم بشكلٍ كبير، فهو وإن كان يشترك معه في بحثِ جملةٍ من الموضوعات نفسِها، لكنه لا يضيف موضوعاتٍ جديدةً لم يعرفها علمُ الكلام القديم فحسب، بل إن طريقةَ بحثه ونتائجَه ومراميَه مختلفةٌ، ذلك أن كلًا منهما له مقدماتُه المعرفية، ومنهجُ بحثه، وأدواتُ تفسيره، ومفاهيمُه المفتاحية، وكيفيةُ رؤيته للعالم.
ربما يُقال إن الإصرار على تسميةٍ دون أخرى لا يغيّر من المحتوى شيئًا، لكن هذا الكلام غير دقيق، لأن كلَّ تسميةٍ تفرضُ سلطتَها المعرفية، التسميةُ تحدد وجهةَ السير وكيفيته، التسميةُ بوصلةٌ ترسمُ خارطةَ الطريق التي يسلكها الباحث وفي ضوئها يهتدي في خطواته وغاياته.
“علم الكلام الجديد” هو التسميةُ التي أتبنّاها، ويتبنّاها كلُّ من يعتقد بعجزِ علم الكلام القديم، ويعرفُ قصورَه عن الوفاء بالمتطلبات الاعتقادية للمسلم اليوم، ومن يدعو لمفارقةِ ذلك العلم، وبناءِ علم كلامٍ بديل يكون جديدًا في مقدماتِه المعرفية ومعناه ومبناه ونتائجه.
لا أستعمل تعبير “علم الكلام المعاصر”، لأن “علم الكلام الجديد”، الذي مضى على استعماله أكثرُ من قرن في كتابات الباحثين المسلمين في الهند وإيران والبلاد العربية، صار مصطلحًا مستقرًا في اللغات الأردية والفارسية والعربية وحتى الانجليزية ولغات اخرى يتداولها المسلمون بشكل واسع، ينطبق على هذا عنوان علم الكلام الجديد خاصة، لا على غيره، مضمونه لا يتطابق مع مضمون “علم الكلام المعاصر”، وإن كان يشتركُ معه في بعض دلالاته.
إن تعبيرَ “علم الكلام المعاصر” يلجأ إليه من يذهب إلى أن تجديدَ علم الكلام يتحقّق برفده بمسائل وحجج جديدة، مع الاحتفاظ ببنيتِه التراثية، وطرائقِ تفكيره، ولغتِه الخاصة، ورؤيته للعالم. لذلك لجأ هؤلاء إلى استعمال كلمة “المعاصر” حذرًا من الدعوةِ للخروج على علم الكلام القديم، واستبدالِه بعلم يستجيب لإشباع حاجة المسلم إلى رؤية توحيديةٍ لا تكرّر أكثرَ المقولات والجدالات المعروفة عند المتكلمين قديمًا.
يشعر البعضُ بالقلق من تسمية “علم كلام جديد”، ولا أريد أن أتحدثَ كثيرًا عن ضرورة هذه التسمية، لأنها صارت بحكم الأمر الواقع، بعد أن كُتِب فيها عددٌ كبير من البحوث والمؤلفات، واستقرت كمقرر دراسي في عدة معاهد وجامعات لعلوم الدين، وصارت تخصصًا معروفًا كتب فيه التلامذة في الجامعات الإسلامية وغيرها رسائل متنوعة في الدراسات العليا.
ولولا شيوع مصطلح “علم الكلام الجديد” في الاستعمال، لكان الأجدر استعمال مصطلح “اللاهوت الجديد”، علمًا أنّ مصطلح “الإلهيات” متداول في الفلسفة الإسلامية منذ فلاسفة الإسلام المتقدمين، ومازالت كليات علوم الدين في إيران وتركيا وغيرهما تسمى بـ “كلية الإلهيات”. وملخص الكلام في هذا الموضوع أنّ “علم كلام جديد” هو محاولة للاجتهاد في علم الكلام اليوم، كما اجتهد مؤسسو الفرق الكلامية في الماضي، فدونوا تصوراتِهم ومفاهيمَهم لأصول الدين المشتقة من عقلانية وعلوم ومعارف عصرهم، فلماذا لا يجوز أن يجتهد علماء الدين في عصرنا لإنتاج تصوراتهم في التوحيد والمعتقدات.
لا أستغرب ذلك ممن يصر على غلق باب الاجتهاد في الفقه، ومازال لا يجرؤ على الخروج على فتاوى أئمة المذاهب وفقهاء الأمس المعروفين، إذ أن من ينكر الاجتهاد في فروع الدين كيف يقبل الاجتهاد في الأصول، الذي هو أبعد مدى وأعمق من ذلك بكثير.
علم كلام أو عقيدة
عمل الحضورُ الواسع لأهل الحديث وتفشي التيار السلفي في عالم الإسلام إلى ترك استعمال “علم الكلام” واستبداله بـ “أصول الدين”، أو “العقيدة” أو “العقائد”، لأن أهل الحديث كانوا ومازالوا مناهضين لعلم الكلام، على الرغم من أن استعمال “علم الكلام” أدق، بوصف “العلم” و”الكلام” كلمتين محايدتين، مضافًا إلى الحضور التاريخي لهذا المصطلح منذ نشأته، واستقلاله كعلم من علوم الدين في وقت مبكر. أما ترك تسمية علم الكلام واستبداله بمصطلحات: “أصول الدين”، أو “العقيدة” أو “العقائد”، ففرضته عوامل بعيدة عن الروح العلمية، لأن كلَّ هذه التسميات تحيل إلى مفاهيم تشي بمعنى ديني، والديني هنا يحيل إلى المقدس المتعالي على التاريخ. لذلك لا يكون موقف الباحث عند استبعاد تسمية علم الكلام 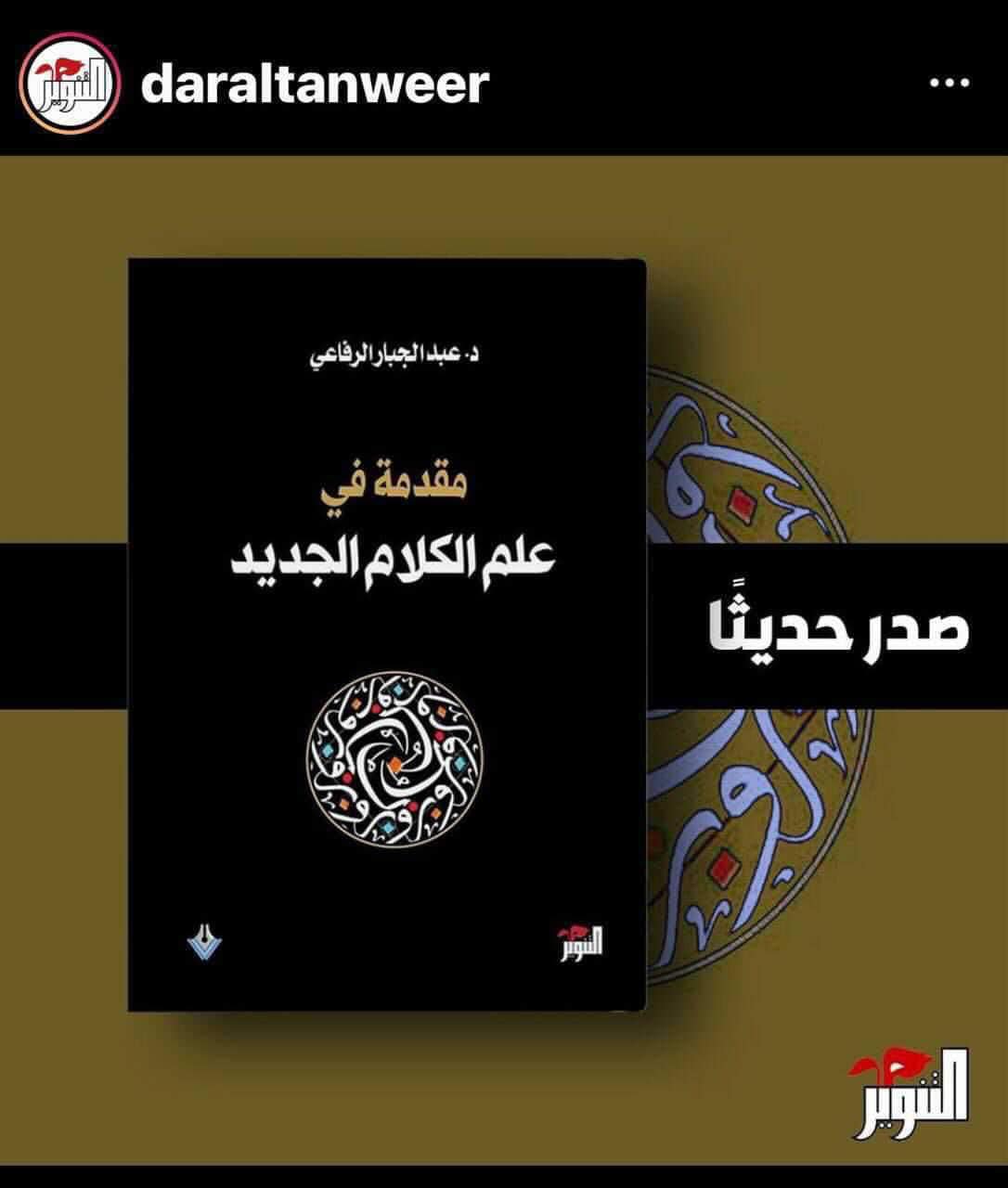 واعتماد تسمية تشي بمعنى ديني محايدًا، كما ينبغي أن يكون عليه موقف كل باحث علمي بالنسبة إلى موضوع بحثه، بل يتحدد موقفه في إطار معتقدات مقررة سلفًا، وليس له من موقف إلا الدفاع عنها والتشبث بها بمختلف الحجج والمجادلات. وذلك يعني وضع “أصول الدين”، أو “العقيدة” أو “العقائد”، خارج الأسئلة والنقاشات العلمية، وتلقينه وكأن مفاهيمه حقائق نهائية. لذلك أمسى تلميذ “أصول الدين”، أو “العقيدة” أو “العقائد” في معاهد التعليم الديني والجامعات الإسلامية يتلقى اليوم اجتهادات مؤسسي الفرق بوصفها القول الفصل في “معرفة الله وصفاته وأسمائه والوحي والنبوة” وما يتصل بذلك من مباحث.
واعتماد تسمية تشي بمعنى ديني محايدًا، كما ينبغي أن يكون عليه موقف كل باحث علمي بالنسبة إلى موضوع بحثه، بل يتحدد موقفه في إطار معتقدات مقررة سلفًا، وليس له من موقف إلا الدفاع عنها والتشبث بها بمختلف الحجج والمجادلات. وذلك يعني وضع “أصول الدين”، أو “العقيدة” أو “العقائد”، خارج الأسئلة والنقاشات العلمية، وتلقينه وكأن مفاهيمه حقائق نهائية. لذلك أمسى تلميذ “أصول الدين”، أو “العقيدة” أو “العقائد” في معاهد التعليم الديني والجامعات الإسلامية يتلقى اليوم اجتهادات مؤسسي الفرق بوصفها القول الفصل في “معرفة الله وصفاته وأسمائه والوحي والنبوة” وما يتصل بذلك من مباحث.
ينطبق معنى “علم” على “علم الكلام الجديد”، كما ينطبق عليه معنى “كلام”، ومعنى “الجديد”. فهو “علم” لأنه يعتمد مناهج البحث العلمي الحديثة، ويوظّف كل ما يحتاجه الباحث من مكاسب المعرفة البشرية، بلا ارتياب أو حذر.
وهو بحث علمي في الـ “كلام” الإلهي لأن موضوعه “الوحي” كما قررنا ذلك في كتابنا الصادر هذا العام: “مقدمة في علم الكلام الجديد” والذي تبنته عدة جامعات في التعليم العالي. “الوحي” هو الموضوع المحوري في علم الكلام الجديد كما شرحنا ذلك في الكتاب المشار إليه، والـ “كلام” الإلهي مبحث أساسي في بيان حقيقة الوحي وإمكانية تواصل الله مع الإنسان بلغة بشرية.
وهو علم “جديد” بوصفه لا يستنسخ مناهج الكلام القديم، ويتحرر من رؤيته للعالم، وكثير من مسائله وجدالاته المكررة، ويتسع لمسائل جديدة تتصل بأسئلة ميتافيزيقية توالدت في ذهن إنسان اليوم ولم يعرفها إنسان الأمس، خاصة الأسئلة المتصلة بمعنى وجود الإنسان وحياته ومصيره.
فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد في المجال العربي
قبل أكثر من 30 عامًا بدأتُ الحديثَ لتلامذتي في دروسي ولزملائي في الحوزة عن فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد. كنت أشدد على أن الآراء والمقولات الاعتقادية لمؤسسي الفرق والمتكلمين الأوائل تفرض حضورها في تشكيل صورة الله وصياغة رؤية المسلمين للعالَم، لأنها مازالت متجذرة في أعماق لا شعورهم. وكل تجديد في علوم الدين لا يبدأ بفتح باب الاجتهاد في علم الكلام ينتهي إلى طريق مغلق.
ثم انتقلتُ لكتابة ونشر وترجمة بعض المقالات والكتب باللغة العربية في ذلك. كان قراء من تلامذة وأساتذة الحوزات ومعاهد التعليم الديني وأقسام الفلسفة في الجامعات يتساءلون عن معنى هذين المصطلحين. أسئلةُ أكثرهم لا تخلو من تشكيكٍ وارتياب، لأن هذه الدعوةَ أزعجت تلامذةً وأساتذةً من الأصدقاء وغيرِهم، بل استفزت الضميرَ الديني للمنغلق عقلُه منهم.
بمثابرةٍ صبورة واصلتُ كلَّ هذه السنوات جهودي بهدوء وإصرار، من دون أن ألتفت إلى كتابات وأحاديث وثرثرة يتداخل فيها الارتيابُ بالاستهجان والاتهامات المبتذلة. انتقلتُ من مرحلة الكلام إلى العمل، فأسّست مركزَ دراسات فلسفة الدين، وأصدرتُ مجلةَ قضايا إسلامية معاصرة قبل 24 عاما، صدر من المجلة 74 عددًا. تناولت محاورُ أعداد هذه المجلة منذ صدورها بحثَ وتحليلَ ونقدَ وتقويمَ موضوعات فلسفة الدين والكلام الجديد ومناهجهما ومسائلهما. كما نشر مركزُ دراسات فلسفة الدين عدةَ سلاسل كتب، تتناول هذه الموضوعات بمداخل متنوعة ومعالجات مختلفة، صدر منها حتى اليوم نحو 300 كتابًا. أحد هذه السلاسل المرجعية التي بدأت بالصدور منذ نهاية القرن الماضي بالعربية، كانت تحت عنوان: “فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد”، وتواصلت سنوات عديدة.
انتقلنا منذ سنوات إلى محطة جديدة، توطنت فيها فلسفةُ الدين وعلمُ الكلام الجديد الدراسات الدينية والفلسفية العربية، فصدرت عدةُ دوريات متخصصة في ذلك، وانفتحت أقسامُ الفلسفة وعلوم الدين في الجامعات على هذه الموضوعات في الدرس الأولي والعالي، وتنامى إنتاجُ بحوث ورسائل الدراسات العليا. حتى بعضُ الحوزات ومعاهد التعليم الديني الحذرة من أية محاولةٍ للانفتاح على ما هو جديد، اهتمت بتعليمها ومناقشتها ونقدها. واتسع نطاقُ التعليم والبحث والكتابة في ذلك إلى الحدّ الذي تغافل فيه أشدُّ المناهضين للتجديد عن مواقفهم المتشدّدة، وفرض عليهم الواقعُ غضَّ النظر عنها، بعد أن تمدّد حضورُ فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد وتعزّز، فتنامى عموديًا وأفقيًا في الفضاء العربي.
إن انخراطَ التعليم الديني في هذا المسار الصعب هو ما يمنح الحياةَ معناها الروحي والأخلاقي والجمالي، الذي يتناغم لحنُه واحتياجاتِ روح وقلب وعقل المسلم اليوم، ويحميه من التشدّد والعنف اللذين أهدرا كلَّ طاقات الدين الخلّاقة، وبدّدا قيمَه الإنسانية الكونية.




