مفارقات وأضداد في توظيف الدين والتراث : من المركزيةِ الغربية إلى مركزيةٍ إنسانيَّة تصبُّ فيها الرَّوافدِ الثَّقَافيَّة الإنسانية
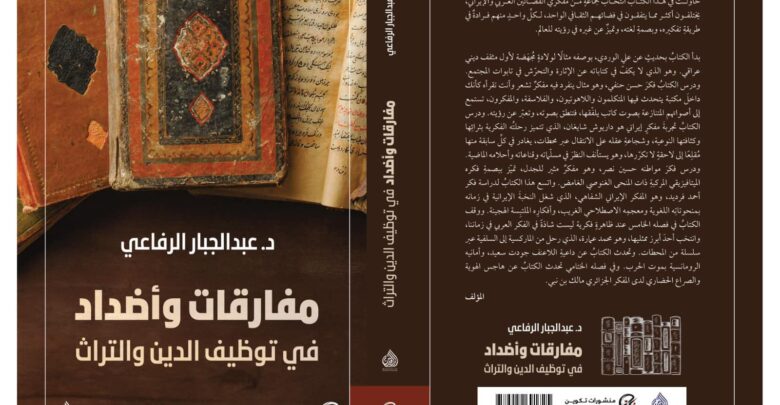
أعتقدُ أنَّ الدكتور عبد الجبار الرفاعي يريدُ من خلال مؤلَّفه هذا، أن تكون له مساهمةٌ في تطوير الثقافة العربية وفكرها، فكتابُه “مفارقات وأضداد في توظيف الدين والتُّراث” أراده جسراً موصولاً بين فكريْن شرقيين متجانسين تاريخيا وجغرافياً: الفكر العربي، والفكر الإيراني، ولعلَّه بذلك يكون قد ربط ماضي هاتيْن الثقافتيْن بحاضرهما، فقدْ تلاقحا ماضياً، بما حقَّق تألُّق الحضارة العربية الإسلامية. يقوم الكاتب بمدِّ حبل التَّواصل بينهما باعتبارهما ثقافتيْن عريقتيْن غنيتين بمحموليْهما، لاعتقاده أوانَ تلاقيهما، لتتشاركا معاً في مصاحبة المسيرة الإنسانية العالمية إلى مصيرها.
يريدُ كتابَه صرحاً جديداً في هذا البناء الفكري العربي المعاصر، وربَّما يكون هذا العملُ حافزاً، فتتفتَّحُ ثقافاتٌ شرقيةٌ أخرى على الفكر العربي من تركية وماليزية، وإندونيسية وباكستانية وغيرها، كما يتفتَّحُ هو عليهم، لِتتوسَّع بذلك الدَّائرةُ الفكرية الشَّرقِيَّةُ، ونخرُجَ من أسار الإبْهار المُزمن لِـ “المركزية الغربية”، ونعملُ على تأسيس “المركزية الإنسانيَّة “، تصبُّ فيها جميعُ الرَّوافدِ الثَّقَافيَّة الإنسانية.
استثمر الرفاعي في مصطلح “المثقف الديني النقدي”، بإثارته في مقال له في صحيفة “الصباح” العراقية، ثمَّ دفع به إلى السَّاحة الفكرية قصد إثرائه، وعمل على إبانته، وبيان الغرض منه، وتحديد إطاره (ص32)، وذكر دوره في ولوج المناطق المعتمة، والمسكوت عنها في التراث أو الفكر الديني، متَّخذاً العقل وسيلةً وآلةً، متسلِّحاً بثقافة الموروث وثقافة الحداثة (ص26)، واشترط أن يظهر المثقفُ الديني النقدي بصورة المتكلم الجديد، أو الفقيه المجدِّد، أو المفكِّر، لا متكلم قديم، ولا فقيه أحكام، ولا داعية (ص27)، كما أكد الكاتب على ضرورة توفر الضمير الأخلاقي اليقظ، والنزعة الإنسانية عنده (ص303)، ثم مضي بعد هذه الاستفاضة، إلى اختيار نماذج يعمل عليها، قد انتقاها من مجاليْ الفكر العربي والإيراني.
أمَّا الفكرُ العربي، فقد اختار منه نماذج مشرقيةٍ ومغربيَّةٍ، وتتمثَّلُ النَماذجُ المشرقيةُ، في شخصية ثقافية عراقية، ومن مصر اختار مفكِّريْن، وآخر سوري، ومثَّل النَّموذجَ المَغاربي مفكِّرٌ جزائري، بينما مثَّل الثقافةَ الإيرانيةَ ثلاثةُ فلاسفة. كل هذه النماذج يربطها إطار زماني واحد، فقد وُجِدُوا جميعا في النصف الأول من القرن العشرين.
اعتبر الكاتبُ الرفاعي “علي الوردي” أولَ مثقف ديني نقدي (ص21)، عرَّف به وبإنجازاته، وظروف عمله، وبأنَّه صَاحِبُ تكوينٍ أكاديمي ممتازٍ بمقاييس عصره (ص28). حرٌّ جريءٌ، له تأثيرٌ واسِعٌ على الأجيال التي نهلتْ منْ صافي معينه، جمع علي الوردي كنزاً هائلا من المعلومات التي تتعلق بالمظاهر الاجتماعية العراقية، والعادات والتقاليد، والسلوك والأخلاق، معتبراً نفسه ابن المجتمع الشعبي البسيط، يعيش وسطهم، يعرفهم عن قربٍ في معايشهم ومهنهم، وطرائق تفكيرهم وأساليب أحاديثهم.
نقل هذا الواقع نقلاً موضوعياً، ونثره تحت مشرحة طاولته دارساً محللاً، نقدَهُ نقد الحصيف، لم ينجرَّ وراء عاطفة، ولا استسلم لميلٍ ذاتي، مفضلا استخدام منهج ابن خلدون، كأفضل منهجِ تشخيصٍ لمجتمعه، وأوجد لذلك مصطلحات العمل، من مثل: صراع البداوة والحضارة، وازدواجية الشخص العراقي، والتناشز الاجتماعي (ص94).
خرج بنتائج محدَّدة دقيقة، تحفَّظَ الرفاعي على بعضها، بل كانَ له التَّحفظ من المنهج الخلدوني نفسِه معلِّلاً ومستشهداً (ص96)، ويقدِّم الكاتب نقد علي الوردي للمنطق الأرسطي الجامد، الذي يفضل عليه المقاربة السوفسطائيَّة (ص108)، القائمة على الشكِّ، وهو ما يريدُ علي الوردي تحقيقُه على السَّاحة الثقافية العراقية، كما أنَّ هذه المقاربة أيضاً تجعلُ من الإنسان معياراً، وهو مبتغى علي الوردي في الإنسان العراقي.
مع كلِّ هذه البضاعة المزجاة، يؤسفُ الكاتبَ أن يجده مفتقراً إلى ثقافة تراثية رصينة، وهذا الفقد هو إحدى هناته، لأنَّه من دونه يتكئ على عصا دون أخرى (ص28).
ثمَّ قارن الرفاعي بين المثقف الديني النقدي، والمثقف العضوي (ص44)، بين علي الوردي، وعلي شريعتي المثقف الآخر، وشرح أوجه المقارنة (ص47)، وامتاز علي الوردي بمراجعة أفكاره وقناعاته (ص52)، والإقرار بأخطائه، وله مواقف صادمة يخالفُ فيها العرفَ، وما جرى عليه الناسُ والمجتمع، من ذلك موقفه من مركزية الشعر، والفصاحة والنحو (ص68)، أقرَّ الكاتبُ الأسلوبَ المبدع الذي سَوَّقَ به علي الوردي كتاباته، وفي طريقة عرضه وتفسيره، وأسلوبه القصصي المشوِّق، وشجاعته النقدية التي مكنته بنشر ما لا يجرؤ على فعله مفكرو الزمن الحاضر.
أمَّا المثقف الديني النقدي الثاني، فهو حسن حنفي، يشيد الرفاعي بثقافته الموسوعية، وتكوينه الأكاديمي الصارم، الذي ناله من جامعة السوربون (ص121)، يشهد بأنَّه مفكر مدهش (ص139)، تجتمع فيه الموهبة الفذَّة، والذِّهنيَّة المراوغة، والإرادة العنيدة (ص186).
وقف حسن حنفي حياته كلَّها على مشروعه الفكري الذي أطلق عليه عنوان “التراث والتجديد” (ص125)، تضمَّن منهجه “اليسار الإسلامي”، استند فيه على التراث يتدارسه بأدوات عقلٍ معاصر تجديدي، عمل فيه على الجمع بين المتناقضات، يبحث عن طريقٍ ثالثٍ، يضع فيه وطنه على أرضية التقدم والازدهار.
صحيحٌ أنَّه خبير بالتُّراث، لكنَّ خبرته وضعها في خدمة منجزه الأيديولوجي، كان انتقائياً، والعمل الانتقائي يلوي عنق النص المستشهَد به، للواقعة المستشهَد لها (ص137). يصنف حسن حنفي نفسه فقيها، يجتهدُ خارج أصول الفقه، متكلماً يخرج عن مقولات الكلام، فيلسوفاً خارج العقل الفلسفي (ص129ـ130).
أمَّا منجزه الثاني، فيتمثل في تأسيس علمٍ جديدٍ أطلق عليه “علم الاستغراب”، يقومُ فيه بدراسة الغربِ بعين الشرق، كما درس الغربُ في “علم الاستشراق” الشرق بعين الغرب، لكن لم يُكتبْ لهذين المشروعيْن النجاح، فقد سقطا، ولم يجدا انتشاراً ولا صدىً إلاَّ قليلاَ.
خلع الرفاعي على حسن حنفي صفة رجل الأضداد، حتى أنَّه جعل العنوان المتصدر لاسمه هو: “الأضداد في كأس واحد” (ص119)، كان حسن حنفي مفكراً إسلامياً منغلقاً رغم أن مادته العلميَّة التي توفَّرتْ له، كانت باستطاعتها أن تجعل منه أحد أقطاب الفكر العربي البارزين، لكنَّه أغلق نفسه في حصن التراث، فبدأ منه، منتهياً إليه، من هنا كان مشروعه إحيائياً لا تجديدياً (ص177).
المثقف الديني النقدي الثالث هو محمد عمارة، تميز بارتداد مراحله الفكرية، فهي دوماً إلى حركة عكسية، ابتدأ نشاطه الفكري ماركسياً، أي بقناعة أيدولوجية، كانت صرخة العصر زمن شبابه، ذات آلياتِ مبنية على قاعدة فكرية فلسفيةٍ، تتجلَّى في مستوياتٍ سياسيةٍ، واجتماعية اقتصادية، ساحتُها تعجُّ بمختلف المناقشات مع المعادل المقابل، وهو الفكر الرأسمالي، أو في تلك الانشقاقات الإيديولوجية والاجتهادات الداخلية، فهي حركة وعيٍ لا تفترُّ.
انتقل من الماركسية إلى العقلانية الاعتزالية، وهي درجة أقلُّ، لأنَّ مساحة فاعليتها محدودة، تتعلَّقُ أكثرُ مقولاتها بالجانب التاريخي، إذْ نشأتْ منْ واقع الدفاعِ عن العقائد الإسلامية، نتيجة تناحرٍ مذهبي، ثمَّ امتدَّت في جدالات المِلل والنِّحل لأديانٍ أخرى مقابل الدين الإسلامي، ثمَّ انتقل إلى الوسطية الإسلامية، وهي درجةٌ أخرى أقلُّ، باعتبار التَّعامل يكون مع فكر إسلامي محافظ، يعتمد على الموروث النقلي.
ثم انتقل إلى مذهبية سلفية وهي درجة أخرى أقلُّ باعتبار التعامل الانتقائي مع مذهبٍ ديني دون سائر المذاهب الأخرى من نفس الدين، ورفض فتح الأبواب على ما عداها من مدارس ومناهج وأعلام آخرين، (ص318ـ319)، فتفكيرُه بحكم الطبيعة المعرفية السَّلفية يتوقف عند السطح من خلال أحكامٍ عامَّةٍ، أشبه بأحكام القضاء، فقد اتَّهم طه حسين بوقوعه تحت تأثير القسِّيس، عمِّ زوجته الفرنسية (ص321)، وكان المفكر الإسلامي الإشكالي نصر حامد أبو زيد من ضحايا تشدُّده (ص320).
ولا يخفى أنَّ لمحمَّد عمارة تأثيراً كبيراً على شريحةٍ واسعةٍ من الشَّباب، نتيجة الصَّحوة الإسلامية العامَّة، وهو صاحبُ تآليف بلغتْ 250 كتاباً، له وزنٌ معتبرٌ في الفضاء العامِّ للفكر الإسلامي، إذْ كان مستشاراً في “المعهد العالمي للفكر الإسلامي” القائم على أسلمة المعرفة، تقدَّم إليه المفكِّر محمد أبو القاسم حاج حمد سنة 1991، بكتابه “المنهجية المعرفية القرآنية”، ولكنَّ محمد عمارة عارض طبعه، وبقي إلى غاية 2013، حيث نشره “مركز دراسات فلسفة الدين” ببغداد في العراق (322).
المثقف الديني النقدي الرابع، هو جودت السعيد، داعية اللاعنف، يرى أنَّ الحربَ مكتوبة على جبين الإنسانية، والعنف طبيعة إنسانية، قامتْ عليها، وانتهتْ بها حضاراتٌ، وأخطر العنفِ العنفُ الديني (ص341)، لأنَّه في اعتقاد جماعات العنف مُسَوَّغٌ بنص قدسي، وأدرك مبكراً خطره على المجتمعات، خاصّةً الإسلامية، فنشر كتابه “مذهب ابن آدم الأول: مشكل العنف في العمل الإسلامي” عام 1966، دعا فيه إلى نبذ أشكاله (ص333)، ودعا إلى التَّعامل مع الذي يخالفُنا في الفكر، أو المعتقد بوصفِهِ إنساناً، لا بصفته العرقية، أو الهوياتية، أو الدينية، لكنَّ الرفاعي يذهب إلى أنَّ العنف الديني له جذور تكلَّستْ، أسَّس لها الكلام القديم، وما انبثق منه من مدونات فقهية وفتاوى (ص335)،
ويحبِّبُ جودت السعيد إلى المسلمين قراءة القرآن الكريم، لكن بآليات القراءة التي تفتح النص على الإنسان وعلى المطلق، فيقترح أن يُقْرَأ القرآن من حيث هو عملُ الإنسان، ويُقْرَأ مَرَّةً أخرى من حيثُ هو عملُ الله، ليجد القارئ فعلاً بشرياً يتحدَّث عنه القرآنُ، كما يجده فِعلاً إلهياً يتحدَّثُ عنه (ص333).
جميلٌ ما دعا إليه جودت السعيد، لكن الأمر لا يتعلق بأمنياتٍ ورغباتٍ كما أكد الرفاعي، فموضوعا اللاعنف، وموت الحرب حين يتحَّولان إلى عملٍ فكري، يتطلبان تأسيساً نظريا، وهو ما لم يتوفّق فيه صاحبُ الفكرة، فانزوتْ إلى دعوة أخلاقيةٍ إنسانيةٍ نبيلة.
المثقف الديني النقدي الخامس، هو مالك بن نبي، يعترفُ الرفاعي بقدرته في صياغة أفكاره ضمن نسقِ نظريةٍ علمية دقيقة، وأنَّ له موهبةً في صناعة المفاهيم، وفي تركيبها، بما يشبه المعادلات الرياضية (ص347)، ثم يرى أنَّ كتاباته غذَّتها عواطفُه وغيرتُه المشتعلة على وطنه وأوطان المسلمين، يخلص من ذلك الكاتبُ إلى أنَّ الحماسَة إذا اتَّقدت أخمدت العقلَ، وتراجع التفكير النقدي، فالعواطف المتَّقدة في نظره لا تفكِّرُ، ثمَّ يعودُ، فيراه مرَّةً أخرى متميِّزاً ببنية ذهنية تتجلى في معادلاته (ص353)، واستشهد بما قدَّمه من تحليل ظاهرة “التخلُّف” في سلسلته “مشكلات الحضارة، بصياغته تعريفاً للحضارة، ومنْ أنَّها حصيلةُ اجتماع ثلاثة عناصر هي: الإنسان، والتراب، والزمن، كما رسم مراحل دورتها التي تمرُّ بها كلُّ حضارة إنسانيةٍ، وهي: مرحلة الروح، ومرحلة العقل، ومرحلة الغريزة (354)،
ويرى الكاتبُ أنَّ مصطلح “القابلية للاستعمار” ربما يكون صدى لفكر وطرح ابن خلدون، في ولع المغلوب بالغالب (355)، ويرى أنَّ أكثر معادلاته لا تخلو من مثالية لا يمكنُها أن تتحقَّقَ في واقع المسلمين، كحلمه في محورٍ يجمع الأمة الإسلامية، سماه “محور طنجة – جاكارتا” (356)، كما تظهر في كتاباته بصمة لاهوت التحرير، إذْ يرى العنف مكّوَناً أساسياً لماهية الدين، ولاهوت التحرير نسخة من الإسلام السياسي (359).
اختار الرفاعي لتمثيل الفكر الإيراني الحديث ثلاثة فلاسفة: داريوش شايغان، وسيد حسين نصر، وأحمد فرديد، عاشوا في فترة متقاربة. أولهم داريوش شايغان، الذي ابتدأ حياته المعرفية في سن مبكرة من خلال مجالس “حلقة أصحاب التأويل”، التي ضمَّتْ العلاَّمة محمد حسين الطباطبائي وهنري كوربان، وتدارسوا فيها الفلسفة الإشراقية، وفلسفة الحكمة المتعالية، والعرفان (ص199)، ثم حاز على تكوين أكاديمي رصينٍ في جامعة السوربون، توَّجَهُ بإجازة الدكتوراه، ليقوم بعد ذلك بتدريس الفلسفة المقارنة، واللغة والآداب السنسكريتية، والتيارات الفلسفية الغربية في جامعة طهران (ص204ـ205)،
ومرَّت حياته الفكرية بثلاثة محطَّات، تأثَّر في محطَّته الأولى بالفرنسي رينيه غينون، والسويسري كارل غوستاف يونغ، والألماني مارتن هايدغر (ص207)، كان نتيجتها إنكاره المعارف الغربية في عصر الأنوار، وأنَّ الأنوار الحقيقية منبعها الشرق، فدعا إلى الرجوع إلى الذاكرة الذاتية، والهوية الثقافية والقيم الموروثة (ص208)، وكتب في هذه الفترة “الأصنام الذهنية والذاكرة الأزلية”، عام 1976،
وأما محطته الثانية، فتأثَّر فيها بميشال فوكو، وغاستون باشلار، ولويس ألتوسير، وهابرماس… وفيها تمكَّن من تصحيح رؤيته، فلم يعد يرى قدسيةً للذاكرة والهوية، ونادى في هذه المرحلة بتعميم “الرؤية النقدية”، التي هي إعادة تفكيك الموروث، واكتشاف خلله، ومواطن قصوره، ونشر كتابه “ما الثورة الدينية” عام 1982 (ص220)، رأى أنّ قوة الحضارة الغربية آتيةٌ من التشغيل النقدي الدائم، ثم ارتقى إلى محطته الثالثة، حيث نضجت شخصيتُه المعرفية، مضيفاً إليها مقولات جيل دولوز، وفيليكس غاتاري، تبيَّنت له حقيقةُ المجتمعَيْن الإنسانيين الغربي والشَّرقي، وأنَّهما أصلاً قائمين على أساس تناقضاتهما الداخلية، إذ أصل تكوينهما تعدُّدي، ولا يمكنُ أن يكون إلاَّ كذلك، فمن هذ التعدد يأتي التناقض،
وصاغ للتعبير عن رؤيته الجديدة مصطلحاته، من مثل:” أنطولوجيا مهشمة. تزامن الثقافات المتنوعة. العالم في هذا العصر شبحٌ. الهوية أربعين قطعة، هوية مركبة من شبكة ترابطات دقيقة، تعددية ثقافية. اختلاط قوميات. تمازج أفكار. تهجن مضطرد. تمازج لغوي وعرقي تعمل كالريزوم، تكتسبُ شكلا جذموريا ريزومياً، فينبثقُ نموذجٌ مرقع…” (ص231).
توصَّل إلى أنَّ عالمنا المعاصر ذو “هويَّة ريزوميَّة”، وهي هوياتٌ متداخلةٌ، وثقافاتٌ متمازجةٌ، وتلاقحٌ واختلاطٌ دائمان مستمران في الزمان والمكان، فلا وجود لهوية نقيَّة صافية، العالمُ ذاته سائرٌ إلى التمازج، الهويَّة الواحدة قماشٌ من أربعين قطعةً تخاطُ باستمرارٍ (ص233)، فمن هنا، فجميعُ الثقافات من الإنسان وللإنسان أُبْدِعَتْ، بل الإنسان نفسه هو للإنسان، وفي هذه المحطة اعتبر داريوش شايغان منجزات الأنوار إضافةً مهمَّةً للإنسان.
أمَّا سيد حسين نصر، فقد درس مرحلته الثانوية والجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل منها على إجازاته العلمية، وحضر دروس براتراند رسل، وتأثر برينيه غينو، وشوان، وبوكهاردت، وكان هؤلاء ضمن تيار فكري أطلق عليه الكاتب عبد الجبار الرفاعي “الحكمة الخالدة” (ص255)، وهي في بحث نصر حكمةٌ جوانيةٌ ساريةٌ من الأنبياء إلى الحكماء والفلاسفة (ص257). ولا يولي الغرب هذا العلم أيَّ اهتمام، لذا يرى سيد حسين نصر الشرقَ رمزَ النور والعقل والروحانية، والغربَ رمزَ المادية والانحطاط (273)، إلاَّ أنَّ الرفاعي يرى هذا الطرح دعوةً مبهمةً غامضةً، تقومُ أساساً على رفض المنجز الغربي (ص263)، كما لم تخرج هذه الدعوة من برجها النظري أبداً، وبقي حسين نصر متمسكاً بها حياتَه كلَّها دون مراجعة (ص275)،
وأمَّا أحمد فرديد، فهو صاحب التَّأثير الواسع في الفضاء الفكري الإيراني عبر حلقته الأسبوعية المسمَّاة “الحلقة الفرديدية”، تُناقش فيها تاريخ الفلسفة الإنسانية، والفلسفة الغربية والشرقية، ولمْ يتركْ أحمد فرديد أيَّ أثرٍ مكتوبٍ، بل اكتفى بتعليمه الشفهي، لذا أُطلِقَ عليه “الفيلسوف الشفهي” (ص287). صاغ للتعبير عن رؤاه مصطلحاتٍ غامضةٍ مركَّبة مثل: “الحكمة الإنسية، علم الأسماء التاريخي، وباء الغرب، تجلي أسماء الله في التاريخ… (ص286)، وقد صاغ رؤيته لعلم الأسماء الإلهية من فلسفة هايدغر، وعرفان ابن عربي، وعلم اللغة المقارن، والفيلولوجيا واللسانيات، لكنَّ هذه الرؤية كما يحللها الرفاعي مزيجٌ غيرُ متجانسٍ (ص290)، رآهُ مجرَّدَ نَقْعٍ لغوي لا ينجلي على أيَّة نتيجةٍ ذاتِ قيمةٍ.
يخلُصُ الرفاعي إلى أنَّ أحمد فرديد شخصية إشكالية مؤثِّرةٌ، فقد وقع في شراك غوايته مثقفون كثيرون، وإنْ كانوا قد انفضُّوا من حوله.
يتكوَّن الكتابُ من 367 صفحة، خصَّصها لعرض ثمان شخصيات. اختار لتمثيل الفكر العربي خمس شخصياتٍ، مثَّل الأولى “علي الوردي” بِـ 67 صفحةً في 13 مقالاً، والثانية “حسن حنفي” بِـ 58 صفحةً في 9 مقالاتٍ، والثالثة “محمد عمارة” بِـ 18 صفحةً في 3 مقالاتٍ، والرابعة “جودت السعيد” بِـ 17 صفحةً في 3 مقالاتٍ، والخامسة “مالك بن نبي” بِمقال واحدٍ من 11 صفحةً، الملاحظُ هو العدُّ التنازلي للمقالات وعدد الصفحات، فبين الشخصية الأولى والأخيرة فجوةٌ واسعة.
وتجلى عمل الفكر العربي في هذه الفترة من خلال هذا الكتاب على معالجة أوضاع اجتماعية كالذي ورد عند علي الوردي، أو عرض لأيديولوجية كاليسار الإسلامي، أو طرح لعلمٍ مُجْهَضٍ كما عند حسن حنفي، أو نظرة دينية منغلقة كما عند محمد عمارة، أو رؤية طوباوية في موت الحرب كما عند جودت السعيد، أو عرضاً غير مكتملٍ لطرح نظري كما عند مالك بن نبي، فليس هناك أي مبحث فلسفي، أو تأسيسي، أو فكري، لذا رأى الكاتبُ أنَّ ظاهرة الفكر العربي، تدعو للرثاء، كما لفت انتباهه فيه أنَّ له بداية متفتحة، ونهاية منغلقة (316)، ولا يمكن للعقل العربي أن يقوم بدوره، إذا لم ينهل مرتوياً من عوالم الفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع (ص18).
أمَّا الفكر الإيراني، فقد مثَّله ثلاثُ شخصيات، الأولى داريوش شايغان بِست مقالات في 44 صفحةً، والثانية سيد حسين نصر بخمس مقالات في 34 صفحةً، والثالثة أحمد فرديد بسبع مقالاتٍ في 29 صفحةً، والملاحظ هو التوازن النسبي في عرض الشخصيات الثلاثة. عمل الفكر الإيراني في نفس الفترة على مبحثيْن: فكرُ الهويَّة، أو العودة إلى الذَّات، والاهتمام بالروحانيات الشَّرقيَّة، وطريقة إصلاح أو تجديد الفكر الديني على ضوء منجزات العلوم الحديثة (288).
في خلاصة القراءة، يبدو أن عنوان الكتاب له نصيبٌ من اسمه في موضوع الكتاب، فرجعُ اللفظتين “مفارقات”، و”أضداد” تتردَّد بين جنبات الموضوع، نجد الفكر العربي في توظيفه التراث والدين فكر مفارقات، ولفظة أضداد صفةٌ تصدق على الفكر الإيراني.




